سورة النبأ | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
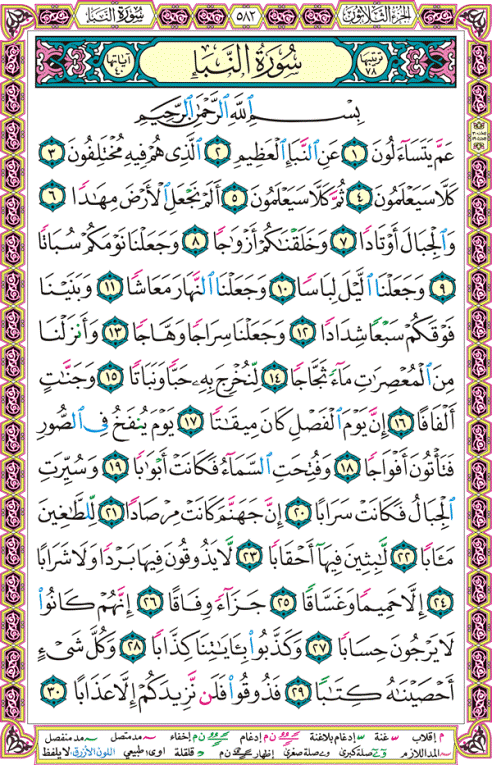
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 582 من المصحف
سورة عم
الآية: 1 - 5 {عم يتساءلون، عن النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون}
قوله تعالى: "عم" لفظ استفهام؛ ولذلك سقطت منها ألف "ما"، ليتميز الخبر عن الاستفهام. وكذلك (فيم، ومم) إذا استفهمت. والمعنى عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. وقال الزجاج: أصل "عم" عن ما فأدغمت النون في الميم، لأنها تشاركها في الغنة. والضمير في "يتساءلون" لقريش. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب به فنزلت "عم يتساءلون"؟ وقيل: "عم" بمعنى: فيم يتشدد المشركون ويختصمون.
قوله تعالى: "عن النبأ العظيم" أي يتساءلون "عن النبأ العظيم" فعن ليس تتعلق بـ "يتساءلون" الذي في التلاوة؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون "عن النبأ العظيم" كقولك: كم مالك أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرناه من امتناع تعلقه "بيتساءلون" الذي في التلاوة، وإنما يتعلق بيتساءلون آخر مضمر. وحسن ذلك لتقدم يتساءلون؛ قال المهدوي. وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: "عن" مكرر إلا أنه مضمر، كأنه قال عم يتساءلون أعن النبأ العظيم؟ فعلى هذا يكون متصلا بالآية الأولى. و "النبأ العظيم" أي الخبر الكبير.
قوله تعالى: "الذي هم فيه مختلفون" أي يخالف فيه بعضهم بعضا، فيصدق واحد ويكذب آخر؛ فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو القرآن؛ دليله قوله: "قل هو نبأ عظيم. أنتم عنه معرضون" فالقرآن نبأ وخبر وقصص، وهو نبأ عظيم الشأن.
وروى سعيد عن قتادة قال: هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجلين: مصدق ومكذب. وقيل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وروي الضحاك عن ابن عباس قال: وذلك أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم، ثم هددهم فقال: "كلا سيعلمون" أي سيعلمون عاقبة القرآن، أو سيعلمون البعث: أحق هو أم باطل. و "كلا" رد عليهم في إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن، فيوقف عليها. ويجوز أن يكون بمعنى حقا أو "ألا" فيبدأ بها. والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا: والذي يدل عليه قوله عز وجل: "إن يوم الفصل كان ميقاتا" [النبأ: 17] يدل على أنهم كانوا يتساءلون عن البعث. "ثم كلا سيعلمون" أي حقا ليعلمن صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت. وقال الضحاك: "كلا سيعلمون" يعني الكافرين عاقبة تكذيبهم. "ثم كلا سيعلمون" يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم. وقيل: بالعكس أيضا. وقال الحسن: هو وعيد بعد وعيد. وقراءة العامة فيهما بالياء على الخبر؛ لقوله تعالى: "يتساءلون" وقوله: "هم فيه مختلفون". وقرأ الحسن وأبو العالية ومالك بن دينار بالتاء فيهما.
الآية: 6 - 16 {ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفاف}
قوله تعالى: "ألم نجعل الأرض مهادا" دلهم على قدرته على البعث؛ أي قدرتنا على إيجاد هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة. والمهاد: الوطاء والفراش. وقد قال تعالى: "الذي جعل لكم الأرض فراشا" [البقرة: 22] وقرئ "مهدا". ومعناه أنها لهم كالمهد للصبي وهو ما يمهد له فينوم عليه "والجبال أوتادا" أي لتسكن ولا تتكفأ ولا تميل بأهلها. "وخلقناكم أزواجا" أي أصنافا: ذكرا وأنثى. وقيل: ألوانا. وقيل: يدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن، وطويل وقصير؛ لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار، فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. "وجعلنا نومكم سباتا" "جعلنا" معناه صيرنا؛ ولذلك تعدت إلى مفعولين. "سباتا" المفعول الثاني، أي راحة لأبدانكم، ومنه يوم السبت أي يوم الراحة؛ أي قيل لبني إسرائيل: استريحوا في هذا اليوم، فلا تعملوا فيه شيئا. وأنكر ابن الأنباري هذا وقال: لا يقال للراحة سبات. وقيل: أصله التمدد؛ يقال: سبتت المرأة شعرها: إذا حلته وأرسلته، فالسبات كالمد، ورجل مسبوت الخلق: أي ممدود. وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدد، فسميت الراحة سبتا. وقيل: أصله القطع؛ يقال: سبت شعره سبتا: حلقه؛ وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغال، فالسبات يشبه الموت، إلا أنه لم تفارقه الروح. ويقال: سير سبت: أي سهل لين؛ قال الشاعر:
ومطوية الأقراب أما نهارها فسبت وأما ليلها فذميل
"وجعلنا الليل لباسا" أي تلبسكم ظلمته وتغشاكم؛ قال الطبري. وقال ابن جبير والسدي: أي سكنا لكم. "وجعلنا النهار معاشا" فيه إضمار، أي وقت معاش، أي متصرفا لطلب المعاش وهو كل ما معاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك فـ "معاشا" على هذا اسم زمان، ليكون الثاني هو الأول. ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى العيش على تقدير حذف المضاف. "وبنينا فوقكم سبعا شدادا" أي سبع سموات محكمات؛ أي محكمة الخلق وثيقة البنيان. "وجعلنا سراجا وهاجا" أي وقادا وهي الشمس. وجعل هنا بمعنى خلق؛ لأنها تعدت لمفعول واحد والوهاج الذي له وهج؛ يقال: وهج يهج وهجا ووهجا ووهجانا. ويقال للجوهر إذا تلألأ توهج. وقال ابن عباس: وهاجا منيرا متلألئا. "وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا" قال مجاهد وقتادة: والمعصرات الرياح. وقاله ابن عباس: كأنها تعصر السحاب. وعن ابن عباس أيضا: أنها السحاب. وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك: أي السحائب التي تنعصر بالماء ولما تمطر بعد، كالمرأة المعصر التي قددنا حيضها ولم تحض، قال أبو النجم:
تمشي الهوينى مائلا خمارها قد أعصرت أوقد دنا إعصارها
وقال آخر:
فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر
وقال آخر:
وذي أشر كالأقحوان يزينه ذهاب الصبا والمعصرات الروائح
فالرياح تسمى معصرات؛ يقال: أعصرت الريح تعصر إعصارا: إذا أثارت العجاج، وهي الإعصار، والسحب أيضا تسمى المعصرات لأنها تمطر. وقال قتادة أيضا: المعصرات السماء، النحاس: هذه الأقوال صحاح؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر معصرات، والرياح تلقح السحاب، فيكون المطر، والمطر ينزل من الريح على هذا. ويجوز أن تكون الأقوال واحدة، ويكون المعنى وأنزلنا من ذوات الرياح المعصرات "ماء ثجاجا" وأصح الأقوال أن المعصرات؛ السحاب. كذا المعروف أن الغيث منها، ولو كان (بالمعصرات) لكان الريح أولى. وفي الصحاح: والمعصرات السحائب تعتصر بالمطر. وأعصر القوم أي أمطروا؛ ومنه قرأ بعضهم "وفيه يعصرون" والمعصر: الجارية أول ما أدركت وحاضت؛ يقال: قد أعصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته؛ قال الراجز:
جارية بسفوان دارها تمشي الهوينى ساقطا خمارها
قد أعصرت أو قد دنا إعصارها
والجمع: معاصر، ويقال: هي التي قاربت الحيض؛ لأن الإعصار في الجارية كالمراهقة في الغلام. سمعته من أبي الغوث الأعرابي. قال غيره: والمعصر السحابة التي حان لها أن تمطر؛ يقال أجن الزرع فهو مجن: أي صار إلى أن يجن، وكذلك السحاب إذا صار إلى أن يمطر فقد أعصر. وقال المبرد: يقال سحاب معصر أي ممسك للماء، ويعتصر منه شيء بعد شيء، ومنه العصر بالتحريك للملجأ الذي يلجأ إليه، والعصرة بالضم أيضا الملجأ. وقد مضى هذا المعنى في سورة "يوسف" والحمد لله. وقال أبو زبيد:
صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود
ومنه المعصر للجارية التي قد قربت من البلوغ يقال لها معصر؛ لأنها تحبس في البيت، فيكون البيت لها عصرا. وفي قراءة ابن عباس وعكرمة "وأنزلنا بالمعصرات". والذي في المصاحف "من المعصرات" قال أبي بن كعب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان: "من المعصرات" أي من السموات. "ماء ثجاجا" صبابا متتابعا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال: ثججت دمه فأنا أثجه ثجا، وقد ثج الدم يثج ثجوجا، وكذلك الماء، فهو لازم ومتعد. والثجاج في الآية المنصب. وقال الزجاج: أي الضباب، وهو متعد كأنه يثج: نفسه أي يصب. وقال عبيد بن الأبرص:
فثج أعلاه ثم ارتج أسفله وضاق ذرعا بحمل الماء منصاح
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحج المبرور فقال: [العج والثج] فالعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: إراقة الدماء وذبح الهدايا. وقال ابن زيد: ثجاجا كثيرا. والمعنى واحد.
قوله تعالى: "لنخرج به" أي بذلك الماء "حبا" كالحنطة والشعير وغير ذلك
"ونباتا" من الأب، وهو ما تأكله الدواب من الحشيش. "وجنات" أي بساتين
"ألفاقا" أي ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصانها، ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. وقيل: واحد الألفاف لف بالكسر ولف بالضم. ذكره الكسائي، قال:
جنة لُفٌّ وعيشٌ مغدِق وندامى كلهم بيض زُهُرْ
وعنه أيضا وأبي عبيدة: لفيف كشريف وأشراف. وقيل: هو جمع الجمع. حكاه الكسائي. يقال: جنة لفاء ونبت لف والجمع لف بضم اللام مثل حمر، ثم يجمع اللف ألفافا. الزمخشري : ولو قيل جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان وجيها. ويقال: شجرة لفاء وشجر لف وامرأة لفاء: أي غليظة الساق مجتمعة اللحم. وقيل: التقدير: ونخرج به جنات ألفافا، فحذف لدلالة الكلام عليه. ثم هذا الالتفاف والانضمام معناه أن الأشجار في البساتين تكون متقاربة، فالأغصان من كل شجرة متقاربة لقوتها.
الآية: 17 - 20 {إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سراب}
قوله تعالى: "إن يوم الفصل كان ميقاتا" أي وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين، لما وعد الله من الجزاء والثواب. وسمي يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه. "يوم ينفخ في الصور" أي للبعث "فتأتون" أي إلى موضع العرض.
"أفواجا" أي أمما، كل أمة مع إمامهم. وقيل: زمرا وجماعات. الواحد: فوج. ونصب يوما بدلا من اليوم الأول. وروي من حديث معاذ بن جبل قلت: يا رسول الله! أرأيت قول الله تعالى: "يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معاذ [بن جبل] لقد سألت عن أمر عظيم) ثم أرسل عينيه باكيا، ثم قال: (يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين، وبدل صورهم، فمنهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون: أرجلهم أعلاهم، ووجوههم يسحبون عليها، وبعضهم عمي يتردون، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم، فهي مدلاة على صدورهم، يسيل القيح من أفواههم لعابا، يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من النار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف، وبعضهم ملبسون جلابيب سابغة من القطران لاصقة بجلودهم؛ فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس - يعني النمام - وأما الذين على صورة الخنازير، فأهل السحت والحرام والمكس. وأما المنكسون رؤوسهم ووجوههم، فأكلة الربا، والعمي: من يجور في الحكم، والصم البكم: الذين يعجبون بأعمالهم. والذين يمضغون ألسنتهم: فالعلماء والقصاص الذين يخالف قولهم فعلهم. والمقطعة أيديهم وأرجلهم: فالذين يؤذون الجيران. والمصلبون على جذوع النار: فالسعاة بالناس إلى السلطان والذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات، ويمنعون حق الله من أموالهم. والذين يلبسون الجلابيب: فأهل الكبر والفخر والخيلاء).
قوله تعالى: "وفتحت السماء فكانت أبوابا" أي لنزول الملائكة؛ كما قال تعالى: "ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا" [الفرقان: 25]. وقيل: تقطعت، فكانت قطعا كالأبواب فانتصاب الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف. وقيل: التقدير فكانت ذات أبواب؛ لأنها تصير كلها أبوابا. وقيل: أبوابها طرقها. وقيل: تنحل وتتناثر، حتى تصير فيها أبواب. وقيل: إن لكل عبد بابين في السماء: بابا لعمله، وبابا لرزقه، فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب. وفي حديث الإسراء: (ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا). "وسيرت الجبال فكانت سرابا" أي لا شيء كما أن السراب كذلك: يظنه الرائي ماء وليس بماء.
وقيل: "سيرت" نسفت من أصولها. وقيل: أزيلت عن مواضعها.
الآية: 21 - 30 {إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب}
قوله تعالى: "إن جهنم كانت مرصادا" مفعال من الرصد والرصد: كل شيء كان أمامك. قال الحسن: إن على النار رصدا، لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه، فمن جاء بجواز جاز، ومن لم يجيء بجواز حبس. وعن سفيان رضي الله عنه قال: عليها ثلاث قناطر. وقيل "مرصادا" ذات أرصاد على النسب؛ أي ترصد من يمر بها. وقال مقاتل: محبسا. وقيل: طريقا وممرا، فلا سبيل إلى الجنة حتى يقطع جهنم.
وفي الصحاح: والمرصاد: الطريق. وذكر القشيري: أن المرصاد المكان الذي يرصد فيه الواحد العدو، نحو المضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل. أي هي معدة لهم؛ فالمرصاد بمعنى المحل؛ فالملائكة يرصدون الكفار حتى ينزلوا بجهنم. وذكر الماوردي عن أبي سنان أنها بمعنى راصدة، تجازيهم بأفعالهم. وفي الصحاح: الراصد الشيء: الراقب له؛ تقول: رصده يرصده رصدا ورصدا، والترصد: الترقب. والمرصد: موضع الرصد. الأصمعي: رصدته أرصده: ترقبته، وأرصدته: أعددت له. والكسائي: مثله.
قلت: فجهنم معدة مترصدة، متفعل من الرصد وهو الترقب؛ أي هي متطلعة لمن يأتي. والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمغيار، فكأنه يكثر من جهنم انتظار الكفار.
"للطاغين مآبا" بدل من قوله: "مرصادا" والمآب: المرجع، أي مرجعا يرجعون إليها؛ يقال: آب يؤوب أوبة: إذا رجع. وقال قتادة: مأوى ومنزلا. والمراد بالطاغين من طغى في دينه بالكفر، أو في دنياه بالظلم.
قوله تعالى: "لابثين فيها أحقابا" أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب، وهي لا تنقطع، فكلما مضى حقب جاء حقب. والحقب بضمتين: الدهر والأحقاب الدهور. والحقبة بالكسر: السنة؛ والجمع حقب؛ قال متمم بن نويرة التميمي:
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
والحقب بالضم والسكون: ثمانون سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقل، على ما يأتي، والجمع: أحقاب. والمعنى في الآية؛ [لابثين] فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها؛ فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه؛ إذ في الكلام ذكر الآخرة وهو كما يقال أيام الآخرة؛ أي أيام بعد أيام إلى غير نهاية، وإنما كان يدل على التوقيت لو قال خمسة أحقاب أو عشرة أحقاب. ونحوه وذكر الأحقاب لأن الحقب كان أبعد شيء عندهم، فتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفونها، وهي كناية عن التأبيد، أي يمكثون فيها أبدا. وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأن الأحقاب أهول في القلوب، وأدل على الخلود. والمعنى متقارب؛ وهذا الخلود في حق المشركين. ويمكن حمل الآية على العصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب. وقيل: الأحقاب وقت لشربهم الحميم والغساق، فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر من العقاب؛ ولهذا قال: "لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا". و"لابثين" اسم فاعل من لبث، ويقويه أن المصدر منه اللبث بالإسكان، كالشرب. وقرأ حمزة والكسائي "لبثين" بغير ألف وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد، وهما لغتان؛ يقال: رجل لابث ولبث، مثل طمع وطامع، وفره وفاره. ويقال: هو لبث بمكان كذا: أي قد صار اللبث شأنه، فشبه بما هو خلقة في الإنسان نحو حذر وفرق؛ لأن باب فعل إنما هو لما يكون خلقة في الشيء في الأغلب، وليس كذلك اسم الفاعل من لابث.
والحقب: ثمانون سنة في قول ابن عمر وابن محيصن وأبي هريرة، والسنة ثلثمائة يوم وستون يوما، واليوم ألف سنة من أيام الدنيا، قاله ابن عباس. وروي ابن عمر هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة: والسنة ثلثمائة يوم وستون يوما كل يوم مثل أيام الدنيا. وعن ابن عمر أيضا: الحقب: أربعون سنة. السدي: سبعون سنة. وقيل: إنه ألف شهر. رواه أبو أمامة مرفوعا. بشير بن كعب: ثلاثمائة سنة. الحسن: الأحقاب لا يدري أحدكم هي، ولكن ذكروا أنها مائة حقب، والحقب الواحد منها سبعون ألف سنة، اليوم منها كألف سنة مما تعدون. وعن أبي أمامة أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحُقُب الواحد ثلاثون ألف سنة) ذكره المهدوي. والأول الماوردي. وقال قطرب: هو الدهر الطويل غير المحدود.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (والله لا يخرج من النار من دخلها حتى يكون فيها أحقابا، الحقب بضع وثمانون سنة، والسنة ثلثمائة وستون يوما، كل يوم ألف سنة مما تعدون؛ فلا يتكلن أحدكم على أن يخرج من النار). ذكره الثعلبي. القُرظي: الأحقاب: ثلاثة وأربعون، حقبا كل حقب سبعون خريفا، كل خريف سبعمائة سنة، كل سنة ثلثمائة وستون يوما، كل يوم ألف سنة.
قلت: هذه أقوال متعارضة، والتحديد في الآية للخلود، يحتاج إلى توقيف يقطع العذر، وليس ذلك بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المعنى - والله أعلم - ما ذكرناه أولا؛ أي لابثين فيها أزمانا ودهورا، كلما مضى زمن يعقبه زمن، ودهر يعقبه دهر، هكذا أبد الآبدين من غير انقطاع. وقال ابن كيسان: معنى "لابثين فيها أحقابا" لا غاية لها انتهاء، فكأنه قال أبدا. وقال ابن زيد ومقاتل: إنها منسوخة بقوله تعالى: "فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا" يعني أن العدد قد انقطع، والخلود قد حصل.
قلت: وهذا بعيد؛ لأنه خبر، وقد قال تعالى: "ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط" [الأعراف: 40] على ما تقدم. هذا في حق الكفار، فأما العصاة الموحدون فصحيح ويكون النسخ بمعنى التخصيص. والله أعلم. وقيل: المعنى "لابثين فيها أحقابا" أي في الأرض؛ إذ قد تقدم ذكرها ويكون الضمير في "لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا" لجهنم. وقيل: واحد الأحقاب حقب وحقبة؛ قال:
فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقها فأنت بما أحدثته بالمجرب
وقال الكميت:
مر لها بعد حقبة حقب
قوله تعالى: "لا يذوقون فيها" أي في الأحقاب "بردا ولا شرابا" البرد: النوم في قول أبي عبيدة وغيره؛ قال الشاعر:
ولو شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نُقاخا ولا بردا
وقاله مجاهد والسدي والكسائي والفضل بن خالد وأبو معاذ النحوي؛ وأنشدوا قول الكندي:
بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن تقبيلها البرد
يعني النوم. والعرب تقول: منع البرد البرد، يعني: أذهب البرد النوم.
قلت: وقد جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل هل في الجنة نوم. فقال: (لا؛ النوم أخو الموت، والجنة لا موت فيها) فكذلك النار؛ وقد قال تعالى: "لا يقضى عليهم فيموتوا" [فاطر: 36] وقال ابن عباس: البرد: برد الشراب. وعنه أيضا: البرد النوم: والشراب الماء. وقال الزجاج: أي لا يذوقون فيها برد ريح، ولا ظل، ولا نوم. فجعل البرد برد كل شيء له راحة، وهذا برد ينفعهم، فأما الزمهرير فهو برد يتأذون به، فلا ينفعهم، فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. وقال الحسن وعطاء وابن زيد: بردا: أي روحا وراحة؛ قال الشاعر:
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء أوقات العشي تذوق
قوله تعالى: "لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا" جملة في موضع الحال من الطاغين، أو نعت للأحقاب؛ فالأحقاب ظرف زمان، والعامل فيه "لابثين" أو "لبثين" على تعدية فعل. "إلا حميما وغساقا" استثناء منقطع في قول من جعل البرد النوم، ومن جعله من البرودة كان بدلا منه. والحميم: الماء الحار؛ قاله أبو عبيدة. وقال ابن زيد: الحميم: دموع أعينهم، تجمع في حياض ثم يسقونه. قال النحاس: أصل الحميم: الماء الحار، ومنه اشتق الحمام، ومنه الحمى، ومنه "وظل من يحموم": إنما يراد به النهاية في الحر. والغساق: صديد أهل النار وقيحهم. وقيل الزمهرير. وقرأ حمزة والكسائي بتشديد السين، وقد مضى في "ص" القول فيه. "جزاء وفاقا" أي موافقا لأعمالهم. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما؛ فالوفاق بمعنى الموافقة كالقتال بمعنى المقاتلة. و"جزاء" نصب على المصدر، أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم؛ قال الفراء والأخفش. وقال الفراء أيضا: هو جمع الوفق، والوفق واللفق واحد. وقال مقاتل. وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك، ولا عذاب أعظم من النار. وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة، فأتاهم الله بما يسوءهم. "إنهم كانوا لا يرجون" أي لا يخافون "حسابا" أي محاسبة على أعمالهم. وقيل: معناه لا يرجون ثواب حساب. الزجاج: أي إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم. "وكذبوا بآياتنا كذابا" أي بما جاءت به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. وقراءة العامة "كذابا" بتشديد الذال، وكسر الكاف، على كذب، أي كذبوا تكذيبا كبيرا. قال الفراء: هي لغة يمانية فسيحة؛ يقولون: كذبت [به] كذابا، وخرقت القميص خراقا؛ وكل فعل في وزن (فعل) فمصدره فعال مشدد في لغتهم؛ وأنشد بعض الكلابيين:
لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائنا
وقرأ علي رضي الله عنه "كذابا" بالتخفيف وهو مصدر أيضا. وقال أبو علي: التخفيف والتشديد جميعا: مصدر المكاذبة، كقول الأعشى:
فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه
أبو الفتح: جاءا جميعا مصدر كذب وكذب جميعا. الزمخشري: "كذابا" بالتخفيف مصدر كذب؛ بدليل قوله:
فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه
وهو مثل قوله: "أنبتكم من الأرض نباتا" [نوح: 17] يعني وكذبوا بآياتنا أفكذبوا كذابا. أو تنصبه بـ "كذبوا". لأنه يتضمن معنى كذبوا؛ لأن كل مكذب بالحق كاذب؛ لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين، وكان المسلمون عندهم كاذبين، فبينهم مكاذبة. وقرأ ابن عمر "كذابا" بضم الكاف والتشديد، جمع كاذب؛ قاله أبو حاتم. ونصبه على الحال الزمخشري. وقد يكون الكذاب: بمعنى الواحد البليغ في الكذب، يقال: رجل كذاب، كقولك حسان وبخال، فيجعله صفة لمصدر "كذبوا" أي تكذيبا كذابا مفرطا كذبه. وفي الصحاح: وقوله تعالى: "وكذبوا بآياتنا كذابا" وهو أحد مصادر المشدد؛ لأن مصدره قد يجيء على (تفعيل) مثل التكليم وعلى (فعال) كذاب وعلى (تفعلة) مثل توصية، وعلى (مفعل)؛ "ومزقناهم كل ممزق". "وكل شيء أحصيناه كتابا" "كل" نصب بإضمار فعل يدل عليه "أحصيناه" أي وأحصينا كل شيء أحصيناه. وقرأ أبو السمال "وكل شيء" بالرفع على الابتداء.
"كتابا" نصب على المصدر؛ لأن معنى أحصينا: كتبنا، أي كتبناه كتابا. ثم قيل: أراد به العلم، فإن ما كتب كان أبعد من النسيان. وقيل: أي كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة. وقيل: أراد ما كتب على العباد من أعمالهم. فهذه كتابة صدرت عن الملائكة الموكلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دليله قوله تعالى: "وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين" [الانفطار: 10]. "فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا" قال أبو برزة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد آية في القرآن؟ فقال: قوله تعالى: "فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا" أي "كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها" [النساء: 56] و"كلما خبت زدناهم سعيرا" [الإسراء: 97].
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 582
582- تفسير الصفحة رقم582 من المصحفسورة عم
الآية: 1 - 5 {عم يتساءلون، عن النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون}
قوله تعالى: "عم" لفظ استفهام؛ ولذلك سقطت منها ألف "ما"، ليتميز الخبر عن الاستفهام. وكذلك (فيم، ومم) إذا استفهمت. والمعنى عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. وقال الزجاج: أصل "عم" عن ما فأدغمت النون في الميم، لأنها تشاركها في الغنة. والضمير في "يتساءلون" لقريش. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب به فنزلت "عم يتساءلون"؟ وقيل: "عم" بمعنى: فيم يتشدد المشركون ويختصمون.
قوله تعالى: "عن النبأ العظيم" أي يتساءلون "عن النبأ العظيم" فعن ليس تتعلق بـ "يتساءلون" الذي في التلاوة؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون "عن النبأ العظيم" كقولك: كم مالك أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرناه من امتناع تعلقه "بيتساءلون" الذي في التلاوة، وإنما يتعلق بيتساءلون آخر مضمر. وحسن ذلك لتقدم يتساءلون؛ قال المهدوي. وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: "عن" مكرر إلا أنه مضمر، كأنه قال عم يتساءلون أعن النبأ العظيم؟ فعلى هذا يكون متصلا بالآية الأولى. و "النبأ العظيم" أي الخبر الكبير.
قوله تعالى: "الذي هم فيه مختلفون" أي يخالف فيه بعضهم بعضا، فيصدق واحد ويكذب آخر؛ فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو القرآن؛ دليله قوله: "قل هو نبأ عظيم. أنتم عنه معرضون" فالقرآن نبأ وخبر وقصص، وهو نبأ عظيم الشأن.
وروى سعيد عن قتادة قال: هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجلين: مصدق ومكذب. وقيل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وروي الضحاك عن ابن عباس قال: وذلك أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم، ثم هددهم فقال: "كلا سيعلمون" أي سيعلمون عاقبة القرآن، أو سيعلمون البعث: أحق هو أم باطل. و "كلا" رد عليهم في إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن، فيوقف عليها. ويجوز أن يكون بمعنى حقا أو "ألا" فيبدأ بها. والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا: والذي يدل عليه قوله عز وجل: "إن يوم الفصل كان ميقاتا" [النبأ: 17] يدل على أنهم كانوا يتساءلون عن البعث. "ثم كلا سيعلمون" أي حقا ليعلمن صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت. وقال الضحاك: "كلا سيعلمون" يعني الكافرين عاقبة تكذيبهم. "ثم كلا سيعلمون" يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم. وقيل: بالعكس أيضا. وقال الحسن: هو وعيد بعد وعيد. وقراءة العامة فيهما بالياء على الخبر؛ لقوله تعالى: "يتساءلون" وقوله: "هم فيه مختلفون". وقرأ الحسن وأبو العالية ومالك بن دينار بالتاء فيهما.
الآية: 6 - 16 {ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفاف}
قوله تعالى: "ألم نجعل الأرض مهادا" دلهم على قدرته على البعث؛ أي قدرتنا على إيجاد هذه الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة. والمهاد: الوطاء والفراش. وقد قال تعالى: "الذي جعل لكم الأرض فراشا" [البقرة: 22] وقرئ "مهدا". ومعناه أنها لهم كالمهد للصبي وهو ما يمهد له فينوم عليه "والجبال أوتادا" أي لتسكن ولا تتكفأ ولا تميل بأهلها. "وخلقناكم أزواجا" أي أصنافا: ذكرا وأنثى. وقيل: ألوانا. وقيل: يدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن، وطويل وقصير؛ لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار، فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. "وجعلنا نومكم سباتا" "جعلنا" معناه صيرنا؛ ولذلك تعدت إلى مفعولين. "سباتا" المفعول الثاني، أي راحة لأبدانكم، ومنه يوم السبت أي يوم الراحة؛ أي قيل لبني إسرائيل: استريحوا في هذا اليوم، فلا تعملوا فيه شيئا. وأنكر ابن الأنباري هذا وقال: لا يقال للراحة سبات. وقيل: أصله التمدد؛ يقال: سبتت المرأة شعرها: إذا حلته وأرسلته، فالسبات كالمد، ورجل مسبوت الخلق: أي ممدود. وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدد، فسميت الراحة سبتا. وقيل: أصله القطع؛ يقال: سبت شعره سبتا: حلقه؛ وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغال، فالسبات يشبه الموت، إلا أنه لم تفارقه الروح. ويقال: سير سبت: أي سهل لين؛ قال الشاعر:
ومطوية الأقراب أما نهارها فسبت وأما ليلها فذميل
"وجعلنا الليل لباسا" أي تلبسكم ظلمته وتغشاكم؛ قال الطبري. وقال ابن جبير والسدي: أي سكنا لكم. "وجعلنا النهار معاشا" فيه إضمار، أي وقت معاش، أي متصرفا لطلب المعاش وهو كل ما معاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك فـ "معاشا" على هذا اسم زمان، ليكون الثاني هو الأول. ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى العيش على تقدير حذف المضاف. "وبنينا فوقكم سبعا شدادا" أي سبع سموات محكمات؛ أي محكمة الخلق وثيقة البنيان. "وجعلنا سراجا وهاجا" أي وقادا وهي الشمس. وجعل هنا بمعنى خلق؛ لأنها تعدت لمفعول واحد والوهاج الذي له وهج؛ يقال: وهج يهج وهجا ووهجا ووهجانا. ويقال للجوهر إذا تلألأ توهج. وقال ابن عباس: وهاجا منيرا متلألئا. "وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا" قال مجاهد وقتادة: والمعصرات الرياح. وقاله ابن عباس: كأنها تعصر السحاب. وعن ابن عباس أيضا: أنها السحاب. وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك: أي السحائب التي تنعصر بالماء ولما تمطر بعد، كالمرأة المعصر التي قددنا حيضها ولم تحض، قال أبو النجم:
تمشي الهوينى مائلا خمارها قد أعصرت أوقد دنا إعصارها
وقال آخر:
فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر
وقال آخر:
وذي أشر كالأقحوان يزينه ذهاب الصبا والمعصرات الروائح
فالرياح تسمى معصرات؛ يقال: أعصرت الريح تعصر إعصارا: إذا أثارت العجاج، وهي الإعصار، والسحب أيضا تسمى المعصرات لأنها تمطر. وقال قتادة أيضا: المعصرات السماء، النحاس: هذه الأقوال صحاح؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر معصرات، والرياح تلقح السحاب، فيكون المطر، والمطر ينزل من الريح على هذا. ويجوز أن تكون الأقوال واحدة، ويكون المعنى وأنزلنا من ذوات الرياح المعصرات "ماء ثجاجا" وأصح الأقوال أن المعصرات؛ السحاب. كذا المعروف أن الغيث منها، ولو كان (بالمعصرات) لكان الريح أولى. وفي الصحاح: والمعصرات السحائب تعتصر بالمطر. وأعصر القوم أي أمطروا؛ ومنه قرأ بعضهم "وفيه يعصرون" والمعصر: الجارية أول ما أدركت وحاضت؛ يقال: قد أعصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته؛ قال الراجز:
جارية بسفوان دارها تمشي الهوينى ساقطا خمارها
قد أعصرت أو قد دنا إعصارها
والجمع: معاصر، ويقال: هي التي قاربت الحيض؛ لأن الإعصار في الجارية كالمراهقة في الغلام. سمعته من أبي الغوث الأعرابي. قال غيره: والمعصر السحابة التي حان لها أن تمطر؛ يقال أجن الزرع فهو مجن: أي صار إلى أن يجن، وكذلك السحاب إذا صار إلى أن يمطر فقد أعصر. وقال المبرد: يقال سحاب معصر أي ممسك للماء، ويعتصر منه شيء بعد شيء، ومنه العصر بالتحريك للملجأ الذي يلجأ إليه، والعصرة بالضم أيضا الملجأ. وقد مضى هذا المعنى في سورة "يوسف" والحمد لله. وقال أبو زبيد:
صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود
ومنه المعصر للجارية التي قد قربت من البلوغ يقال لها معصر؛ لأنها تحبس في البيت، فيكون البيت لها عصرا. وفي قراءة ابن عباس وعكرمة "وأنزلنا بالمعصرات". والذي في المصاحف "من المعصرات" قال أبي بن كعب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان: "من المعصرات" أي من السموات. "ماء ثجاجا" صبابا متتابعا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال: ثججت دمه فأنا أثجه ثجا، وقد ثج الدم يثج ثجوجا، وكذلك الماء، فهو لازم ومتعد. والثجاج في الآية المنصب. وقال الزجاج: أي الضباب، وهو متعد كأنه يثج: نفسه أي يصب. وقال عبيد بن الأبرص:
فثج أعلاه ثم ارتج أسفله وضاق ذرعا بحمل الماء منصاح
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحج المبرور فقال: [العج والثج] فالعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: إراقة الدماء وذبح الهدايا. وقال ابن زيد: ثجاجا كثيرا. والمعنى واحد.
قوله تعالى: "لنخرج به" أي بذلك الماء "حبا" كالحنطة والشعير وغير ذلك
"ونباتا" من الأب، وهو ما تأكله الدواب من الحشيش. "وجنات" أي بساتين
"ألفاقا" أي ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصانها، ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. وقيل: واحد الألفاف لف بالكسر ولف بالضم. ذكره الكسائي، قال:
جنة لُفٌّ وعيشٌ مغدِق وندامى كلهم بيض زُهُرْ
وعنه أيضا وأبي عبيدة: لفيف كشريف وأشراف. وقيل: هو جمع الجمع. حكاه الكسائي. يقال: جنة لفاء ونبت لف والجمع لف بضم اللام مثل حمر، ثم يجمع اللف ألفافا. الزمخشري : ولو قيل جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان وجيها. ويقال: شجرة لفاء وشجر لف وامرأة لفاء: أي غليظة الساق مجتمعة اللحم. وقيل: التقدير: ونخرج به جنات ألفافا، فحذف لدلالة الكلام عليه. ثم هذا الالتفاف والانضمام معناه أن الأشجار في البساتين تكون متقاربة، فالأغصان من كل شجرة متقاربة لقوتها.
الآية: 17 - 20 {إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سراب}
قوله تعالى: "إن يوم الفصل كان ميقاتا" أي وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين، لما وعد الله من الجزاء والثواب. وسمي يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه. "يوم ينفخ في الصور" أي للبعث "فتأتون" أي إلى موضع العرض.
"أفواجا" أي أمما، كل أمة مع إمامهم. وقيل: زمرا وجماعات. الواحد: فوج. ونصب يوما بدلا من اليوم الأول. وروي من حديث معاذ بن جبل قلت: يا رسول الله! أرأيت قول الله تعالى: "يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معاذ [بن جبل] لقد سألت عن أمر عظيم) ثم أرسل عينيه باكيا، ثم قال: (يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين، وبدل صورهم، فمنهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون: أرجلهم أعلاهم، ووجوههم يسحبون عليها، وبعضهم عمي يتردون، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم، فهي مدلاة على صدورهم، يسيل القيح من أفواههم لعابا، يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من النار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف، وبعضهم ملبسون جلابيب سابغة من القطران لاصقة بجلودهم؛ فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس - يعني النمام - وأما الذين على صورة الخنازير، فأهل السحت والحرام والمكس. وأما المنكسون رؤوسهم ووجوههم، فأكلة الربا، والعمي: من يجور في الحكم، والصم البكم: الذين يعجبون بأعمالهم. والذين يمضغون ألسنتهم: فالعلماء والقصاص الذين يخالف قولهم فعلهم. والمقطعة أيديهم وأرجلهم: فالذين يؤذون الجيران. والمصلبون على جذوع النار: فالسعاة بالناس إلى السلطان والذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات، ويمنعون حق الله من أموالهم. والذين يلبسون الجلابيب: فأهل الكبر والفخر والخيلاء).
قوله تعالى: "وفتحت السماء فكانت أبوابا" أي لنزول الملائكة؛ كما قال تعالى: "ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا" [الفرقان: 25]. وقيل: تقطعت، فكانت قطعا كالأبواب فانتصاب الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف. وقيل: التقدير فكانت ذات أبواب؛ لأنها تصير كلها أبوابا. وقيل: أبوابها طرقها. وقيل: تنحل وتتناثر، حتى تصير فيها أبواب. وقيل: إن لكل عبد بابين في السماء: بابا لعمله، وبابا لرزقه، فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب. وفي حديث الإسراء: (ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا). "وسيرت الجبال فكانت سرابا" أي لا شيء كما أن السراب كذلك: يظنه الرائي ماء وليس بماء.
وقيل: "سيرت" نسفت من أصولها. وقيل: أزيلت عن مواضعها.
الآية: 21 - 30 {إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب}
قوله تعالى: "إن جهنم كانت مرصادا" مفعال من الرصد والرصد: كل شيء كان أمامك. قال الحسن: إن على النار رصدا، لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه، فمن جاء بجواز جاز، ومن لم يجيء بجواز حبس. وعن سفيان رضي الله عنه قال: عليها ثلاث قناطر. وقيل "مرصادا" ذات أرصاد على النسب؛ أي ترصد من يمر بها. وقال مقاتل: محبسا. وقيل: طريقا وممرا، فلا سبيل إلى الجنة حتى يقطع جهنم.
وفي الصحاح: والمرصاد: الطريق. وذكر القشيري: أن المرصاد المكان الذي يرصد فيه الواحد العدو، نحو المضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل. أي هي معدة لهم؛ فالمرصاد بمعنى المحل؛ فالملائكة يرصدون الكفار حتى ينزلوا بجهنم. وذكر الماوردي عن أبي سنان أنها بمعنى راصدة، تجازيهم بأفعالهم. وفي الصحاح: الراصد الشيء: الراقب له؛ تقول: رصده يرصده رصدا ورصدا، والترصد: الترقب. والمرصد: موضع الرصد. الأصمعي: رصدته أرصده: ترقبته، وأرصدته: أعددت له. والكسائي: مثله.
قلت: فجهنم معدة مترصدة، متفعل من الرصد وهو الترقب؛ أي هي متطلعة لمن يأتي. والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمغيار، فكأنه يكثر من جهنم انتظار الكفار.
"للطاغين مآبا" بدل من قوله: "مرصادا" والمآب: المرجع، أي مرجعا يرجعون إليها؛ يقال: آب يؤوب أوبة: إذا رجع. وقال قتادة: مأوى ومنزلا. والمراد بالطاغين من طغى في دينه بالكفر، أو في دنياه بالظلم.
قوله تعالى: "لابثين فيها أحقابا" أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب، وهي لا تنقطع، فكلما مضى حقب جاء حقب. والحقب بضمتين: الدهر والأحقاب الدهور. والحقبة بالكسر: السنة؛ والجمع حقب؛ قال متمم بن نويرة التميمي:
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
والحقب بالضم والسكون: ثمانون سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقل، على ما يأتي، والجمع: أحقاب. والمعنى في الآية؛ [لابثين] فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها؛ فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه؛ إذ في الكلام ذكر الآخرة وهو كما يقال أيام الآخرة؛ أي أيام بعد أيام إلى غير نهاية، وإنما كان يدل على التوقيت لو قال خمسة أحقاب أو عشرة أحقاب. ونحوه وذكر الأحقاب لأن الحقب كان أبعد شيء عندهم، فتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفونها، وهي كناية عن التأبيد، أي يمكثون فيها أبدا. وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأن الأحقاب أهول في القلوب، وأدل على الخلود. والمعنى متقارب؛ وهذا الخلود في حق المشركين. ويمكن حمل الآية على العصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب. وقيل: الأحقاب وقت لشربهم الحميم والغساق، فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر من العقاب؛ ولهذا قال: "لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا". و"لابثين" اسم فاعل من لبث، ويقويه أن المصدر منه اللبث بالإسكان، كالشرب. وقرأ حمزة والكسائي "لبثين" بغير ألف وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد، وهما لغتان؛ يقال: رجل لابث ولبث، مثل طمع وطامع، وفره وفاره. ويقال: هو لبث بمكان كذا: أي قد صار اللبث شأنه، فشبه بما هو خلقة في الإنسان نحو حذر وفرق؛ لأن باب فعل إنما هو لما يكون خلقة في الشيء في الأغلب، وليس كذلك اسم الفاعل من لابث.
والحقب: ثمانون سنة في قول ابن عمر وابن محيصن وأبي هريرة، والسنة ثلثمائة يوم وستون يوما، واليوم ألف سنة من أيام الدنيا، قاله ابن عباس. وروي ابن عمر هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة: والسنة ثلثمائة يوم وستون يوما كل يوم مثل أيام الدنيا. وعن ابن عمر أيضا: الحقب: أربعون سنة. السدي: سبعون سنة. وقيل: إنه ألف شهر. رواه أبو أمامة مرفوعا. بشير بن كعب: ثلاثمائة سنة. الحسن: الأحقاب لا يدري أحدكم هي، ولكن ذكروا أنها مائة حقب، والحقب الواحد منها سبعون ألف سنة، اليوم منها كألف سنة مما تعدون. وعن أبي أمامة أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحُقُب الواحد ثلاثون ألف سنة) ذكره المهدوي. والأول الماوردي. وقال قطرب: هو الدهر الطويل غير المحدود.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (والله لا يخرج من النار من دخلها حتى يكون فيها أحقابا، الحقب بضع وثمانون سنة، والسنة ثلثمائة وستون يوما، كل يوم ألف سنة مما تعدون؛ فلا يتكلن أحدكم على أن يخرج من النار). ذكره الثعلبي. القُرظي: الأحقاب: ثلاثة وأربعون، حقبا كل حقب سبعون خريفا، كل خريف سبعمائة سنة، كل سنة ثلثمائة وستون يوما، كل يوم ألف سنة.
قلت: هذه أقوال متعارضة، والتحديد في الآية للخلود، يحتاج إلى توقيف يقطع العذر، وليس ذلك بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المعنى - والله أعلم - ما ذكرناه أولا؛ أي لابثين فيها أزمانا ودهورا، كلما مضى زمن يعقبه زمن، ودهر يعقبه دهر، هكذا أبد الآبدين من غير انقطاع. وقال ابن كيسان: معنى "لابثين فيها أحقابا" لا غاية لها انتهاء، فكأنه قال أبدا. وقال ابن زيد ومقاتل: إنها منسوخة بقوله تعالى: "فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا" يعني أن العدد قد انقطع، والخلود قد حصل.
قلت: وهذا بعيد؛ لأنه خبر، وقد قال تعالى: "ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط" [الأعراف: 40] على ما تقدم. هذا في حق الكفار، فأما العصاة الموحدون فصحيح ويكون النسخ بمعنى التخصيص. والله أعلم. وقيل: المعنى "لابثين فيها أحقابا" أي في الأرض؛ إذ قد تقدم ذكرها ويكون الضمير في "لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا" لجهنم. وقيل: واحد الأحقاب حقب وحقبة؛ قال:
فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقها فأنت بما أحدثته بالمجرب
وقال الكميت:
مر لها بعد حقبة حقب
قوله تعالى: "لا يذوقون فيها" أي في الأحقاب "بردا ولا شرابا" البرد: النوم في قول أبي عبيدة وغيره؛ قال الشاعر:
ولو شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نُقاخا ولا بردا
وقاله مجاهد والسدي والكسائي والفضل بن خالد وأبو معاذ النحوي؛ وأنشدوا قول الكندي:
بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن تقبيلها البرد
يعني النوم. والعرب تقول: منع البرد البرد، يعني: أذهب البرد النوم.
قلت: وقد جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل هل في الجنة نوم. فقال: (لا؛ النوم أخو الموت، والجنة لا موت فيها) فكذلك النار؛ وقد قال تعالى: "لا يقضى عليهم فيموتوا" [فاطر: 36] وقال ابن عباس: البرد: برد الشراب. وعنه أيضا: البرد النوم: والشراب الماء. وقال الزجاج: أي لا يذوقون فيها برد ريح، ولا ظل، ولا نوم. فجعل البرد برد كل شيء له راحة، وهذا برد ينفعهم، فأما الزمهرير فهو برد يتأذون به، فلا ينفعهم، فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. وقال الحسن وعطاء وابن زيد: بردا: أي روحا وراحة؛ قال الشاعر:
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء أوقات العشي تذوق
قوله تعالى: "لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا" جملة في موضع الحال من الطاغين، أو نعت للأحقاب؛ فالأحقاب ظرف زمان، والعامل فيه "لابثين" أو "لبثين" على تعدية فعل. "إلا حميما وغساقا" استثناء منقطع في قول من جعل البرد النوم، ومن جعله من البرودة كان بدلا منه. والحميم: الماء الحار؛ قاله أبو عبيدة. وقال ابن زيد: الحميم: دموع أعينهم، تجمع في حياض ثم يسقونه. قال النحاس: أصل الحميم: الماء الحار، ومنه اشتق الحمام، ومنه الحمى، ومنه "وظل من يحموم": إنما يراد به النهاية في الحر. والغساق: صديد أهل النار وقيحهم. وقيل الزمهرير. وقرأ حمزة والكسائي بتشديد السين، وقد مضى في "ص" القول فيه. "جزاء وفاقا" أي موافقا لأعمالهم. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما؛ فالوفاق بمعنى الموافقة كالقتال بمعنى المقاتلة. و"جزاء" نصب على المصدر، أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم؛ قال الفراء والأخفش. وقال الفراء أيضا: هو جمع الوفق، والوفق واللفق واحد. وقال مقاتل. وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك، ولا عذاب أعظم من النار. وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة، فأتاهم الله بما يسوءهم. "إنهم كانوا لا يرجون" أي لا يخافون "حسابا" أي محاسبة على أعمالهم. وقيل: معناه لا يرجون ثواب حساب. الزجاج: أي إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم. "وكذبوا بآياتنا كذابا" أي بما جاءت به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. وقراءة العامة "كذابا" بتشديد الذال، وكسر الكاف، على كذب، أي كذبوا تكذيبا كبيرا. قال الفراء: هي لغة يمانية فسيحة؛ يقولون: كذبت [به] كذابا، وخرقت القميص خراقا؛ وكل فعل في وزن (فعل) فمصدره فعال مشدد في لغتهم؛ وأنشد بعض الكلابيين:
لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائنا
وقرأ علي رضي الله عنه "كذابا" بالتخفيف وهو مصدر أيضا. وقال أبو علي: التخفيف والتشديد جميعا: مصدر المكاذبة، كقول الأعشى:
فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه
أبو الفتح: جاءا جميعا مصدر كذب وكذب جميعا. الزمخشري: "كذابا" بالتخفيف مصدر كذب؛ بدليل قوله:
فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه
وهو مثل قوله: "أنبتكم من الأرض نباتا" [نوح: 17] يعني وكذبوا بآياتنا أفكذبوا كذابا. أو تنصبه بـ "كذبوا". لأنه يتضمن معنى كذبوا؛ لأن كل مكذب بالحق كاذب؛ لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين، وكان المسلمون عندهم كاذبين، فبينهم مكاذبة. وقرأ ابن عمر "كذابا" بضم الكاف والتشديد، جمع كاذب؛ قاله أبو حاتم. ونصبه على الحال الزمخشري. وقد يكون الكذاب: بمعنى الواحد البليغ في الكذب، يقال: رجل كذاب، كقولك حسان وبخال، فيجعله صفة لمصدر "كذبوا" أي تكذيبا كذابا مفرطا كذبه. وفي الصحاح: وقوله تعالى: "وكذبوا بآياتنا كذابا" وهو أحد مصادر المشدد؛ لأن مصدره قد يجيء على (تفعيل) مثل التكليم وعلى (فعال) كذاب وعلى (تفعلة) مثل توصية، وعلى (مفعل)؛ "ومزقناهم كل ممزق". "وكل شيء أحصيناه كتابا" "كل" نصب بإضمار فعل يدل عليه "أحصيناه" أي وأحصينا كل شيء أحصيناه. وقرأ أبو السمال "وكل شيء" بالرفع على الابتداء.
"كتابا" نصب على المصدر؛ لأن معنى أحصينا: كتبنا، أي كتبناه كتابا. ثم قيل: أراد به العلم، فإن ما كتب كان أبعد من النسيان. وقيل: أي كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة. وقيل: أراد ما كتب على العباد من أعمالهم. فهذه كتابة صدرت عن الملائكة الموكلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دليله قوله تعالى: "وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين" [الانفطار: 10]. "فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا" قال أبو برزة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد آية في القرآن؟ فقال: قوله تعالى: "فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا" أي "كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها" [النساء: 56] و"كلما خبت زدناهم سعيرا" [الإسراء: 97].










الصفحة رقم 582 من المصحف تحميل و استماع mp3