سورة المائدة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
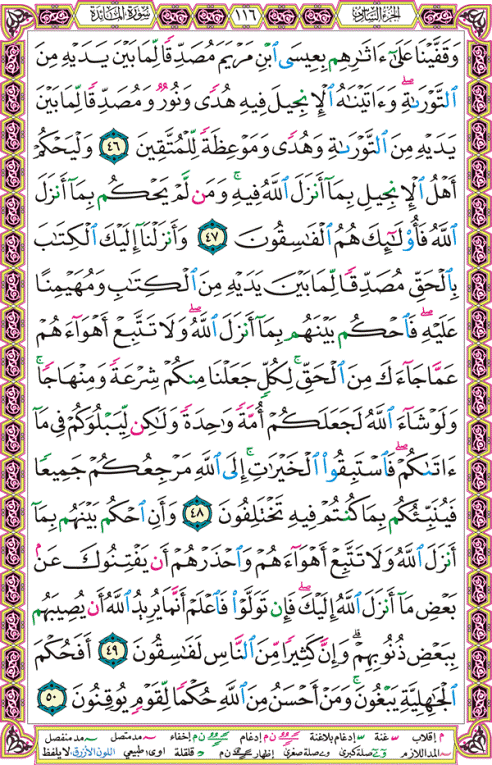
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 116 من المصحف
الآيتان: 46 - 47 {وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}
قوله تعالى: "وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم" أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم، أي آثار النبيين الذين أسلموا. "مصدقا لما بين يديه" يعني التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقا، ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأتي ناسخ. "مصدقا" نصب على الحال من عيسى. "فيه هدى" في موضع رفع بالابتداء. "ونور" عطف عليه. "ومصدقا" فيه وجهان؛ يجوز أن يكون لعيسى وتعطفه على مصدقا الأول، ويجوز أن يكون حالا من الإنجيل، ويكون التقدير: وأتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور ومصدقا "وهدى وموعظة" عطف على "مصدقا" أي هاديا وواعظا "للمتقين" وخصهم لأنهم المنتفعون بهما. ويجوز رفعهما على العطف على قوله: "فيه هدى ونور".
قوله تعالى: "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه" قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي. والباقون بالجزم على الأمر؛ فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله: "وآتيناه" فلا يجوز الوقف؛ أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: "وأن احكم بينهم" [المائدة: 49] فهو إلزام مستأنف يبتدأ به، أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت، فأما الآن فهو منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. قال مكي: والاختيار الجزم؛ لأن الجماعة عليه؛ ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل. قال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عز وجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه، وأمر بالعمل بما فيه؛ فصحتا جميعا.
الآية: 48 {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون}
قوله تعالى: "وأنزلنا إليك الكتاب" الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم "الكتاب" القرآن "بالحق" أي هو بالأمر الحق "مصدقا" حال. "لما بين يديه من الكتاب" أي من جنس الكتب. "ومهيمنا عليه" أي عاليا عليه ومرتفعا. وهذا يدل على تأويل من يقول بالتفضيل أي في كثرة الثواب، على ما تقدمت إليه الإشارة في "الفاتحة" وهو اختيار ابن الحصار في كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرج الأسماء الحسنى والحمد لله. وقال قتادة: المهيمن معناه المشاهد. وقيل: الحافظ. وقال الحسن: المصدق؛ ومنه قول الشاعر:
إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذوو الألباب
وقال ابن عباس: "ومهيمنا عليه" أي مؤتمنا عليه. قال سعيد بن جبير: القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب، وعن ابن عباس والحسن أيضا: المهيمن الأمين. قال المبرد: أصله مؤتمن أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في أرقت الماء هرقت، وقاله الزجاج أيضا وأبو علي. وقد صرف فقيل: هيمن يهيمن هيمنة، وهو مهيمن بمعنى كان أمينا. الجوهري: هو من آمن غيره من الخوف؛ وأصله أأمن فهو مؤامن بهمزتين، قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مؤتمن، ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا: هراق الماء وأراقه؛ يقال منه: هيمن على الشيء يهيمن إذا كان له حافظا، فهو مهيمن؛ عن أبى عبيد. وقرأ مجاهد وابن محيصن: "ومهينا عليه" بفتح الميم. قال مجاهد: أي محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمن على القرآن.
قوله تعالى: "فاحكم بينهم بما أنزل الله" يوجب الحكم؛ فقيل: هذا نسخ للتخيير في قوله: "فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" وقيل: ليس هذا وجوبا، والمعنى: فاحكم بينهم إن شئت؛ إذ لا يجب عليا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذمة. وفي أهل الذمة تردد وقد مضى الكلام فيه. وقيل: أراد فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجبا عليه.
قوله تعالى: "ولا تتبع أهواءهم" يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على ما جاءك من الحق؛ يعني لا تترك الحكم بما بين الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام. والأهواء جمع هوى؛ ولا يجمع أهوية؛ وقد تقدم في "البقرة". فنهاه عن أن يتبعهم فيما يريدونه؛ وهو يدل على بطلان قول من قال: تقوم الخمر على من أتلفها عليهم؛ لأنها ليست مالا لهم فتكون مضمونة على متلفها؛ لأن إيجاب ضمانها على متلفها حكم بموجب أهواء اليهود؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك. ومعنى "عما جاءك" على ما جاءك. "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" يدل على عدم التعلق بشرائع الأولين. والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. والشريعة في اللغة: الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء. والشريعة ما شرع الله لعباده من الدين؛ وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سن. والشارع الطريق الأعظم. والشرعة أيضا الوتر، والجمع شرع وشرع وشراع جمع الجمع؛ عن أبي عبيد؛ فهو مشترك. والمنهاج الطريق المستمر، وهو النهج والمنهج، أي البين؛ قال الراجز:
من يك ذا شك فهذا فلج ماء رواء وطريق نهج
وقال أبو العباس محمد بن يزيد: الشريعة ابتداء الطريق؛ المنهاج الطريق المستمر. وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما "شرعة ومنهاجا" سنة وسبيلا. ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها؛ والإنجيل لأهله؛ والقرآن لأهله؛ وهذا في الشرائع والعبادات؛ والأصل التوحيد لا اختلاف فيه؛ روي معنى ذلك عن قتادة. وقال مجاهد: الشرعة والمنهاج دين محمد عليه السلام؛ وقد نسخ به كل ما سواه.
قوله تعالى: "ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" أي لجعل شريعتكم واحدة فكنتم على الحق؛ فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم. "ولكن ليبلوكم في ما آتاكم" في الكلام حذف تتعلق به لام كي؛ أي ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم؛ والابتلاء الاختبار.
قوله تعالى: "فاستبقوا الخيرات" أي سارعوا إلى الطاعات؛ وهذا يدل على أن تقديمه الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها إلا في الصلاة في أول الوقت؛ فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها، وعموم الآية دليل عليه؛ قال الكيا. وفيه دليل على أن الصوم في السفر أولى من الفطر، وقد تقدم جميع هذا في "البقرة" "إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون" أي بما اختلفتم فيه، وتزول الشكوك.
الآية: 49 {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون}
قوله تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" تقدم الكلام فيها، وأنها ناسخة للتخيير. قال ابن العربي: وهذه دعوى عريضة؛ فإن شروط النسخ أربعة: منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر، وهذا مجهول من هاتين الآيتين؛ فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى، وبقي الأمر على حاله.
قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحاس أن هذه الآية متأخرة في النزول؛ فتكون ناسخة إلا أن يقدر في الكلام "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" إن شئت؛ لأنه قد تقدم ذكر التخيير له، فآخر الكلام حذف التخيير منه لدلالة الأول عليه؛ لأنه معطوف عليه، فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه، فهما شريكان وليس الآخر بمنقطع مما قبله؛ إذ لا معنى لذلك ولا يصح، فلا بد من أن يكون قوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" معطوفا على ما قبله من قوله: "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" ومن قوله: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" فمعنى "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" أي احكم بذلك إن حكمت واخترت الحكم؛ فهو كله محكم غير منسوخ، لأن الناسخ لا يكون مرتبطا بالمنسوخ معطوفا عليه، فالتخيير للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك محكم غير منسوخ، قاله مكي رحمه اله. "وأن احكم" في موضع نصب عطفا على الكتاب؛ أي وأنزلنا إليك أن احكم بينهم بما أنزل اله، أي بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه. "واحذرهم أن يفتنوك" "أن" بدل من الهاء والميم في "واحذرهم" وهو بدل اشتمال. أو مفعول من أجله؛ أي من أجل أن يفتنوك. وعن ابن إسحاق قال ابن عباس: اجتمع قوم من الأحبار منهم ابن صوريا وكعب بن أسد وابن صلوبا وشأس بن عدي وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر؛ فأتوه فقالوا: قد عرفت يا محمد أنا أحبار اليهود، وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود، وإن بيننا وبين قوم خصومة فتحاكمهم إليك، فأقض لنا عليهم حتى نؤمن بك؛ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وأصل الفتنة الاختبار حسبما تقدم، ثم يختلف معناها؛ فقوله تعالى هنا "يفتنوك" معناه يصدوك ويردوك؛ وتكون الفتنة بمعنى الشرك؛ ومنه قوله: "والفتنة" بمعنى العبرة؛ وقوله: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" [الأنفال: 39]. وتكون الفتنة بمعنى العبرة؛ كقوله: "لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين" [يونس: 85]. و"لا تجعلنا فتنة للذين كفروا" [الممتحنة: 5] ، وتكون الفتنة الصد عن السبيل كما في هذه الآية. وتكرير "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" للتأكيد، أو هي أحوال وأحكام أمره أن يحكم في كل واحد بما أنزل الله. وفي الآية دليل على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: "أن يفتنوك" وإنما يكون ذلك عن نسيان لا عن تعمد. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. وسيأتي بيان هذا في "الأنعام" إن شاء الله تعالى. ومعنى "عن بعض ما أنزل الله إليك" عن كل ما أنزل الله إليك. والبعض يستعمل بمعنى الكل قال الشاعر:
أو يعتبط بعض النفوس حمامها
ويروى "أو يرتبط". أراد كل النفوس؛ وعليه حملوا قوله تعالى: "ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه" [الزخرف: 63]. قال ابن العربي: والصحيح أن "بعض" على حالها في هذه الآية، وأن المراد به الرجم أو الحكم الذي كانوا أرادوه ولم يقصدوا أن يفتنوه عن الكل. والله أعلم.
قوله تعالى: "فإن تولوا" أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه "فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم" أي يعذبهم بالجلاء والجزية والقتل، وكذلك كان. وإنما قال: "ببعض" لأن المجازاة بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم. "وإن كثيرا من الناس لفاسقون" يعني اليهود.
الآية: 50 {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}
قوله تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون" "أفحكم" نصب بـ "يبغون" والمعنى: أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقم في غير موضع، وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراء، ولا يقيمونها على الأقوياء الأغنياء؛ فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل.
روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية "أفحكم الجاهلية يبغون" فكان طاوس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ؛ وبه قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثله، وكرهه الثوري وابن المبارك وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد، وأجاز ذلك مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي؛ واستدلوا بفعل الصديق في نحله عائشة دون سائر ولده، وبقول عليه السلام: (فارجعه) وقوله: (فأشهد على هذا غيري). واحتج الأولون بقوله عليه السلام لبشير: (ألك ولد سوى هذا) قال نعم، فقال: (أكلهم وهبت له مثل هذا) فقال لا، قال: (فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور) في رواية (وإني لا أشهد إلا على حق). قالوا: وما كان جورا وغير حق فهو باطل لا يجوز. وقول: (أشهد على هذا غيري) ليس إذنا في الشهادة وإنما هو زجر عنها؛ لأنه عليه السلام قد سماه جورا وامتنع من الشهادة فيه؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه. وأما فعل أبي بكر فلا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قد كاه نحل أولاده نحلا يعادل ذلك.
فإن قيل: الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقا، قيل له: الأصل الكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل لا تعارض بينهما كالعموم والخصوص. وفي الأصول أن الصحيح بناء العام على الخاص، ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائر، وذلك محمد، وما يؤدي إلى المحرم فهو ممنوع؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، والصدقة لا يعتصرها الأب بالإنفاق وقوله: (فارجعه) محمول على معنى فاردده، والرد ظاهر في الفسخ؛ كما قال عليه السلام (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود مفسوخ. وهذا كله ظاهر قوي، وترجيح جلي في المنع.
قرأ ابن وثاب والنخعي "أفحكم" بالرفع على معنى يبغونه؛ فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله:
قد أصبحت أم الخيار تدعي على ذنبا كله لم أصنع
فيمن روى "كله" بالرفع. ويجوز أن يكون التقدير: أفحكم الجاهلية حكم يبغونه، فحذف الموصوف. وقرأ الحسن وقتادة والأعرج والأعمش "أفحكم" بنصب الحاء والكاف وفتح الميم؛ وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة إذ ليس المراد نفس الحكم، وإنما المراد الحكم؛ فكأنه قال: أفحكم حكم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحكم والحاكم في اللغة واحدا وكأنهم يريدون الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية؛ فيكون المراد بالحكم الشيوع والجنس، إذ لا يراد به حاكم بعينه؛ وجاز وقوع المضاف جنسا كما جاز في قولهم: منعت مصر إردبها، وشبهه. وقرأ ابن عامر "تبغون" بالتاء، الباقون بالياء.
قوله تعالى: "ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" هذا استفهام على جهة الإنكار بمعنى: لا أحد أحسن؛ فهذا ابتداء وخبر. و"حكما" نصب على البيان. لقوله "لقوم يوقنون" أي عند قوم يوقنون.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 116
116- تفسير الصفحة رقم116 من المصحفالآيتان: 46 - 47 {وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}
قوله تعالى: "وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم" أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم، أي آثار النبيين الذين أسلموا. "مصدقا لما بين يديه" يعني التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقا، ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأتي ناسخ. "مصدقا" نصب على الحال من عيسى. "فيه هدى" في موضع رفع بالابتداء. "ونور" عطف عليه. "ومصدقا" فيه وجهان؛ يجوز أن يكون لعيسى وتعطفه على مصدقا الأول، ويجوز أن يكون حالا من الإنجيل، ويكون التقدير: وأتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور ومصدقا "وهدى وموعظة" عطف على "مصدقا" أي هاديا وواعظا "للمتقين" وخصهم لأنهم المنتفعون بهما. ويجوز رفعهما على العطف على قوله: "فيه هدى ونور".
قوله تعالى: "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه" قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي. والباقون بالجزم على الأمر؛ فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله: "وآتيناه" فلا يجوز الوقف؛ أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: "وأن احكم بينهم" [المائدة: 49] فهو إلزام مستأنف يبتدأ به، أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت، فأما الآن فهو منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. قال مكي: والاختيار الجزم؛ لأن الجماعة عليه؛ ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل. قال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عز وجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه، وأمر بالعمل بما فيه؛ فصحتا جميعا.
الآية: 48 {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون}
قوله تعالى: "وأنزلنا إليك الكتاب" الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم "الكتاب" القرآن "بالحق" أي هو بالأمر الحق "مصدقا" حال. "لما بين يديه من الكتاب" أي من جنس الكتب. "ومهيمنا عليه" أي عاليا عليه ومرتفعا. وهذا يدل على تأويل من يقول بالتفضيل أي في كثرة الثواب، على ما تقدمت إليه الإشارة في "الفاتحة" وهو اختيار ابن الحصار في كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرج الأسماء الحسنى والحمد لله. وقال قتادة: المهيمن معناه المشاهد. وقيل: الحافظ. وقال الحسن: المصدق؛ ومنه قول الشاعر:
إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذوو الألباب
وقال ابن عباس: "ومهيمنا عليه" أي مؤتمنا عليه. قال سعيد بن جبير: القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب، وعن ابن عباس والحسن أيضا: المهيمن الأمين. قال المبرد: أصله مؤتمن أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في أرقت الماء هرقت، وقاله الزجاج أيضا وأبو علي. وقد صرف فقيل: هيمن يهيمن هيمنة، وهو مهيمن بمعنى كان أمينا. الجوهري: هو من آمن غيره من الخوف؛ وأصله أأمن فهو مؤامن بهمزتين، قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مؤتمن، ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا: هراق الماء وأراقه؛ يقال منه: هيمن على الشيء يهيمن إذا كان له حافظا، فهو مهيمن؛ عن أبى عبيد. وقرأ مجاهد وابن محيصن: "ومهينا عليه" بفتح الميم. قال مجاهد: أي محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمن على القرآن.
قوله تعالى: "فاحكم بينهم بما أنزل الله" يوجب الحكم؛ فقيل: هذا نسخ للتخيير في قوله: "فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" وقيل: ليس هذا وجوبا، والمعنى: فاحكم بينهم إن شئت؛ إذ لا يجب عليا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذمة. وفي أهل الذمة تردد وقد مضى الكلام فيه. وقيل: أراد فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجبا عليه.
قوله تعالى: "ولا تتبع أهواءهم" يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على ما جاءك من الحق؛ يعني لا تترك الحكم بما بين الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام. والأهواء جمع هوى؛ ولا يجمع أهوية؛ وقد تقدم في "البقرة". فنهاه عن أن يتبعهم فيما يريدونه؛ وهو يدل على بطلان قول من قال: تقوم الخمر على من أتلفها عليهم؛ لأنها ليست مالا لهم فتكون مضمونة على متلفها؛ لأن إيجاب ضمانها على متلفها حكم بموجب أهواء اليهود؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك. ومعنى "عما جاءك" على ما جاءك. "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" يدل على عدم التعلق بشرائع الأولين. والشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. والشريعة في اللغة: الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء. والشريعة ما شرع الله لعباده من الدين؛ وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سن. والشارع الطريق الأعظم. والشرعة أيضا الوتر، والجمع شرع وشرع وشراع جمع الجمع؛ عن أبي عبيد؛ فهو مشترك. والمنهاج الطريق المستمر، وهو النهج والمنهج، أي البين؛ قال الراجز:
من يك ذا شك فهذا فلج ماء رواء وطريق نهج
وقال أبو العباس محمد بن يزيد: الشريعة ابتداء الطريق؛ المنهاج الطريق المستمر. وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما "شرعة ومنهاجا" سنة وسبيلا. ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها؛ والإنجيل لأهله؛ والقرآن لأهله؛ وهذا في الشرائع والعبادات؛ والأصل التوحيد لا اختلاف فيه؛ روي معنى ذلك عن قتادة. وقال مجاهد: الشرعة والمنهاج دين محمد عليه السلام؛ وقد نسخ به كل ما سواه.
قوله تعالى: "ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" أي لجعل شريعتكم واحدة فكنتم على الحق؛ فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم. "ولكن ليبلوكم في ما آتاكم" في الكلام حذف تتعلق به لام كي؛ أي ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم؛ والابتلاء الاختبار.
قوله تعالى: "فاستبقوا الخيرات" أي سارعوا إلى الطاعات؛ وهذا يدل على أن تقديمه الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها إلا في الصلاة في أول الوقت؛ فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها، وعموم الآية دليل عليه؛ قال الكيا. وفيه دليل على أن الصوم في السفر أولى من الفطر، وقد تقدم جميع هذا في "البقرة" "إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون" أي بما اختلفتم فيه، وتزول الشكوك.
الآية: 49 {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون}
قوله تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" تقدم الكلام فيها، وأنها ناسخة للتخيير. قال ابن العربي: وهذه دعوى عريضة؛ فإن شروط النسخ أربعة: منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر، وهذا مجهول من هاتين الآيتين؛ فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى، وبقي الأمر على حاله.
قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحاس أن هذه الآية متأخرة في النزول؛ فتكون ناسخة إلا أن يقدر في الكلام "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" إن شئت؛ لأنه قد تقدم ذكر التخيير له، فآخر الكلام حذف التخيير منه لدلالة الأول عليه؛ لأنه معطوف عليه، فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه، فهما شريكان وليس الآخر بمنقطع مما قبله؛ إذ لا معنى لذلك ولا يصح، فلا بد من أن يكون قوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" معطوفا على ما قبله من قوله: "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" ومن قوله: "فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" فمعنى "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" أي احكم بذلك إن حكمت واخترت الحكم؛ فهو كله محكم غير منسوخ، لأن الناسخ لا يكون مرتبطا بالمنسوخ معطوفا عليه، فالتخيير للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك محكم غير منسوخ، قاله مكي رحمه اله. "وأن احكم" في موضع نصب عطفا على الكتاب؛ أي وأنزلنا إليك أن احكم بينهم بما أنزل اله، أي بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه. "واحذرهم أن يفتنوك" "أن" بدل من الهاء والميم في "واحذرهم" وهو بدل اشتمال. أو مفعول من أجله؛ أي من أجل أن يفتنوك. وعن ابن إسحاق قال ابن عباس: اجتمع قوم من الأحبار منهم ابن صوريا وكعب بن أسد وابن صلوبا وشأس بن عدي وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر؛ فأتوه فقالوا: قد عرفت يا محمد أنا أحبار اليهود، وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود، وإن بيننا وبين قوم خصومة فتحاكمهم إليك، فأقض لنا عليهم حتى نؤمن بك؛ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وأصل الفتنة الاختبار حسبما تقدم، ثم يختلف معناها؛ فقوله تعالى هنا "يفتنوك" معناه يصدوك ويردوك؛ وتكون الفتنة بمعنى الشرك؛ ومنه قوله: "والفتنة" بمعنى العبرة؛ وقوله: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" [الأنفال: 39]. وتكون الفتنة بمعنى العبرة؛ كقوله: "لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين" [يونس: 85]. و"لا تجعلنا فتنة للذين كفروا" [الممتحنة: 5] ، وتكون الفتنة الصد عن السبيل كما في هذه الآية. وتكرير "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" للتأكيد، أو هي أحوال وأحكام أمره أن يحكم في كل واحد بما أنزل الله. وفي الآية دليل على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: "أن يفتنوك" وإنما يكون ذلك عن نسيان لا عن تعمد. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. وسيأتي بيان هذا في "الأنعام" إن شاء الله تعالى. ومعنى "عن بعض ما أنزل الله إليك" عن كل ما أنزل الله إليك. والبعض يستعمل بمعنى الكل قال الشاعر:
أو يعتبط بعض النفوس حمامها
ويروى "أو يرتبط". أراد كل النفوس؛ وعليه حملوا قوله تعالى: "ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه" [الزخرف: 63]. قال ابن العربي: والصحيح أن "بعض" على حالها في هذه الآية، وأن المراد به الرجم أو الحكم الذي كانوا أرادوه ولم يقصدوا أن يفتنوه عن الكل. والله أعلم.
قوله تعالى: "فإن تولوا" أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه "فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم" أي يعذبهم بالجلاء والجزية والقتل، وكذلك كان. وإنما قال: "ببعض" لأن المجازاة بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم. "وإن كثيرا من الناس لفاسقون" يعني اليهود.
الآية: 50 {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}
قوله تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون" "أفحكم" نصب بـ "يبغون" والمعنى: أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقم في غير موضع، وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراء، ولا يقيمونها على الأقوياء الأغنياء؛ فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل.
روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية "أفحكم الجاهلية يبغون" فكان طاوس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ؛ وبه قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثله، وكرهه الثوري وابن المبارك وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد، وأجاز ذلك مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي؛ واستدلوا بفعل الصديق في نحله عائشة دون سائر ولده، وبقول عليه السلام: (فارجعه) وقوله: (فأشهد على هذا غيري). واحتج الأولون بقوله عليه السلام لبشير: (ألك ولد سوى هذا) قال نعم، فقال: (أكلهم وهبت له مثل هذا) فقال لا، قال: (فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور) في رواية (وإني لا أشهد إلا على حق). قالوا: وما كان جورا وغير حق فهو باطل لا يجوز. وقول: (أشهد على هذا غيري) ليس إذنا في الشهادة وإنما هو زجر عنها؛ لأنه عليه السلام قد سماه جورا وامتنع من الشهادة فيه؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه. وأما فعل أبي بكر فلا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قد كاه نحل أولاده نحلا يعادل ذلك.
فإن قيل: الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقا، قيل له: الأصل الكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل لا تعارض بينهما كالعموم والخصوص. وفي الأصول أن الصحيح بناء العام على الخاص، ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائر، وذلك محمد، وما يؤدي إلى المحرم فهو ممنوع؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، والصدقة لا يعتصرها الأب بالإنفاق وقوله: (فارجعه) محمول على معنى فاردده، والرد ظاهر في الفسخ؛ كما قال عليه السلام (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود مفسوخ. وهذا كله ظاهر قوي، وترجيح جلي في المنع.
قرأ ابن وثاب والنخعي "أفحكم" بالرفع على معنى يبغونه؛ فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله:
قد أصبحت أم الخيار تدعي على ذنبا كله لم أصنع
فيمن روى "كله" بالرفع. ويجوز أن يكون التقدير: أفحكم الجاهلية حكم يبغونه، فحذف الموصوف. وقرأ الحسن وقتادة والأعرج والأعمش "أفحكم" بنصب الحاء والكاف وفتح الميم؛ وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة إذ ليس المراد نفس الحكم، وإنما المراد الحكم؛ فكأنه قال: أفحكم حكم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحكم والحاكم في اللغة واحدا وكأنهم يريدون الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية؛ فيكون المراد بالحكم الشيوع والجنس، إذ لا يراد به حاكم بعينه؛ وجاز وقوع المضاف جنسا كما جاز في قولهم: منعت مصر إردبها، وشبهه. وقرأ ابن عامر "تبغون" بالتاء، الباقون بالياء.
قوله تعالى: "ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" هذا استفهام على جهة الإنكار بمعنى: لا أحد أحسن؛ فهذا ابتداء وخبر. و"حكما" نصب على البيان. لقوله "لقوم يوقنون" أي عند قوم يوقنون.










الصفحة رقم 116 من المصحف تحميل و استماع mp3