سورة إبراهيم | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
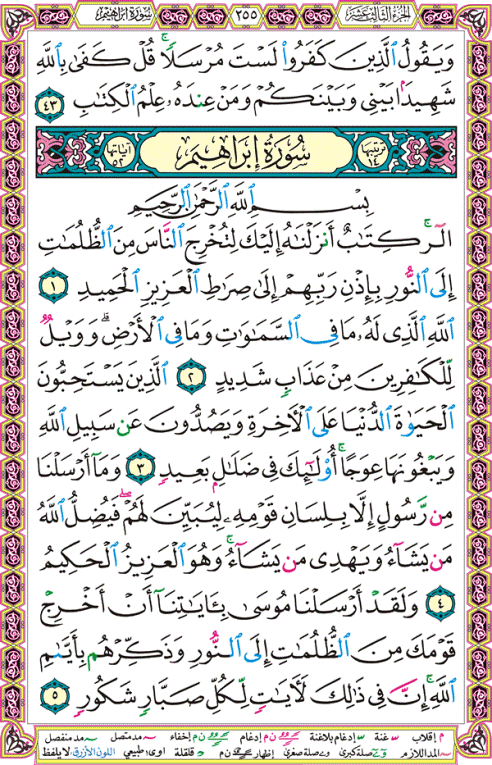
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 255 من المصحف
الآية: 43 {ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب}
قوله تعالى: "ويقول الذين كفروا لست مرسلا" قال قتادة: هم مشركو العرب؛ أي لست بنبي ولا رسول، وإنما أنت متقول؛ أي لما لم يأتهم بما اقترحوا قالوا ذلك. "قل كفى بالله" أي قل لهم يا محمد: "كفى بالله شهيدا بيني وبينكم" بصدقي وكذبكم. "ومن عنده علم الكتاب" وهذا إحجاج على مشركي العرب لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب - من آمن منهم - في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة لقول الخصوم؛ وهم مؤمنو أهل الكتاب كعبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري والنجاشي وأصحابه، قاله قتادة وسعيد بن جبير. وروى الترمذي عن ابن أخي عبدالله بن سلام قال: لما أريد قتل عثمان جاء عبدالله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك؛ قال: أخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لي من داخل؛ قال فخرج عبدالله بن سلام إلى الناس فقال: أيها الناس! إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله، ونزلت في آيات من كتاب الله؛ فنزلت في. "وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" [الأحقاف: 10] ونزلت في. "قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب" الحديث. وقد كتبناه بكماله في كتاب "التذكرة". وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وكان اسمه الجاهلية حصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله. وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير "ومن عنده علم الكتاب"؟ قال: هو عبدالله بن سلام.
قلت: وكيف يكون عبدالله بن سلام وهذه السورة مكية وابن سلام ما أسلم إلا بالمدينة؟! ذكره الثعلبي. وقال القشيري: وقال ابن جبير السورة مكية وابن سلام أسلم بالمدينة بعد هذه السورة؛ فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سلام؛ فمن عنده علم الكتاب جبريل؛ وهو قول ابن عباس. وقال الحسن ومجاهد والضحاك: هو الله تعالى؛ وكانوا يقرؤون "ومن عنده علم الكتاب" وينكرون على من يقول: هو عبدالله بن سلام وسلمان؛ لأنهم يرون أن السورة مكية، وهؤلاء أسلموا بالمدينة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ "ومن عنده علم الكتاب" وإن كان في الرواية ضعف، وروى ذلك سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وروى محبوب عن إسماعيل بن محمد اليماني أنه قرأ كذلك - "ومِن عنده" بكسر الميم والعين والدال "علم الكتاب" بضم العين ورفع الكتاب. وقال عبدالله بن عطاء: قلت، لأبي جعفر بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبدالله بن سلام فقال: إنما ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل: جميع المؤمنين، والله أعلم. قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما من قال إنه علي فعول على أحد وجهين: إما لأنه عنده أعلم المؤمنين وليس كذلك؛ بل أبو بكر وعمر وعثمان أعلم منه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. (أنا مدينة العلم وعلي بابها) وهو حديث باطل؛ النبي صلى الله عليه وسلم علم وأصحابه أبوابها؛ فمنهم الباب المنفسح، ومنهم المتوسط، على قدر منازلهم في العلوم. وأما من قال إنهم جميع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن يعلم الكتاب، ويدرك وجه إعجازه، ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقه.
قلت: فالكتاب على هذا هو القرآن. وأما من قال هو عبدالله بن سلام فعوَّل، على حديث الترمذي؛ وليس يمتنع أن ينزل في عبدالله بن سلام شيئا ويتناول جميع المؤمنين لفظا؛ ويعضده من النظام أن قوله تعالى: "ويقول الذين كفروا" يعني قريشا؛ فالذين عندهم علم الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى، الذين هم إلى معرفة النبوة والكتاب أقرب من عبدة الأوثان. قال النحاس: وقول من قال هو عبدالله بن سلام وغيره يحتمل أيضا؛ لأن البراهين إذا صحت وعرفها من قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن كان أمرا مؤكدا؛ والله أعلم بحقيقة ذلك.
سورة إبراهيم
مقدمة
سورة إبراهيم مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها مدنيتين وقيل: ثلاث، نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله وهي قوله تعالى: "ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا" [إبراهيم: 28] إلى قوله: "فإن مصيركم إلى النار" [إبراهيم: 30].
الآية: 1 {الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد}
قوله تعالى: "الر كتاب أنزلناه إليك" تقدم معناه. "لتخرج الناس" أي بالكتاب، وهو القرآن، أي بدعائك إليه. "من الظلمات إلى النور" أي من ظلمات الكفر الضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم؛ وهذا على التمثيل؛ لأن الكفر بمنزلة الظلمة؛ والإسلام بمنزلة النور. وقيل: من البدعة إلى السنة، ومن الشك إلى اليقين، والمعنى. متقارب. "بإذن ربهم" أي بتوفيقه إياهم ولطفه بهم، والباء في "بإذن ربهم" متعلقة بـ "تخرج" وأضيف الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الداعي والمنذر الهادي. "إلى صراط العزيز الحميد" هو كقولك: خرجت إلى زيد العاقل الفاضل من غير واو، لأنهما شيء واحد؛ والله هو العزيز الذي لا مثل له ولا شبيه. وقيل: "العزيز" الذي لا يغلبه غالب. وقيل: "العزيز" المنيع في ملكه وسلطانه. "الحميد" أي المحمود بكل لسان، والممجد في كل مكان على كل حال. وروى مقسم عن ابن عباس قال: كان قوم آمنوا بعيسى ابن مريم، وقوم كفروا به، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى، وكفر الذين آمنوا بعيسى؛ فنزلت هذه الآية، ذكره الماوردي.
الآية: 2 {الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد}
قوله تعالى: "الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض" أي ملكا وعبيدا واختراعا وخلقا. وقرأ نافع وابن عامر وغيرهما: "الله" بالرفع على الابتداء "الذي" خبره. وقيل: "الذي" صفة، والخبر مضمر؛ أي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض قادر على كل شيء. الباقون بالخفض نعتا للعزيز الحميد فقدم النعت على المنعوت؛ كقولك: مررت بالظريف زيد. وقيل: على البدل من "الحميد" وليس صفة؛ لأن اسم الله صار كالعلم فلا يوصف؛ كما لا يوصف بزيد وعمرو، بل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى؛ لأن معناه أنه المنفرد بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخير، مجازه: إلى صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وكان يعقوب إذا وقف على "الحميد" رفع، وإذا وصل خفض على النعت. قال ابن الأنباري: من خفض وقف على "وما في الأرض". "وويل للكافرين من عذاب شديد" قد تقدم معنى الويل في "البقرة" وقال الزجاج: هي كلمة تقال للعذاب والهلكة. "من عذاب شديد" أي من جهنم.
الآية: 3 {الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد}
قوله تعالى: "الذين يستحبون الحياة الدنيا" أي يختارونها على الآخرة، والكافرون يفعلون ذلك. فـ "الذين" في موضع خفض صفة لهم. وقيل: في موضع رفع خبر ابتداء مضمر، أي هم الذين وقيل: "الذين يستحبون" مبتدأ وخبره. "أولئك". وكل من آثر الدنيا وزهرتها، واستحب البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة، وصد عن سبيل الله - أي صرف الناس عنه وهو دين الله، الذي جاءت به الرسل، في قول ابن عباس وغيره - فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون) وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان، والله المستعان. وقيل: "يستحبون" أي يلتمسون الدنيا من غير وجهها، لأن نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته. "ويبغونها عوجا" أي يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم، وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تذكر وتؤنث. والموج بكسر العين في الدين والأمر والأرضي، وفي كل ما لم يكن قائما؛ وبفتح العين في كل ما كان قائما، كالحائط والرمح ونحوه؛ وقد تقدم في "آل عمران" وغيرها. "أولئك في ضلال بعيد" أي ذهاب عن الحق بعيد عنه.
الآية: 4 {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم}
قوله تعالى: "وما أرسلنا من رسول" أي قبلك يا محمد "إلا بلسان قومه" أي بلغتهم، ليبينوا لهم أمر دينهم؛ ووحد اللسان وإن أضافه إلى القوم لأن المراد اللغة؛ فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير؛ ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية؛ لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمته الحجة، وقد قال الله تعالى: "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا" [سبأ: 28]. وقال صلى الله عليه وسلم: (أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها وأرسلني الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه). وقال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار). خرجه مسلم، وقد تقدم. "فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء" رد على القدرية في نفوذ المشيئة، وهو مستأنف، وليس بمعطوف على "ليبين" لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للإضلال. ويجوز النصب في "يضل" لأن الإرسال صار سببا للإضلال؛ فيكون كقوله: "ليكون لهم عدوا وحزنا" [القصص: 8] وإنما صار الإرسال سببا للإضلال لأنهم كفروا به لما جاءهم؛ فصار كأنه سبب لكفرهم "وهو العزيز الحكيم" تقدم معناه.
الآية: 5 {ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور}
قوله تعالى: "ولقد أرسلنا موسى بآياتنا" أي بحجتنا وبراهيننا؛ أي بالمعجزات الدالة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآيات. "أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور" نظيره قوله تعالى: لنبينا عليه السلام أول السورة: "لتخرج الناس من الظلمات إلى النور": "أن" هنا بمعنى أي، كقوله تعالى: "وانطلق الملأ منهم أن امشوا" [ص: 6] أي امشوا.
قوله تعالى: "وذكرهم بأيام الله" أي قل لهم قولا يتذكرون به أيام الله تعالى. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: بنعم الله عليهم؛ وقاله أبي بن كعب ورواه مرفوعا؛ أي بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه إلى سائر النعم، وقد تسمى النعم الأيام؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم:
وأيام لنا غر طوال
وعن ابن عباس أيضا ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يقال: فلان عالم بأيام العرب، أي بوقائعها. قال ابن زيد: يعني الأيام التي انتقم فيها من الأمم الخالية؛ وكذلك روى ابن وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبري: وعظهم بما سلف في الأيام الماضية لهم، أي بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة؛ وقد كانوا عبيدا مستذلين؛ واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بينا موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله بلاؤه ونعماؤه) وذكر حديث الخضر؛ ودل هذا على جواز الوعظ المرفق للقلوب، المقوي لليقين. الخالي من كل بدعة، والمنزه عن كل ضلالة وشبهة. "إن في ذلك" أي في التذكير بأيام الله "لآيات" أي دلالات. "لكل صبار" أي كثير الصبر على طاعة الله، وعن معاصيه. "شكور" لنعم الله. وقال قتادة: هو العبد؛ إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. وروى عن النبي أنه قال: (الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر - ثم تلا هذه الآية - "إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور".) ونحوه عن الشعبي موقوفا. وتواري الحسن البصري عن الحجاج سبع سنين، فلما بلغه موته قال: اللهم قد أمته فأمت سنته، وسجد شكرا، وقرأ: "إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور". وإنما خص بالآيات كل صبار شكور؛ لأنه يعتبر بها ولا يغفل عنها؛ كما قال: "إنما أنت منذر من يخشاها" [النازعات: 45] وإن كان منذرا للجميع.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 255
255- تفسير الصفحة رقم255 من المصحفالآية: 43 {ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب}
قوله تعالى: "ويقول الذين كفروا لست مرسلا" قال قتادة: هم مشركو العرب؛ أي لست بنبي ولا رسول، وإنما أنت متقول؛ أي لما لم يأتهم بما اقترحوا قالوا ذلك. "قل كفى بالله" أي قل لهم يا محمد: "كفى بالله شهيدا بيني وبينكم" بصدقي وكذبكم. "ومن عنده علم الكتاب" وهذا إحجاج على مشركي العرب لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب - من آمن منهم - في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة لقول الخصوم؛ وهم مؤمنو أهل الكتاب كعبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري والنجاشي وأصحابه، قاله قتادة وسعيد بن جبير. وروى الترمذي عن ابن أخي عبدالله بن سلام قال: لما أريد قتل عثمان جاء عبدالله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك؛ قال: أخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لي من داخل؛ قال فخرج عبدالله بن سلام إلى الناس فقال: أيها الناس! إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله، ونزلت في آيات من كتاب الله؛ فنزلت في. "وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" [الأحقاف: 10] ونزلت في. "قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب" الحديث. وقد كتبناه بكماله في كتاب "التذكرة". وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وكان اسمه الجاهلية حصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله. وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير "ومن عنده علم الكتاب"؟ قال: هو عبدالله بن سلام.
قلت: وكيف يكون عبدالله بن سلام وهذه السورة مكية وابن سلام ما أسلم إلا بالمدينة؟! ذكره الثعلبي. وقال القشيري: وقال ابن جبير السورة مكية وابن سلام أسلم بالمدينة بعد هذه السورة؛ فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سلام؛ فمن عنده علم الكتاب جبريل؛ وهو قول ابن عباس. وقال الحسن ومجاهد والضحاك: هو الله تعالى؛ وكانوا يقرؤون "ومن عنده علم الكتاب" وينكرون على من يقول: هو عبدالله بن سلام وسلمان؛ لأنهم يرون أن السورة مكية، وهؤلاء أسلموا بالمدينة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ "ومن عنده علم الكتاب" وإن كان في الرواية ضعف، وروى ذلك سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وروى محبوب عن إسماعيل بن محمد اليماني أنه قرأ كذلك - "ومِن عنده" بكسر الميم والعين والدال "علم الكتاب" بضم العين ورفع الكتاب. وقال عبدالله بن عطاء: قلت، لأبي جعفر بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبدالله بن سلام فقال: إنما ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل: جميع المؤمنين، والله أعلم. قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما من قال إنه علي فعول على أحد وجهين: إما لأنه عنده أعلم المؤمنين وليس كذلك؛ بل أبو بكر وعمر وعثمان أعلم منه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. (أنا مدينة العلم وعلي بابها) وهو حديث باطل؛ النبي صلى الله عليه وسلم علم وأصحابه أبوابها؛ فمنهم الباب المنفسح، ومنهم المتوسط، على قدر منازلهم في العلوم. وأما من قال إنهم جميع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن يعلم الكتاب، ويدرك وجه إعجازه، ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقه.
قلت: فالكتاب على هذا هو القرآن. وأما من قال هو عبدالله بن سلام فعوَّل، على حديث الترمذي؛ وليس يمتنع أن ينزل في عبدالله بن سلام شيئا ويتناول جميع المؤمنين لفظا؛ ويعضده من النظام أن قوله تعالى: "ويقول الذين كفروا" يعني قريشا؛ فالذين عندهم علم الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى، الذين هم إلى معرفة النبوة والكتاب أقرب من عبدة الأوثان. قال النحاس: وقول من قال هو عبدالله بن سلام وغيره يحتمل أيضا؛ لأن البراهين إذا صحت وعرفها من قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن كان أمرا مؤكدا؛ والله أعلم بحقيقة ذلك.
سورة إبراهيم
مقدمة
سورة إبراهيم مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها مدنيتين وقيل: ثلاث، نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله وهي قوله تعالى: "ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا" [إبراهيم: 28] إلى قوله: "فإن مصيركم إلى النار" [إبراهيم: 30].
الآية: 1 {الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد}
قوله تعالى: "الر كتاب أنزلناه إليك" تقدم معناه. "لتخرج الناس" أي بالكتاب، وهو القرآن، أي بدعائك إليه. "من الظلمات إلى النور" أي من ظلمات الكفر الضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم؛ وهذا على التمثيل؛ لأن الكفر بمنزلة الظلمة؛ والإسلام بمنزلة النور. وقيل: من البدعة إلى السنة، ومن الشك إلى اليقين، والمعنى. متقارب. "بإذن ربهم" أي بتوفيقه إياهم ولطفه بهم، والباء في "بإذن ربهم" متعلقة بـ "تخرج" وأضيف الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الداعي والمنذر الهادي. "إلى صراط العزيز الحميد" هو كقولك: خرجت إلى زيد العاقل الفاضل من غير واو، لأنهما شيء واحد؛ والله هو العزيز الذي لا مثل له ولا شبيه. وقيل: "العزيز" الذي لا يغلبه غالب. وقيل: "العزيز" المنيع في ملكه وسلطانه. "الحميد" أي المحمود بكل لسان، والممجد في كل مكان على كل حال. وروى مقسم عن ابن عباس قال: كان قوم آمنوا بعيسى ابن مريم، وقوم كفروا به، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى، وكفر الذين آمنوا بعيسى؛ فنزلت هذه الآية، ذكره الماوردي.
الآية: 2 {الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد}
قوله تعالى: "الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض" أي ملكا وعبيدا واختراعا وخلقا. وقرأ نافع وابن عامر وغيرهما: "الله" بالرفع على الابتداء "الذي" خبره. وقيل: "الذي" صفة، والخبر مضمر؛ أي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض قادر على كل شيء. الباقون بالخفض نعتا للعزيز الحميد فقدم النعت على المنعوت؛ كقولك: مررت بالظريف زيد. وقيل: على البدل من "الحميد" وليس صفة؛ لأن اسم الله صار كالعلم فلا يوصف؛ كما لا يوصف بزيد وعمرو، بل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى؛ لأن معناه أنه المنفرد بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخير، مجازه: إلى صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وكان يعقوب إذا وقف على "الحميد" رفع، وإذا وصل خفض على النعت. قال ابن الأنباري: من خفض وقف على "وما في الأرض". "وويل للكافرين من عذاب شديد" قد تقدم معنى الويل في "البقرة" وقال الزجاج: هي كلمة تقال للعذاب والهلكة. "من عذاب شديد" أي من جهنم.
الآية: 3 {الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد}
قوله تعالى: "الذين يستحبون الحياة الدنيا" أي يختارونها على الآخرة، والكافرون يفعلون ذلك. فـ "الذين" في موضع خفض صفة لهم. وقيل: في موضع رفع خبر ابتداء مضمر، أي هم الذين وقيل: "الذين يستحبون" مبتدأ وخبره. "أولئك". وكل من آثر الدنيا وزهرتها، واستحب البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة، وصد عن سبيل الله - أي صرف الناس عنه وهو دين الله، الذي جاءت به الرسل، في قول ابن عباس وغيره - فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون) وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان، والله المستعان. وقيل: "يستحبون" أي يلتمسون الدنيا من غير وجهها، لأن نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته. "ويبغونها عوجا" أي يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم، وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تذكر وتؤنث. والموج بكسر العين في الدين والأمر والأرضي، وفي كل ما لم يكن قائما؛ وبفتح العين في كل ما كان قائما، كالحائط والرمح ونحوه؛ وقد تقدم في "آل عمران" وغيرها. "أولئك في ضلال بعيد" أي ذهاب عن الحق بعيد عنه.
الآية: 4 {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم}
قوله تعالى: "وما أرسلنا من رسول" أي قبلك يا محمد "إلا بلسان قومه" أي بلغتهم، ليبينوا لهم أمر دينهم؛ ووحد اللسان وإن أضافه إلى القوم لأن المراد اللغة؛ فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير؛ ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية؛ لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمته الحجة، وقد قال الله تعالى: "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا" [سبأ: 28]. وقال صلى الله عليه وسلم: (أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها وأرسلني الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه). وقال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار). خرجه مسلم، وقد تقدم. "فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء" رد على القدرية في نفوذ المشيئة، وهو مستأنف، وليس بمعطوف على "ليبين" لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للإضلال. ويجوز النصب في "يضل" لأن الإرسال صار سببا للإضلال؛ فيكون كقوله: "ليكون لهم عدوا وحزنا" [القصص: 8] وإنما صار الإرسال سببا للإضلال لأنهم كفروا به لما جاءهم؛ فصار كأنه سبب لكفرهم "وهو العزيز الحكيم" تقدم معناه.
الآية: 5 {ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور}
قوله تعالى: "ولقد أرسلنا موسى بآياتنا" أي بحجتنا وبراهيننا؛ أي بالمعجزات الدالة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآيات. "أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور" نظيره قوله تعالى: لنبينا عليه السلام أول السورة: "لتخرج الناس من الظلمات إلى النور": "أن" هنا بمعنى أي، كقوله تعالى: "وانطلق الملأ منهم أن امشوا" [ص: 6] أي امشوا.
قوله تعالى: "وذكرهم بأيام الله" أي قل لهم قولا يتذكرون به أيام الله تعالى. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: بنعم الله عليهم؛ وقاله أبي بن كعب ورواه مرفوعا؛ أي بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه إلى سائر النعم، وقد تسمى النعم الأيام؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم:
وأيام لنا غر طوال
وعن ابن عباس أيضا ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يقال: فلان عالم بأيام العرب، أي بوقائعها. قال ابن زيد: يعني الأيام التي انتقم فيها من الأمم الخالية؛ وكذلك روى ابن وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبري: وعظهم بما سلف في الأيام الماضية لهم، أي بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة؛ وقد كانوا عبيدا مستذلين؛ واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بينا موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله بلاؤه ونعماؤه) وذكر حديث الخضر؛ ودل هذا على جواز الوعظ المرفق للقلوب، المقوي لليقين. الخالي من كل بدعة، والمنزه عن كل ضلالة وشبهة. "إن في ذلك" أي في التذكير بأيام الله "لآيات" أي دلالات. "لكل صبار" أي كثير الصبر على طاعة الله، وعن معاصيه. "شكور" لنعم الله. وقال قتادة: هو العبد؛ إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. وروى عن النبي أنه قال: (الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر - ثم تلا هذه الآية - "إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور".) ونحوه عن الشعبي موقوفا. وتواري الحسن البصري عن الحجاج سبع سنين، فلما بلغه موته قال: اللهم قد أمته فأمت سنته، وسجد شكرا، وقرأ: "إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور". وإنما خص بالآيات كل صبار شكور؛ لأنه يعتبر بها ولا يغفل عنها؛ كما قال: "إنما أنت منذر من يخشاها" [النازعات: 45] وإن كان منذرا للجميع.










الصفحة رقم 255 من المصحف تحميل و استماع mp3