سورة القيامة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
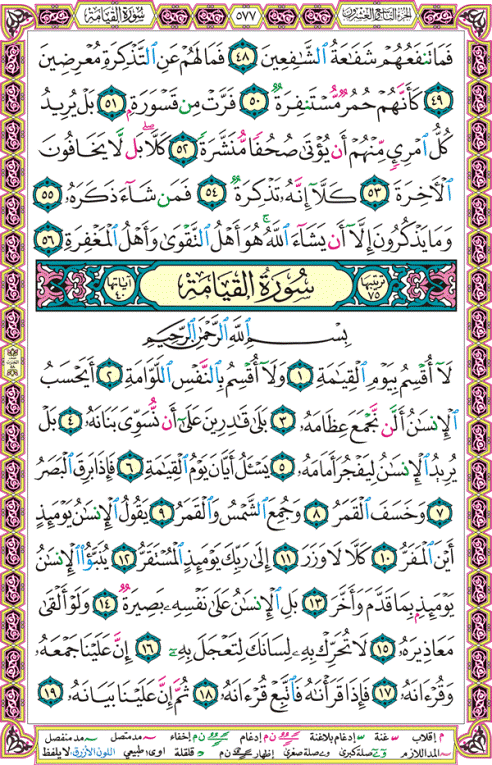
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 577 من المصحف
قوله تعالى: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين؛ وذلك أن قوما من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم، ثم شفع فيهم، فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة، فأخرجوا من النار، وليس للكفار شفيع يشفع فيهم.
وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: يشفع نبيكم صلى الله عليه وسلم رابع أربعة: جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى أو عيسى، ثم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ويبقى قوم في جهنم، فيقال لهم: "ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين" إلى قوله: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" قال عبدالله بن مسعود: فهؤلاء هم الذين يبقون في جهنم؛ وقد ذكرنا إسناده في كتاب (التذكرة).
الآية: 49 - 53 {فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة}
قوله تعالى: "فما لهم عن التذكرة معرضين" أي فما لأهل مكة أعرضوا وولوا عما جئتم به. وفي تفسير مقاتل: الإعراض عن القرآن من وجهين: أحدهما الجحود والإنكار، والوجه الآخر ترك العمل بما فيه. و"معرضين" نصب على الحال من الهاء والميم في "لهم" وفي اللام معنى الفعل؛ فانتصاب الحال على معنى الفعل. "كأنهم" أي كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد صلى الله عليه وسلم "حمر مستنفرة" قال ابن عباس: أراد الحمر الوحشية. وقرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء، أي منفرة مذعورة؛ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. الباقون بالكسر، أي نافرة. يقال. نفرت واستنفرت بمعنى؛ مثل عجبت واستعجبت، وسخرت واستسخرت، وأنشد الفراء:
أمسك حمارك إنه مستنفر في إثر أحمرة عمدن لغرب
قوله تعالى: "فرت" أي نفرت وهربت "من قسورة" أي من رماة يرمونها.
وقال بعض أهل اللغة: إن القسورة الرامي، وجمعه القسورة. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وابن كيسان: القسورة: هم الرماة والصيادون، ورواه عطاء عن ابن عباس وأبو [ظبيان] عن أبي موسى الأشعري. وقيل: إنه الأسد؛ قال أبو هريرة وابن عباس أيضا. ابن عرفة: من العسر بمعنى القهر أي؛ إنه يقهر السباع، والحمر الوحشية تهرب من السباع. وروى أبو جمرة عن ابن عباس قال: ما أعلم القسورة الأسد في لغة أحد من العرب، ولكنها عصب الرجال؛ قال: فالقسورة جمع الرجال، وأنشد:
يا بنت كوني خيرة لخيرة أخوالها الجن وأهل القسورة
وعنه: ركز الناس أي حسهم وأصواتهم. وعنه أيضا: "فرت من قسورة" أي من حبال الصيادين. وعنه أيضا: القسورة بلسان العرب: الأسد، وبلسان الحبشة: الرماة؛ وبلسان فارس: شير، وبلسان النبط: أريا. وقال ابن الأعرابي: القسورة: أول الليل؛ أي فرت من ظلمة الليل. وقاله عكرمة أيضا. وقيل: هو أول سواد الليل، ولا يقال لآخر سواد الليل قسورة. وقال زيد بن أسلم: من رجال أقوياء، وكل شديد عند العرب فهو قسورة وقسور. وقال لبيد بن ربيعة:
إذا ما هتفنا هتفة في ندينا أتانا الرجال العائدون القساور
قوله تعالى: "بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة" أي يعطى كتبا مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بكتب من رب العالمين مكتوب فيها: إني قد أرسلت إليكم محمدا، صلى الله عليه وسلم. نظيره: "ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه" [الإسراء: 93]. وقال ابن عباس: كانوا يقولون إن كان محمد صادقا فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار. قال مطر الوراق: أرادوا أن يعطوا بغير عمل. وقال الكلبي: قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح عند رأسه مكتوبا ذنبه وكفارته، فأتنا بمثل ذلك. وقال مجاهد: أرادوا أن ينزل على كل واحد منهم كتاب فيه من الله عز وجل: إلى فلان بن فلان. وقيل: المعنى أن يذكر بذكر جميل، فجعلت الصحف موضع الذكر مجازا. وقالوا: إذا كانت ذنوب الإنسان تكتب عليه فما بالنا لا نرى ذلك؟ "كلا" أي ليس يكون ذلك. وقيل: حقا. والأول أجود؛ لأنه رد لقولهم. "بل لا يخافون الآخرة" أي لا أعطيهم ما يتمنون لأنهم لا يخافون الآخرة، اغترارا بالدنيا. وقرأ سعيد بن جبير "صحفا منشرة" بسكون الحاء والنون، فأما تسكين الحاء فتخفيف، وأما النون فشاذ. إنما يقال: نشرت الثوب وشبهه ولا يقال أنشرت. ويجوز أن يكون شبه الصحيفة بالميت كأنها ميتة بطيها، فإذا نشرت حييت، فجاء على أنشر الله الميت، كما شبه إحياء الميت بنشر الثوب، فقيل فيه نشر الله الميت، فهي لغة فيه.
الآية: 54 - 56 {كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة}
قوله تعالى: "كلا إنه تذكرة" أي حقا إن القرآن عظة. "فمن شاء ذكره" أي اتعظ به. "وما يذكرون" أي وما يتعظون "إلا أن يشاء الله" أي ليس يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم. وقراءة العامة "يذكرون" بالياء واختاره أبو عبيد؛ لقوله تعالى: "كلا بل لا يخافون الآخرة". وقرأ نافع ويعقوب بالتاء، واختاره أبو حاتم، لأنه أعم واتفقوا على تخفيفها. "هو أهل التقوى وأهل المغفرة" في الترمذي وسنن ابن ماجة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: "هو أهل التقوى وأهل المغفرة" قال: [قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له] لفظ الترمذي، وقال فيه: حديث حسن غريب. وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبار، وأهل المغفرة أيضا للذنوب الصغار، باجتناب الذنوب الكبار.
وقال محمد بن نصر: أنا أهل أن يتقيني عبدي، فإن لم يفعل كنت أهلا أن أغفر له [وأرحمه، وأنا الغفور الرحيم].
سورة القيامة
الآية: 1 - 6 {لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة}
قوله تعالى: "لا أقسم بيوم القيامة" قيل: إن "لا" صلة، وجاز وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض، فهو في حكم كلام واحد؛ ولهذا قد يذكر الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى؛ كقوله تعالى: "وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون" [الحجر: 6]. وجوابه في سورة أخرى: "ما أنت بنعمة ربك بمجنون" [القلم: 2]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة؛ قال ابن عباس وابن جبير وأبو عبيدة؛ ومثله قول الشاعر:
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة فكاد صميم القلب لا يتقطع
وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى "لا أقسم": أقسم. واختلفوا في تفسير: "لا" قال بعضهم: "لا" زيادة في الكلام للزينة، ويجري في كلام العرب زيادة (لا) كما قال في آية أخرى: "قال ما منعك أن تسجد" [ص: 75]. يعني أن تسجد، وقال بعضهم: "لا": رد لكلامهم حيث أنكروا البعث، فقال: ليس الأمر كما زعمتم.
قلت: وهذا قول الفراء؛ قال الفراء: وكثير من النحويين يقولون "لا" صلة، ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه، ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار، فجاء الإقسام بالرد عليهم (في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدأ) وذلك كقولهم لا والله لا أفعل "فلا" رد لكلام قد مضى، وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحق، كأنك أكذبت قوما أنكروه. وأنشد غير الفراء لامرئ القيس:
فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر
وقال غوية بن سلمى:
ألا نادت أمامة باحتمال لتحزنني فلا بك ما أبالي
وفائدتها توكيد القسم في الرد. قال الفراء: وكان من لا يعرف هذه الجهة يقرأ "لأقسم" بغير ألف؛ كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم، وهو صواب؛ لأن العرب تقول: لأقسم بالله وهي قراءة الحسن وابن كثير والزهري وابن هرمز "بيوم القيامة" أي بيوم يقوم الناس فيه لربهم، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء. "ولا أقسم بالنفس اللوامة" لا خلاف في هذا بين القراء، وهو أنه أقسم سبحانه بيوم القيامة تعظيما لشأنه (ولم يقسم بالنفس). وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية.
وقيل: "ولا أقسم بالنفس اللوامة" رد آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة. قال الثعلبي: والصحيح أنه أقسم بهما جميعا. ومعنى: "بالنفس اللوامة" أي بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه؛ قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن، ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلامى؟ ما أردت بأكلي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لم فعلته، وعلى الخير لم لا تستكثر منه. وقيل: إنها ذات اللوم.
وقيل: إنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللوامة بمعنى اللائمة، وهو صفة مدح؛ وعلى هذا يجيء القسم بها سائغا حسنا. وفي بعض التفسير: إنه آدم عليه السلام لم يزل لائما لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة. وقيل: اللوامة بمعنى الملومة المذمومة عن ابن عباس أيضا - فهي صفة ذم وهو قول من نفى أن يكون قسما؛ إذ ليس للعاصي خطر يقسم به، فهي كثيرة اللوم. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه، ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله. وقال الفراء: ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسانا، والمسيء يلوم نفسه ألا يكون ارعوى عن إساءته.
قوله تعالى: "أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه" فنعيدها خلقا جديدا بعد أن صارت رفاتا. قال الزجاج: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة: ليجمعن العظام للبعث، فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم محذوف أي لتبعثن؛ ودل عليه قوله تعالى: "أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه" للإحياء والبعث. والإنسان هنا الكافر المكذب للبعث. الآية نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عن يوم القيامة متى تكون، وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أأمن به، أو يجمع الله العظام؟ ! ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم اكفني جاري السوء عدي بن ربيعة، والأخنس بن شريق). وقيل: نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت. وذكر العظام والمراد نفسه كلها؛ لأن العظام قالب الخلق. "بلى" وقف حسن ثم تبتدئ "قادرين". قال سيبويه: على معنى نجمعها قادرين، "فقادرين" حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف على ما ذكرناه من التقدير. وقيل: المعنى بل نقدر قادرين. قال الفراء: "قادرين" نصب على الخروج من "نجمع" أي نقدر ونقوى "قادرين" على أكثر من ذلك. وقال أيضا: يصلح نصبه على التكرير أي "بلى" فليحسبنا قادرين. وقيل: المضمر (كنا) أي كنا قادرين في الابتداء، وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميقع "بلى قادرون" بتأويل نحن قادرون. "على أن نسوي بنانه" البنان عند العرب: الأصابع، واحدها بنانة؛ قال النابغة:
بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد
وقال عنترة:
وأن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندواني
فنبه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضا فإنها أصغر العظام، فخصها بالذكر لذلك.
قال القتبي والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام؛ فقال الله تعالى: بلى قادرين على أن نعيد السلاميات على صغرها، ونؤلف بينها حتى تستوي، ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر. وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى "على أن نسوي بنانه" أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخف البعير، أو كحافر الحمار، أو كظلف الخنزير، ولا يمكنه أن يعمل به شيئا، ولكنا فرقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء. وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تبسطهن، وتقبضهن بهن، ولو شاء الله لجمعهن فلم تتق الأرض إلا بكفيك. وقيل: أي نقدر أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم، فكيف في صورته التي كان عليها؛ وهو كقوله تعالى: "وما نحن بمسبوقين. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون" [الواقعة:61 ].
قلت: والتأويل الأول أشبه بمساق الآية. والله أعلم.
قوله تعالى: "بل يريد الإنسان ليفجر أمامه" قال ابن عباس: يعني الكافر يكذب بما أمامه من البعث والحساب. وقال عبدالرحمن بن زيد؛ ودليله: "يسأل أيان يوم القيامة" أي يسأل متى يكون! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه من التكذيب، ولكن يأثم لما بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره القتبي وغيره: أن أعرابيا قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكا إليه نقب إبله ودبرها، وسأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله؛ فقال الأعرابي:
أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر
فاغفر له اللهم إن كان فجر
يعني إن كان كذبني فيما ذكرت. وعن ابن عباس أيضا: يعجل المعصية ويسوف التوبة. وفي بعض الحديث قال: يقول سوف أتوب ولا يتوب؛ فهو قد أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدي وسعيد بن جبير، يقول: سوف أتوب، سوف أتوب، حتى يأتيه الموت على أشر أحواله. وقال الضحاك: هو الأمل يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت. وقيل: أي يعزم على المعصية أبدا وإن كان لا يعيش إلا مدة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. وقيل: الهاء ليوم القيامة. والمعنى بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة. والفجور أصله الميل عن الحق. "يسأل أيان يوم القيامة" أي متى يوم القيامة.
الآية: 7 - 13 {فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر}
قوله تعالى: "فإذا برق البصر" قرأ نافع وأبان عن عاصم "برق" بفتح الراء، معناه: لمع بصره من شدة شخوصه، فتراه لا يطرف. قال مجاهد وغيره: هذا عند الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامة. وقال فيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة "إذا برق البصر. وخسف القمر" والباقون بالكسر "برق" ومعناه: تحير فلم يطرف؛ قاله أبو عمرو والزجاج وغيرهما. قال ذو الرمة:
ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافرا كاد يبرق
الفراء والخليل: "برق" بالكسر: فزع وبهت وتحير. والعرب تقول للإنسان المتحير المبهوت: قد برق فهو برق؛ وأنشد الفراء:
فنفسك فانع ولا تنعني وداو الكلوم ولا تبرق
أي لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك. وقيل: برق يبرق بالفتح: شق عينيه وفتحهما. قاله أبو عبيدة؛ وأنشد قول الكلابي:
لما أتاني ابن عمير راغبا أعطيته عيشا صهابا فبرق
أي فتح عينيه. وقيل: إن كسر الراء وفتحها لغتان بمعنى.
قوله تعالى: "وخسف القمر" أي ذهب ضوئه. والخسوف في الدنيا إلى انجلاء، بخلاف الآخرة، فإنه لا يعود ضوئه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه قوله تعالى: "فخسفنا به وبداره الأرض" [القصص: 81]. وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعرج: "وخسف القمر" بضم الخاء وكسر السين يدل عليه "وجمع الشمس والقمر". وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا ذهب بعضه فهو الكسوف، وإذا ذهب كله فهو الخسوف. "وجمع الشمس والقمر" أي جمع بينهما في ذهاب ضوئهما، فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه؛ قاله الفراء والزجاج.
قال الفراء: ولم يقل جمعت؛ لأن المعنى جمع بينهما. وقال أبو عبيدة: هو على تغليب المذكر. وقال الكسائي: هو محمول على المعنى، كأنه قال الضوءان. المبرد: التأنيث غير حقيقي. وقال ابن عباس وابن مسعود: جمع بينهما أي قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين كأنهما ثوران عقيران. وقد مضى الحديث بهذا المعنى في آخر سورة "الأنعام". وفي قراءة عبدالله "وجمع بين الشمس والقمر" وقال عطاء بن يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر، فيكونان نار الله الكبرى. وقال علي وابن عباس: يجعلان في (نور) الحجب. وقد يجمعان في نار جهنم؛ لأنهما قد عبدا من دون الله ولا تكون النار عذابا لهما لأنهما جماد، وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم. وفي مسند أبي داود الطيالسي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس ابن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار)
وقيل: هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان، ويقربان من الناس، فيلحقهم العرق لشدة الحر؛ فكأن المعنى يجمع حرهما عليهم. وقيل: يجمع الشمس والقمر، فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار.
قوله تعالى: "يقول الإنسان يومئذ أين المفر" أي يقول ابن آدم، ويقال: أبو جهل؛ أي أين المهرب؟ قال الشاعر:
أين المفر والكباش تنتطح وأي كبش حاد عنها يفتضح
الماوردي: ويحتمل وجهين: أحدهما "أين المفر" من الله استحياء منه. الثاني "أين المفر" من جهنم حذرا منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: أحدهما: أن يكون من الكافر خاصة في عرضة القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن ببشرى ربه. الثاني: أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما شاهدوا منها. وقراءة العامة "المفر" بفتح الفاء واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم؛ لأنه مصدر. وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع فتح الميم؛ قال الكسائي: هما لغتان مثل مدب ومدب، ومصح ومصح. وعن الزهري بكسر الميم وفتح الفاء. المهدوي: من فتح الميم والفاء من "المفر" فهو مصدر بمعنى الفرار، ومن فتح الميم وكسر الفاء فهو الموضع الذي يفر إليه. ومن كسر الميم وفتح الفاء فهو الإنسان الجيد الفرار؛ فالمعنى أين الإنسان الجيد الفرار ولن ينجو مع ذلك.
قلت: ومنه قول امرئ القيس:
مكر مفر مقبل مدبر معا
يريد أنه حسن الكر والفر جيده. "كلا" أي لا مفر "فكلا" رد وهو من قول الله تعالى.. ثم فسر هذا الرد فقال: "لا وزر" أي لا ملجأ من النار. وكان ابن مسعود يقول: لا حصن. وكان الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. وابن جبير: لا محيص ولا منعة. المعنى في ذلك كله واحد. والوزر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما؛ قال الشاعر:
لعمري ما للفتى من وزر من الموت يدركه والكبر
قال السدي: كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصنوا في الجبال، فقال الله لهم: لا وزر يعصمكم يومئذ مني؛ قال طرفة:
ولقد تعلم بكر أننا فاضلوا الرأي وفي الروع وزر
أي ملجأ للخائف. ويروى: وقر. "إلى ربك يومئذ المستقر" أي المنتهى؛ قال قتادة نظيره: "وأن إلى ربك المنتهى" [النجم: 42]. وقال ابن مسعود: إلى ربك المصير والمرجع. قيل: أي المستقر في الآخرة حيث يقره الله تعالى؛ إذ هو الحاكم بينهم.
وقيل: إن "كلا" من قول الإنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له مفر قال لنفسه: "كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر".
قوله تعالى: "ينبأ الإنسان" أي يخبر ابن آدم برا كان أو فاجرا "بما قدم وأخر": أي بما أسلف من عمل سيء أو صالح، أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يعمل بها بعده؛ قاله ابن عباس وابن مسعود. وروى منصور عن مجاهد قال: ينبأ بأول عمله وآخره. وقاله النخعي. وقال ابن عباس أيضا: أي بما قدم من المعصية، وأخر من الطاعة. وهو قول قتادة. وقال ابن زيد: "بما قدم" من أمواله لنفسه "وأخر": خلف للورثة. وقال الضحاك: ينبأ بما قدم من فرض، وأخر من فرض. قال القشيري: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون عند الموت.
قلت: والأول أظهر؛ لما خرجه ابن ماجة في سننه من حديث الزهري، حدثني أبو عبدالله الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته) وخرجه أبو نعيم الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته) فقوله: (بعد موته وهو في قبره) نص على أن ذلك لا يكون عند الموت، وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن عمله، وإن كان يبشر بذلك في قبره. ودل على هذا أيضا قوله الحق: "وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم" [العنكبوت: 13] وقوله تعالى: "ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم" [النحل: 25] وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم.
وفي الصحيح: (من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء).
الآية: 14 - 15 {بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره}
قوله تعالى: "بل الإنسان على نفسه بصيرة" قال الأخفش: جعله هو البصيرة، كما تقول للرجل أنت حجة على نفسك. وقال ابن عباس: "بصيرة" أي شاهد، وهو شهود جوارحه عليه: يداه بما بطش بهما، ورجلاه بما مشى عليهما، وعيناه بما أبصر بهما. والبصيرة: الشاهد. وأنشد الفراء:
كأن على ذي العقل عينا بصيرة بمقعده أو منظر هو ناظره
يحاذر حتى يحسب الناس كلهم من الخوف لا تخفى عليهم سرائره
ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى: "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون" [النور: 24]. وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارح، لأنها شاهدة على نفس الإنسان؛ فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة؛ قال معناه القتبي وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: "بصيرة" هي التي يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة، كالهاء في قولهم: داهية وعلامة وراوية. وهو قول أبي عبيد. وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير أو شر؛ يدل عليه قوله تعالى: "ولو ألقى معاذيره" فيمن جعل المعاذير الستور. وهو قول السدي والضحاك. وقال بعض أهل التفسير: المعنى بل على الإنسان من نفسه بصيرة؛ أي شاهد فحذف حرف الجر. ويجوز أن يكون "بصيرة" نعتا لاسم مؤنث فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه عين بصيرة؛ وأنشد الفراء:
كأن على ذي العقل عينا بصيرة
وقال الحسن في قوله تعالى: "بل الإنسان على نفسه بصيرة" يعني بصير بعيوب غيره، جاهل بعيوب نفسه. أي ولو أرخى ستوره. والستر بلغة أهل اليمن: معذار؛ قاله الضحاك وقال الشاعر:
ولكنها ضنت بمنزل ساعة علينا وأطت فوقها بالمعاذر
قال الزجاج: المعاذر: الستور، والواحد معذار؛ أي وإن أرخى ستره؛ يريد أن يخفى عمله، فنفسه شاهدة عليه. وقيل: أي ولو اعتذر فقال لم أفعل شيئا، لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه، فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه، فعليه شاهد يكذب عذره؛ قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبدالرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفراء والسدي أيضا ومقاتل. قال مقاتل: أي لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك. نظيره قوله تعالى: "يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم" [غافر: 52] وقوله: "ولا يؤذن لهم فيعتذرون" [المرسلات: 36] فالمعاذير على هذا: مأخوذ من العذر؛ قال الشاعر:
وإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر
فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر
واعتذر رجل إلى إبراهيم النخعي فقال له: قد عذرتك غير معتذر، إن المعاذير يشوبها الكذب. وقال ابن عباس: "ولو ألقى معاذيره" أي لو تجرد من ثيابه. حكاه الماوردي.
قلت: والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب؛ ومنه قول النابغة:
ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك الكند
والدليل على هذا قوله تعالى في الكفار "والله ربنا ما كنا مشركين" [الأنعام: 23] وقوله تعالى في المنافقين: "يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم" [المجادلة: 18]. وفي الصحيح أنه يقول: (يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع) الحديث. وقد تقدم في "حم السجدة" وغيرها. والمعاذير والمعاذر: جمع معذرة؛ ويقال: عذرته فيما صنع أعذره عذرا وعذرا، والاسم المعذرة والعذري؛ قال الشاعر:
إني حددت ولا عذرى لمحدود
وكذلك العذرة وهي مثل الركبة والجلسة؛ قال النابغة:
ها إن تا عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد
قال القاضي أبو بكر بن العربي قوله تعالى: "بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره": فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه؛ لأنها بشهادة منه عليها؛ قال الله سبحانه وتعالى: "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون" [النور: 24] ولا خلاف فيه؛ لأنه إخبار على وجه تنتفي التهمة عنه؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه، وهي
وقد قال سبحانه في كتابه الكريم: "وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين" [آل عمران: 81] ثم قال تعالى: "وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا" [التوبة: 102] وهو في الآثار كثير؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: إن أبي قد أقر أن فلانا ابنه، أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر الدين الذي يصيبه من المال الذي في يده. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين ويترك ستمائة دينار، ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استحق مائة دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، وإن أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه. وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم، إن كانت امرأة فورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء.
لا يصح الإقرار إلا من مكلف، لكن بشرط ألا يكون محجورا عليه؛ لأن الحجر يسقط قوله إن كان لحق نفسه، فإن كان لحق غيره كالمريض كان منه ساقط، ومنه جائز. وبيانه في مسائل الفقه. وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في ابتدائه، ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم. والثانية في انتهائه، وذلك مثل إبهام الإقرار، وله صور كثيرة وأمهاتها ست: الصورة الأولى: أن يقول له عندي شيء، قال الشافعي: لو فسره بتمرة أو كسرة قبل منه. والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قدر، فإذا فسره به قبل منه وحلف عليه. الصورة الثانية: أن يفسر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالا في الشريعة: لم يقبل باتفاق ولو ساعده عليه المقر له. الصورة الثالثة: أن يفسره بمختلف فيه مثل جلد الميتة أو سرقين أو كلب، (فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاء) فإن رده لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء، لأن الحكم قد نفذ بإبطاله، وقال بعض أصحاب الشافعي: يلزم الخمر والخنزير، وهو قول باطل.
وقال أبو حنيفة: إذا قال له علي شيء لم يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون، لأنه لا يثبت في الذمة بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعا. الصورة الرابعة: إذا قال له: عندي مال قبل تفسيره بما لا يكون مالا في العادة كالدرهم والدرهمين، ما لم يجيء من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه.
الصورة الخامسة: أن يقول له: عندي مال كثير أو عظيم؛ فقال الشافعي: يقبل في الحبة. وقال أبو حنيفة: لا يقبل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماؤنا في ذلك أقوالا مختلفة، منها نصاب السرقة والزكاة والدية وأقله عندي نصاب السرقة، لأنه لا يبان عضو المسلم إلا في مال عظيم. وبه قال أكثر الحنفية. ومن يعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد: إنه لا يقبل في أقل من اثنين وسبعين درهما. فقيل له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: "لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين" [التوبة: 25] وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصح؛ لأنه أخرج حنينا منها، وكان حقه أن يقول يقبل في أحد وسبعين، وقد قال الله تعالى: "اذكروا الله ذكرا كثيرا" [الأحزاب: 41]، وقال: "لا خير في كثير من نجواهم" [النساء: 114]، وقال: "والعنهم لعنا كبيرا" [الأحزاب: 68]. الصورة السادسة: إذا قال له: عندي عشرة أو مائة وخمسون درهما فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه، فإن قال ألف درهم أو مائة وعبد أو مائة وخمسون درهما فإنه يفسر المبهم ويقبل منه. وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا؛ كقوله: مائة وخمسون درهما؛ لأن الدرهم تفسير للخمسين، والخمسين تفسير للمائة. وقال ابن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي: الدرهم لا يكون تفسيرا في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويفسر هو المائة بما شاء.
قوله تعالى: "ولو ألقى معاذيره" ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله؛ فقال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة: يقبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك في أحد قوليه، وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا.
والصحيح جواز الرجوع مطلقا؛ لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزنى مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه، ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (أبك جنون) قال: لا. قال: (أحصنت) قال: نعم. وفي حديث البخاري: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت). وفي النسائي وأبي داود: حتى قال له في الخامسة (أجامعتها) قال: نعم. قال: (حتى غاب ذلك منك في ذلك منها) قال: نعم. قال: (كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر). قال: نعم. ثم قال: (هل تدري ما الزنى) قال: نعم، أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: (فما تريد مني)؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فرجم. قال الترمذي وأبو داود: فلما وجد مس الحجارة فر يشتد، فضربه رجل بلحى جمل، وضربه الناس حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا تركتموه) وقال أبو داود والنسائي: ليثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما لترك حد فلا. وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله. وفي قوله عليه السلام: (لعلك قبلت أو غمزت) إشارة إلى قول مالك: إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها.
وهذا في الحر المالك لأمر نفسه، فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين: إما أن يقر على بدنه، أو على ما في يده وذمته؛ فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرق لحق السيد، وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه؛ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: (من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن من يبدلنا صفحته نقم عليه الحد). المعنى: أن محل العقوبة أصل الخلقة، وهي (الدمية) في الآدمية، ولا حق للسيد فيها، وإنما حقه في الوصف والتبع، وهي المالية الطارئة عليه؛ ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل، حتى قال أبو حنيفة: إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقر له. وقال علماؤنا: السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق؛ لأن مال العبد للسيد إجماعا، فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه، لا سيما وأبو حنيفة يقول: إن العبد لا ملك له ولا يصح أن يملك ولا يملك، ونحن وإن قلنا إنه يصح تملكه. ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين. والله أعلم.
الآية: 16 - 21 {لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة، وتذرون الآخرة}
قوله تعالى: "لا تحرك به لسانك لتعجل به" في الترمذي: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه، يريد أن يحفظه، فأنزل الله تبارك وتعالى: "لا تحرك به لسانك لتعجل به" قال: فكان يحرك به شفتيه. وحرك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما؛ فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه؛ فأنزل الله عز وجل: "لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه" قال جمعه في صدرك ثم تقرؤه: "فإذا قرآناه فاتبع قرآنه" قال فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا أن نقرأه؛ قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع، وإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه؛ خرجه البخاري أيضا. ونظير هذه الآية قوله تعالى: "ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه" [طه: 114] وقد تقدم. وقال عامر الشعبي: إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبه له، وحلاوته في لسانه، فنهى عن ذلك حتى يجتمع؛ لأن بعضه مرتبط ببعض، وقيل: كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحي حرك لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه، فنزلت "ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه" [طه: 114] ونزل: "سنقرئك فلا تنسى" [الأعلى: 6] ونزل: "لا تحرك به لسانك" قاله ابن عباس: "وقرآنه" أي وقراءته عليك. والقراءة والقرآن في قول الفراء مصدران. وقال قتادة: "فاتبع قرآنه" أي فاتبع شرائعه وأحكامه. "ثم إن علينا بيانه" أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام؛ قاله قتادة. وقيل: ثم إن علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما وقيل: أي إن علينا أن نبينه بلسانك. "كلا" قال ابن عباس: أي إن أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه. وقيل: أي (كلا) لا يصلون ولا يذكون يريد كفار مكة. "بل تحبون" أي بل تحبون يا كفار أهل مكة "العاجلة" أي الدار الدنيا والحياة فيها "وتذرون" أي تدعون "الآخرة" والعمل لها. وفي بعض التفسير قال: الآخرة الجنة. وقرأ أهل المدينة والكوفيون "بل تحبون" "وتذرون" بالتاء فيهما على الخطاب واختاره أبو عبيد؛ قال: ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القراء لقرأتها بالياء؛ لذكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبر، وهو اختيار أبي حاتم، فمن قرأ بالياء فردا على قوله تعالى: "ينبأ الإنسان" [القيامة: 13] وهو بمعنى الناس. ومن قرأ بالتاء فعلى أنه واجههم بالتقريع؛ لأن ذلك أبلغ في المقصود؛ نظيره: "إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا" [الإنسان: 27].
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 577
577- تفسير الصفحة رقم577 من المصحفقوله تعالى: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين؛ وذلك أن قوما من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم، ثم شفع فيهم، فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة، فأخرجوا من النار، وليس للكفار شفيع يشفع فيهم.
وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: يشفع نبيكم صلى الله عليه وسلم رابع أربعة: جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى أو عيسى، ثم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ويبقى قوم في جهنم، فيقال لهم: "ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين" إلى قوله: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" قال عبدالله بن مسعود: فهؤلاء هم الذين يبقون في جهنم؛ وقد ذكرنا إسناده في كتاب (التذكرة).
الآية: 49 - 53 {فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة}
قوله تعالى: "فما لهم عن التذكرة معرضين" أي فما لأهل مكة أعرضوا وولوا عما جئتم به. وفي تفسير مقاتل: الإعراض عن القرآن من وجهين: أحدهما الجحود والإنكار، والوجه الآخر ترك العمل بما فيه. و"معرضين" نصب على الحال من الهاء والميم في "لهم" وفي اللام معنى الفعل؛ فانتصاب الحال على معنى الفعل. "كأنهم" أي كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد صلى الله عليه وسلم "حمر مستنفرة" قال ابن عباس: أراد الحمر الوحشية. وقرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء، أي منفرة مذعورة؛ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. الباقون بالكسر، أي نافرة. يقال. نفرت واستنفرت بمعنى؛ مثل عجبت واستعجبت، وسخرت واستسخرت، وأنشد الفراء:
أمسك حمارك إنه مستنفر في إثر أحمرة عمدن لغرب
قوله تعالى: "فرت" أي نفرت وهربت "من قسورة" أي من رماة يرمونها.
وقال بعض أهل اللغة: إن القسورة الرامي، وجمعه القسورة. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وابن كيسان: القسورة: هم الرماة والصيادون، ورواه عطاء عن ابن عباس وأبو [ظبيان] عن أبي موسى الأشعري. وقيل: إنه الأسد؛ قال أبو هريرة وابن عباس أيضا. ابن عرفة: من العسر بمعنى القهر أي؛ إنه يقهر السباع، والحمر الوحشية تهرب من السباع. وروى أبو جمرة عن ابن عباس قال: ما أعلم القسورة الأسد في لغة أحد من العرب، ولكنها عصب الرجال؛ قال: فالقسورة جمع الرجال، وأنشد:
يا بنت كوني خيرة لخيرة أخوالها الجن وأهل القسورة
وعنه: ركز الناس أي حسهم وأصواتهم. وعنه أيضا: "فرت من قسورة" أي من حبال الصيادين. وعنه أيضا: القسورة بلسان العرب: الأسد، وبلسان الحبشة: الرماة؛ وبلسان فارس: شير، وبلسان النبط: أريا. وقال ابن الأعرابي: القسورة: أول الليل؛ أي فرت من ظلمة الليل. وقاله عكرمة أيضا. وقيل: هو أول سواد الليل، ولا يقال لآخر سواد الليل قسورة. وقال زيد بن أسلم: من رجال أقوياء، وكل شديد عند العرب فهو قسورة وقسور. وقال لبيد بن ربيعة:
إذا ما هتفنا هتفة في ندينا أتانا الرجال العائدون القساور
قوله تعالى: "بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة" أي يعطى كتبا مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بكتب من رب العالمين مكتوب فيها: إني قد أرسلت إليكم محمدا، صلى الله عليه وسلم. نظيره: "ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه" [الإسراء: 93]. وقال ابن عباس: كانوا يقولون إن كان محمد صادقا فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار. قال مطر الوراق: أرادوا أن يعطوا بغير عمل. وقال الكلبي: قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح عند رأسه مكتوبا ذنبه وكفارته، فأتنا بمثل ذلك. وقال مجاهد: أرادوا أن ينزل على كل واحد منهم كتاب فيه من الله عز وجل: إلى فلان بن فلان. وقيل: المعنى أن يذكر بذكر جميل، فجعلت الصحف موضع الذكر مجازا. وقالوا: إذا كانت ذنوب الإنسان تكتب عليه فما بالنا لا نرى ذلك؟ "كلا" أي ليس يكون ذلك. وقيل: حقا. والأول أجود؛ لأنه رد لقولهم. "بل لا يخافون الآخرة" أي لا أعطيهم ما يتمنون لأنهم لا يخافون الآخرة، اغترارا بالدنيا. وقرأ سعيد بن جبير "صحفا منشرة" بسكون الحاء والنون، فأما تسكين الحاء فتخفيف، وأما النون فشاذ. إنما يقال: نشرت الثوب وشبهه ولا يقال أنشرت. ويجوز أن يكون شبه الصحيفة بالميت كأنها ميتة بطيها، فإذا نشرت حييت، فجاء على أنشر الله الميت، كما شبه إحياء الميت بنشر الثوب، فقيل فيه نشر الله الميت، فهي لغة فيه.
الآية: 54 - 56 {كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة}
قوله تعالى: "كلا إنه تذكرة" أي حقا إن القرآن عظة. "فمن شاء ذكره" أي اتعظ به. "وما يذكرون" أي وما يتعظون "إلا أن يشاء الله" أي ليس يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم. وقراءة العامة "يذكرون" بالياء واختاره أبو عبيد؛ لقوله تعالى: "كلا بل لا يخافون الآخرة". وقرأ نافع ويعقوب بالتاء، واختاره أبو حاتم، لأنه أعم واتفقوا على تخفيفها. "هو أهل التقوى وأهل المغفرة" في الترمذي وسنن ابن ماجة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: "هو أهل التقوى وأهل المغفرة" قال: [قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له] لفظ الترمذي، وقال فيه: حديث حسن غريب. وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبار، وأهل المغفرة أيضا للذنوب الصغار، باجتناب الذنوب الكبار.
وقال محمد بن نصر: أنا أهل أن يتقيني عبدي، فإن لم يفعل كنت أهلا أن أغفر له [وأرحمه، وأنا الغفور الرحيم].
سورة القيامة
الآية: 1 - 6 {لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة}
قوله تعالى: "لا أقسم بيوم القيامة" قيل: إن "لا" صلة، وجاز وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض، فهو في حكم كلام واحد؛ ولهذا قد يذكر الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى؛ كقوله تعالى: "وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون" [الحجر: 6]. وجوابه في سورة أخرى: "ما أنت بنعمة ربك بمجنون" [القلم: 2]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة؛ قال ابن عباس وابن جبير وأبو عبيدة؛ ومثله قول الشاعر:
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة فكاد صميم القلب لا يتقطع
وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى "لا أقسم": أقسم. واختلفوا في تفسير: "لا" قال بعضهم: "لا" زيادة في الكلام للزينة، ويجري في كلام العرب زيادة (لا) كما قال في آية أخرى: "قال ما منعك أن تسجد" [ص: 75]. يعني أن تسجد، وقال بعضهم: "لا": رد لكلامهم حيث أنكروا البعث، فقال: ليس الأمر كما زعمتم.
قلت: وهذا قول الفراء؛ قال الفراء: وكثير من النحويين يقولون "لا" صلة، ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه، ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار، فجاء الإقسام بالرد عليهم (في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدأ) وذلك كقولهم لا والله لا أفعل "فلا" رد لكلام قد مضى، وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحق، كأنك أكذبت قوما أنكروه. وأنشد غير الفراء لامرئ القيس:
فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر
وقال غوية بن سلمى:
ألا نادت أمامة باحتمال لتحزنني فلا بك ما أبالي
وفائدتها توكيد القسم في الرد. قال الفراء: وكان من لا يعرف هذه الجهة يقرأ "لأقسم" بغير ألف؛ كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم، وهو صواب؛ لأن العرب تقول: لأقسم بالله وهي قراءة الحسن وابن كثير والزهري وابن هرمز "بيوم القيامة" أي بيوم يقوم الناس فيه لربهم، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء. "ولا أقسم بالنفس اللوامة" لا خلاف في هذا بين القراء، وهو أنه أقسم سبحانه بيوم القيامة تعظيما لشأنه (ولم يقسم بالنفس). وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية.
وقيل: "ولا أقسم بالنفس اللوامة" رد آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة. قال الثعلبي: والصحيح أنه أقسم بهما جميعا. ومعنى: "بالنفس اللوامة" أي بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه؛ قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن، ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلامى؟ ما أردت بأكلي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لم فعلته، وعلى الخير لم لا تستكثر منه. وقيل: إنها ذات اللوم.
وقيل: إنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللوامة بمعنى اللائمة، وهو صفة مدح؛ وعلى هذا يجيء القسم بها سائغا حسنا. وفي بعض التفسير: إنه آدم عليه السلام لم يزل لائما لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة. وقيل: اللوامة بمعنى الملومة المذمومة عن ابن عباس أيضا - فهي صفة ذم وهو قول من نفى أن يكون قسما؛ إذ ليس للعاصي خطر يقسم به، فهي كثيرة اللوم. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه، ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله. وقال الفراء: ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسانا، والمسيء يلوم نفسه ألا يكون ارعوى عن إساءته.
قوله تعالى: "أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه" فنعيدها خلقا جديدا بعد أن صارت رفاتا. قال الزجاج: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة: ليجمعن العظام للبعث، فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم محذوف أي لتبعثن؛ ودل عليه قوله تعالى: "أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه" للإحياء والبعث. والإنسان هنا الكافر المكذب للبعث. الآية نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عن يوم القيامة متى تكون، وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أأمن به، أو يجمع الله العظام؟ ! ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم اكفني جاري السوء عدي بن ربيعة، والأخنس بن شريق). وقيل: نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت. وذكر العظام والمراد نفسه كلها؛ لأن العظام قالب الخلق. "بلى" وقف حسن ثم تبتدئ "قادرين". قال سيبويه: على معنى نجمعها قادرين، "فقادرين" حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف على ما ذكرناه من التقدير. وقيل: المعنى بل نقدر قادرين. قال الفراء: "قادرين" نصب على الخروج من "نجمع" أي نقدر ونقوى "قادرين" على أكثر من ذلك. وقال أيضا: يصلح نصبه على التكرير أي "بلى" فليحسبنا قادرين. وقيل: المضمر (كنا) أي كنا قادرين في الابتداء، وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميقع "بلى قادرون" بتأويل نحن قادرون. "على أن نسوي بنانه" البنان عند العرب: الأصابع، واحدها بنانة؛ قال النابغة:
بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد
وقال عنترة:
وأن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندواني
فنبه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضا فإنها أصغر العظام، فخصها بالذكر لذلك.
قال القتبي والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام؛ فقال الله تعالى: بلى قادرين على أن نعيد السلاميات على صغرها، ونؤلف بينها حتى تستوي، ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر. وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى "على أن نسوي بنانه" أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخف البعير، أو كحافر الحمار، أو كظلف الخنزير، ولا يمكنه أن يعمل به شيئا، ولكنا فرقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء. وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تبسطهن، وتقبضهن بهن، ولو شاء الله لجمعهن فلم تتق الأرض إلا بكفيك. وقيل: أي نقدر أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم، فكيف في صورته التي كان عليها؛ وهو كقوله تعالى: "وما نحن بمسبوقين. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون" [الواقعة:61 ].
قلت: والتأويل الأول أشبه بمساق الآية. والله أعلم.
قوله تعالى: "بل يريد الإنسان ليفجر أمامه" قال ابن عباس: يعني الكافر يكذب بما أمامه من البعث والحساب. وقال عبدالرحمن بن زيد؛ ودليله: "يسأل أيان يوم القيامة" أي يسأل متى يكون! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه من التكذيب، ولكن يأثم لما بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره القتبي وغيره: أن أعرابيا قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكا إليه نقب إبله ودبرها، وسأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله؛ فقال الأعرابي:
أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر
فاغفر له اللهم إن كان فجر
يعني إن كان كذبني فيما ذكرت. وعن ابن عباس أيضا: يعجل المعصية ويسوف التوبة. وفي بعض الحديث قال: يقول سوف أتوب ولا يتوب؛ فهو قد أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدي وسعيد بن جبير، يقول: سوف أتوب، سوف أتوب، حتى يأتيه الموت على أشر أحواله. وقال الضحاك: هو الأمل يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت. وقيل: أي يعزم على المعصية أبدا وإن كان لا يعيش إلا مدة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. وقيل: الهاء ليوم القيامة. والمعنى بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة. والفجور أصله الميل عن الحق. "يسأل أيان يوم القيامة" أي متى يوم القيامة.
الآية: 7 - 13 {فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر}
قوله تعالى: "فإذا برق البصر" قرأ نافع وأبان عن عاصم "برق" بفتح الراء، معناه: لمع بصره من شدة شخوصه، فتراه لا يطرف. قال مجاهد وغيره: هذا عند الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامة. وقال فيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة "إذا برق البصر. وخسف القمر" والباقون بالكسر "برق" ومعناه: تحير فلم يطرف؛ قاله أبو عمرو والزجاج وغيرهما. قال ذو الرمة:
ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافرا كاد يبرق
الفراء والخليل: "برق" بالكسر: فزع وبهت وتحير. والعرب تقول للإنسان المتحير المبهوت: قد برق فهو برق؛ وأنشد الفراء:
فنفسك فانع ولا تنعني وداو الكلوم ولا تبرق
أي لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك. وقيل: برق يبرق بالفتح: شق عينيه وفتحهما. قاله أبو عبيدة؛ وأنشد قول الكلابي:
لما أتاني ابن عمير راغبا أعطيته عيشا صهابا فبرق
أي فتح عينيه. وقيل: إن كسر الراء وفتحها لغتان بمعنى.
قوله تعالى: "وخسف القمر" أي ذهب ضوئه. والخسوف في الدنيا إلى انجلاء، بخلاف الآخرة، فإنه لا يعود ضوئه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه قوله تعالى: "فخسفنا به وبداره الأرض" [القصص: 81]. وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعرج: "وخسف القمر" بضم الخاء وكسر السين يدل عليه "وجمع الشمس والقمر". وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا ذهب بعضه فهو الكسوف، وإذا ذهب كله فهو الخسوف. "وجمع الشمس والقمر" أي جمع بينهما في ذهاب ضوئهما، فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه؛ قاله الفراء والزجاج.
قال الفراء: ولم يقل جمعت؛ لأن المعنى جمع بينهما. وقال أبو عبيدة: هو على تغليب المذكر. وقال الكسائي: هو محمول على المعنى، كأنه قال الضوءان. المبرد: التأنيث غير حقيقي. وقال ابن عباس وابن مسعود: جمع بينهما أي قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين كأنهما ثوران عقيران. وقد مضى الحديث بهذا المعنى في آخر سورة "الأنعام". وفي قراءة عبدالله "وجمع بين الشمس والقمر" وقال عطاء بن يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر، فيكونان نار الله الكبرى. وقال علي وابن عباس: يجعلان في (نور) الحجب. وقد يجمعان في نار جهنم؛ لأنهما قد عبدا من دون الله ولا تكون النار عذابا لهما لأنهما جماد، وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم. وفي مسند أبي داود الطيالسي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس ابن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار)
وقيل: هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان، ويقربان من الناس، فيلحقهم العرق لشدة الحر؛ فكأن المعنى يجمع حرهما عليهم. وقيل: يجمع الشمس والقمر، فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار.
قوله تعالى: "يقول الإنسان يومئذ أين المفر" أي يقول ابن آدم، ويقال: أبو جهل؛ أي أين المهرب؟ قال الشاعر:
أين المفر والكباش تنتطح وأي كبش حاد عنها يفتضح
الماوردي: ويحتمل وجهين: أحدهما "أين المفر" من الله استحياء منه. الثاني "أين المفر" من جهنم حذرا منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: أحدهما: أن يكون من الكافر خاصة في عرضة القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن ببشرى ربه. الثاني: أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما شاهدوا منها. وقراءة العامة "المفر" بفتح الفاء واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم؛ لأنه مصدر. وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع فتح الميم؛ قال الكسائي: هما لغتان مثل مدب ومدب، ومصح ومصح. وعن الزهري بكسر الميم وفتح الفاء. المهدوي: من فتح الميم والفاء من "المفر" فهو مصدر بمعنى الفرار، ومن فتح الميم وكسر الفاء فهو الموضع الذي يفر إليه. ومن كسر الميم وفتح الفاء فهو الإنسان الجيد الفرار؛ فالمعنى أين الإنسان الجيد الفرار ولن ينجو مع ذلك.
قلت: ومنه قول امرئ القيس:
مكر مفر مقبل مدبر معا
يريد أنه حسن الكر والفر جيده. "كلا" أي لا مفر "فكلا" رد وهو من قول الله تعالى.. ثم فسر هذا الرد فقال: "لا وزر" أي لا ملجأ من النار. وكان ابن مسعود يقول: لا حصن. وكان الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. وابن جبير: لا محيص ولا منعة. المعنى في ذلك كله واحد. والوزر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما؛ قال الشاعر:
لعمري ما للفتى من وزر من الموت يدركه والكبر
قال السدي: كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصنوا في الجبال، فقال الله لهم: لا وزر يعصمكم يومئذ مني؛ قال طرفة:
ولقد تعلم بكر أننا فاضلوا الرأي وفي الروع وزر
أي ملجأ للخائف. ويروى: وقر. "إلى ربك يومئذ المستقر" أي المنتهى؛ قال قتادة نظيره: "وأن إلى ربك المنتهى" [النجم: 42]. وقال ابن مسعود: إلى ربك المصير والمرجع. قيل: أي المستقر في الآخرة حيث يقره الله تعالى؛ إذ هو الحاكم بينهم.
وقيل: إن "كلا" من قول الإنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له مفر قال لنفسه: "كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر".
قوله تعالى: "ينبأ الإنسان" أي يخبر ابن آدم برا كان أو فاجرا "بما قدم وأخر": أي بما أسلف من عمل سيء أو صالح، أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يعمل بها بعده؛ قاله ابن عباس وابن مسعود. وروى منصور عن مجاهد قال: ينبأ بأول عمله وآخره. وقاله النخعي. وقال ابن عباس أيضا: أي بما قدم من المعصية، وأخر من الطاعة. وهو قول قتادة. وقال ابن زيد: "بما قدم" من أمواله لنفسه "وأخر": خلف للورثة. وقال الضحاك: ينبأ بما قدم من فرض، وأخر من فرض. قال القشيري: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون عند الموت.
قلت: والأول أظهر؛ لما خرجه ابن ماجة في سننه من حديث الزهري، حدثني أبو عبدالله الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته) وخرجه أبو نعيم الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته) فقوله: (بعد موته وهو في قبره) نص على أن ذلك لا يكون عند الموت، وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن عمله، وإن كان يبشر بذلك في قبره. ودل على هذا أيضا قوله الحق: "وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم" [العنكبوت: 13] وقوله تعالى: "ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم" [النحل: 25] وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم.
وفي الصحيح: (من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء).
الآية: 14 - 15 {بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره}
قوله تعالى: "بل الإنسان على نفسه بصيرة" قال الأخفش: جعله هو البصيرة، كما تقول للرجل أنت حجة على نفسك. وقال ابن عباس: "بصيرة" أي شاهد، وهو شهود جوارحه عليه: يداه بما بطش بهما، ورجلاه بما مشى عليهما، وعيناه بما أبصر بهما. والبصيرة: الشاهد. وأنشد الفراء:
كأن على ذي العقل عينا بصيرة بمقعده أو منظر هو ناظره
يحاذر حتى يحسب الناس كلهم من الخوف لا تخفى عليهم سرائره
ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى: "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون" [النور: 24]. وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارح، لأنها شاهدة على نفس الإنسان؛ فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة؛ قال معناه القتبي وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: "بصيرة" هي التي يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة، كالهاء في قولهم: داهية وعلامة وراوية. وهو قول أبي عبيد. وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير أو شر؛ يدل عليه قوله تعالى: "ولو ألقى معاذيره" فيمن جعل المعاذير الستور. وهو قول السدي والضحاك. وقال بعض أهل التفسير: المعنى بل على الإنسان من نفسه بصيرة؛ أي شاهد فحذف حرف الجر. ويجوز أن يكون "بصيرة" نعتا لاسم مؤنث فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه عين بصيرة؛ وأنشد الفراء:
كأن على ذي العقل عينا بصيرة
وقال الحسن في قوله تعالى: "بل الإنسان على نفسه بصيرة" يعني بصير بعيوب غيره، جاهل بعيوب نفسه. أي ولو أرخى ستوره. والستر بلغة أهل اليمن: معذار؛ قاله الضحاك وقال الشاعر:
ولكنها ضنت بمنزل ساعة علينا وأطت فوقها بالمعاذر
قال الزجاج: المعاذر: الستور، والواحد معذار؛ أي وإن أرخى ستره؛ يريد أن يخفى عمله، فنفسه شاهدة عليه. وقيل: أي ولو اعتذر فقال لم أفعل شيئا، لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه، فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه، فعليه شاهد يكذب عذره؛ قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبدالرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفراء والسدي أيضا ومقاتل. قال مقاتل: أي لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك. نظيره قوله تعالى: "يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم" [غافر: 52] وقوله: "ولا يؤذن لهم فيعتذرون" [المرسلات: 36] فالمعاذير على هذا: مأخوذ من العذر؛ قال الشاعر:
وإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر
فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر
واعتذر رجل إلى إبراهيم النخعي فقال له: قد عذرتك غير معتذر، إن المعاذير يشوبها الكذب. وقال ابن عباس: "ولو ألقى معاذيره" أي لو تجرد من ثيابه. حكاه الماوردي.
قلت: والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب؛ ومنه قول النابغة:
ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك الكند
والدليل على هذا قوله تعالى في الكفار "والله ربنا ما كنا مشركين" [الأنعام: 23] وقوله تعالى في المنافقين: "يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم" [المجادلة: 18]. وفي الصحيح أنه يقول: (يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع) الحديث. وقد تقدم في "حم السجدة" وغيرها. والمعاذير والمعاذر: جمع معذرة؛ ويقال: عذرته فيما صنع أعذره عذرا وعذرا، والاسم المعذرة والعذري؛ قال الشاعر:
إني حددت ولا عذرى لمحدود
وكذلك العذرة وهي مثل الركبة والجلسة؛ قال النابغة:
ها إن تا عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد
قال القاضي أبو بكر بن العربي قوله تعالى: "بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره": فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه؛ لأنها بشهادة منه عليها؛ قال الله سبحانه وتعالى: "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون" [النور: 24] ولا خلاف فيه؛ لأنه إخبار على وجه تنتفي التهمة عنه؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه، وهي
وقد قال سبحانه في كتابه الكريم: "وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين" [آل عمران: 81] ثم قال تعالى: "وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا" [التوبة: 102] وهو في الآثار كثير؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: إن أبي قد أقر أن فلانا ابنه، أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر الدين الذي يصيبه من المال الذي في يده. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين ويترك ستمائة دينار، ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استحق مائة دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، وإن أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه. وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم، إن كانت امرأة فورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء.
لا يصح الإقرار إلا من مكلف، لكن بشرط ألا يكون محجورا عليه؛ لأن الحجر يسقط قوله إن كان لحق نفسه، فإن كان لحق غيره كالمريض كان منه ساقط، ومنه جائز. وبيانه في مسائل الفقه. وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في ابتدائه، ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم. والثانية في انتهائه، وذلك مثل إبهام الإقرار، وله صور كثيرة وأمهاتها ست: الصورة الأولى: أن يقول له عندي شيء، قال الشافعي: لو فسره بتمرة أو كسرة قبل منه. والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قدر، فإذا فسره به قبل منه وحلف عليه. الصورة الثانية: أن يفسر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالا في الشريعة: لم يقبل باتفاق ولو ساعده عليه المقر له. الصورة الثالثة: أن يفسره بمختلف فيه مثل جلد الميتة أو سرقين أو كلب، (فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاء) فإن رده لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء، لأن الحكم قد نفذ بإبطاله، وقال بعض أصحاب الشافعي: يلزم الخمر والخنزير، وهو قول باطل.
وقال أبو حنيفة: إذا قال له علي شيء لم يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون، لأنه لا يثبت في الذمة بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعا. الصورة الرابعة: إذا قال له: عندي مال قبل تفسيره بما لا يكون مالا في العادة كالدرهم والدرهمين، ما لم يجيء من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه.
الصورة الخامسة: أن يقول له: عندي مال كثير أو عظيم؛ فقال الشافعي: يقبل في الحبة. وقال أبو حنيفة: لا يقبل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماؤنا في ذلك أقوالا مختلفة، منها نصاب السرقة والزكاة والدية وأقله عندي نصاب السرقة، لأنه لا يبان عضو المسلم إلا في مال عظيم. وبه قال أكثر الحنفية. ومن يعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد: إنه لا يقبل في أقل من اثنين وسبعين درهما. فقيل له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: "لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين" [التوبة: 25] وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصح؛ لأنه أخرج حنينا منها، وكان حقه أن يقول يقبل في أحد وسبعين، وقد قال الله تعالى: "اذكروا الله ذكرا كثيرا" [الأحزاب: 41]، وقال: "لا خير في كثير من نجواهم" [النساء: 114]، وقال: "والعنهم لعنا كبيرا" [الأحزاب: 68]. الصورة السادسة: إذا قال له: عندي عشرة أو مائة وخمسون درهما فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه، فإن قال ألف درهم أو مائة وعبد أو مائة وخمسون درهما فإنه يفسر المبهم ويقبل منه. وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا؛ كقوله: مائة وخمسون درهما؛ لأن الدرهم تفسير للخمسين، والخمسين تفسير للمائة. وقال ابن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي: الدرهم لا يكون تفسيرا في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويفسر هو المائة بما شاء.
قوله تعالى: "ولو ألقى معاذيره" ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله؛ فقال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة: يقبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك في أحد قوليه، وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا.
والصحيح جواز الرجوع مطلقا؛ لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزنى مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه، ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (أبك جنون) قال: لا. قال: (أحصنت) قال: نعم. وفي حديث البخاري: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت). وفي النسائي وأبي داود: حتى قال له في الخامسة (أجامعتها) قال: نعم. قال: (حتى غاب ذلك منك في ذلك منها) قال: نعم. قال: (كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر). قال: نعم. ثم قال: (هل تدري ما الزنى) قال: نعم، أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: (فما تريد مني)؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فرجم. قال الترمذي وأبو داود: فلما وجد مس الحجارة فر يشتد، فضربه رجل بلحى جمل، وضربه الناس حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا تركتموه) وقال أبو داود والنسائي: ليثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما لترك حد فلا. وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله. وفي قوله عليه السلام: (لعلك قبلت أو غمزت) إشارة إلى قول مالك: إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها.
وهذا في الحر المالك لأمر نفسه، فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين: إما أن يقر على بدنه، أو على ما في يده وذمته؛ فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرق لحق السيد، وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه؛ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: (من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن من يبدلنا صفحته نقم عليه الحد). المعنى: أن محل العقوبة أصل الخلقة، وهي (الدمية) في الآدمية، ولا حق للسيد فيها، وإنما حقه في الوصف والتبع، وهي المالية الطارئة عليه؛ ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل، حتى قال أبو حنيفة: إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقر له. وقال علماؤنا: السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق؛ لأن مال العبد للسيد إجماعا، فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه، لا سيما وأبو حنيفة يقول: إن العبد لا ملك له ولا يصح أن يملك ولا يملك، ونحن وإن قلنا إنه يصح تملكه. ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين. والله أعلم.
الآية: 16 - 21 {لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة، وتذرون الآخرة}
قوله تعالى: "لا تحرك به لسانك لتعجل به" في الترمذي: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه، يريد أن يحفظه، فأنزل الله تبارك وتعالى: "لا تحرك به لسانك لتعجل به" قال: فكان يحرك به شفتيه. وحرك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما؛ فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه؛ فأنزل الله عز وجل: "لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه" قال جمعه في صدرك ثم تقرؤه: "فإذا قرآناه فاتبع قرآنه" قال فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا أن نقرأه؛ قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع، وإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه؛ خرجه البخاري أيضا. ونظير هذه الآية قوله تعالى: "ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه" [طه: 114] وقد تقدم. وقال عامر الشعبي: إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبه له، وحلاوته في لسانه، فنهى عن ذلك حتى يجتمع؛ لأن بعضه مرتبط ببعض، وقيل: كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحي حرك لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه، فنزلت "ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه" [طه: 114] ونزل: "سنقرئك فلا تنسى" [الأعلى: 6] ونزل: "لا تحرك به لسانك" قاله ابن عباس: "وقرآنه" أي وقراءته عليك. والقراءة والقرآن في قول الفراء مصدران. وقال قتادة: "فاتبع قرآنه" أي فاتبع شرائعه وأحكامه. "ثم إن علينا بيانه" أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام؛ قاله قتادة. وقيل: ثم إن علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما وقيل: أي إن علينا أن نبينه بلسانك. "كلا" قال ابن عباس: أي إن أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه. وقيل: أي (كلا) لا يصلون ولا يذكون يريد كفار مكة. "بل تحبون" أي بل تحبون يا كفار أهل مكة "العاجلة" أي الدار الدنيا والحياة فيها "وتذرون" أي تدعون "الآخرة" والعمل لها. وفي بعض التفسير قال: الآخرة الجنة. وقرأ أهل المدينة والكوفيون "بل تحبون" "وتذرون" بالتاء فيهما على الخطاب واختاره أبو عبيد؛ قال: ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القراء لقرأتها بالياء؛ لذكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبر، وهو اختيار أبي حاتم، فمن قرأ بالياء فردا على قوله تعالى: "ينبأ الإنسان" [القيامة: 13] وهو بمعنى الناس. ومن قرأ بالتاء فعلى أنه واجههم بالتقريع؛ لأن ذلك أبلغ في المقصود؛ نظيره: "إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا" [الإنسان: 27].










الصفحة رقم 577 من المصحف تحميل و استماع mp3