سورة المدثر | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
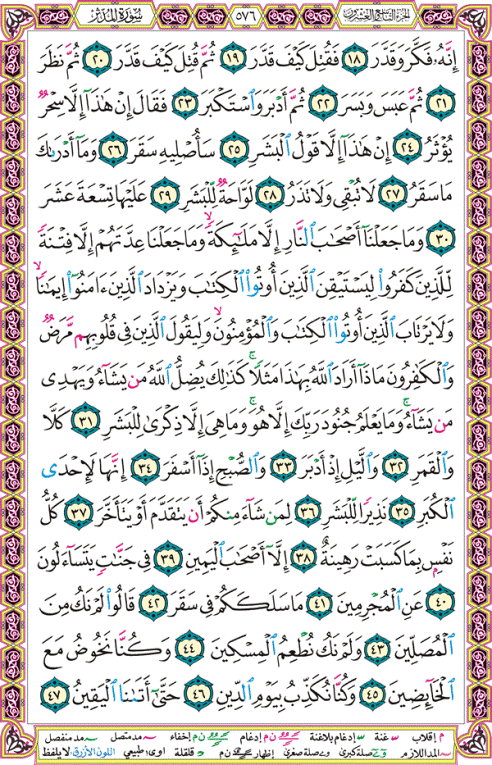
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 576 من المصحف
الآية: 18 - 25 {إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر}
قوله تعالى: "إنه فكر وقدر" يعني الوليد فكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن و"قدر" أي هيأ الكلام في نفسه، والعرب تقول: قدرت الشيء إذا هيأته، وذلك أنه لما نزل: "حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم" [غافر: 1] إلى قوله: "إليه المصير" سمعه الوليد يقرؤها فقال: والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. فقالت قريش: صبا الوليد لتصبون قريش كلها. وكان يقال للوليد ريحانة قريش؛ فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فمضى إليه حزينا؟ فقال له: مالي أراك حزينا. فقال له: ومالي لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد، وتدخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهما؛ فغضب الوليد وتكبر، وقال: أنا أحتاج إلى كسر محمد وصاحبه، فأنتم تعرفون قدر مالي، واللات والعزى ما بي حاجة إلى ذلك، وإنما أنتم تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه قط يخنق؟ قالوا: لا والله، قال: وتزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا والله. قال: فتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا: لا والله. قال: فتزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط، ولقد رأينا للكهنة أسجاعا وتخالجا فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الصادق الأمين من كثرة صدقه. فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه، ثم نظر، ثم عبس، فقال ما هو إلا ساحر! أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فذلك قوله تعالى: "إنه فكر" أي في أمر محمد والقرآن "وقدر" في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما. "فقتل" أي لعن. وكان بعض أهل التأويل يقول: معناها فقهر وغلب، وكل مذلل مقتل؛ قال الشاعر:
وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتل
وقال الزهري: عذب؛ وهو من باب الدعاء. "كيف قدر" قال ناس: "كيف" تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجب من صنيعه: كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله: "انظر كيف ضربوا لك الأمثال" [الإسراء: 48]. "ثم قتل" أي لعن لعنا بعد لعن. وقيل: فقتل بضرب من العقوبة، ثم قتل بضرب آخر من العقوبة "كيف قدر" أي على أي حال قدر. "ثم نظر" بأي شيء يرد الحق ويدفعه. "ثم عبس" أي قطب بين عينيه في وجوه المؤمنين؛ وذلك أنه لما حمل قريشا على ما حملهم عليه من القول في محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، مر على جماعة من المسلمين، فدعوه إلى الإسلام، فعبس في وجوههم.. قيل: عبس وبسر على النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه. والعبس مخففا مصدر عبس يعبس عبسا وعبوسا: إذا قطب. والعبس ما يتعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ قال أبو النجم:
كأن في أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الأيل
قوله تعالى: "وبسر" أي كلح وجهه وتغير لونه؛ قال قتادة والسدي؛ ومنه قول بشر بن أبي خازم:
صبحنا تميما غداة الجفار بشهباء ملمومة باسره
وقال آخر:
وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها
وقيل: إن ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة، وظهور البسور في الوجه قبل المحاورة. وقال قوم: "بسر" وقف لا يتقدم ولا يتأخر. قالوا: وكذلك يقول أهل اليمن إذا وقف المركب، فلم يجيء ولم يذهب: قد بسر المركب، وأبسر أي وقف وقد أبسرنا. والعرب تقول: وجه باسر بين البسور: إذا تغير واسود. "ثم أدبر" أي ولى وأعرض ذاهبا إلى أهله. "واستكبر" أي تعظم عن أن يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان واستكبر حين دعي إليه. "فقال إن هذا" أي ما هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم "إلا سحر يؤثر" أي يأثره عن غيره. والسحر: الخديعة. وقد تقدم بيانه في سورة (البقرة). وقال قوم: السحر: إظهار الباطل في صورة الحق. والأثره: مصدر قولك: أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك؛ ومنه قيل: حديث مأثور: أي ينقله خلف عن سلف؛ قال امرؤ القيس:
ولو عن نثا غيره جاءني وجرح اللسان كجرح اليد
لقلت من القول ما لا يزا ل يؤثر عني يد المسند
يريد: آخر الدهر، وقال الأعشى:
إن الذي فيه تماريتما بين للسامع والآثر
ويروى: بين. "إن هذا إلا قول البشر" أي ما هذا إلا كلام المخلوقين، يختدع به القلوب كما تختدع بالسحر، قال السدي: يعنون أنه من قول سيار عبد لبني الحضرمي، كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك.
وقيل: أراد أنه تلقنه من أهل بابل. وقيل: عن مسيلمة. وقيل: عن عدي الحضرمي الكاهن. وقيل: إنما تلقنه ممن ادعى النبوة قبله، فنسج على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير: إن هذا إلا أمر سحر يؤثر؛ أي يورث.
الآية: 26 - 29 {سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر}
أي سأدخله سقر كي يصلى حرها. وإنما سميت سقر من سقرته الشمس: إذا أذابته ولوحته، وأحرقت جلدة وجهه. ولا ينصرف للتعريف والتأنيث. قال ابن عباس: هي الطبق السادس من جهنم. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [سأل موسى ربه فقال: أي رب، أي عبادك أفقر؟ قال صاحب سقر] ذكره الثعلبي: "وما أدراك ما سقر"؟ هذه مبالغة في وصفها؛ أي وما أعلمك أي شيء هي؟ وهي كلمة تعظيم، ثم فسر حالها فقال: "لا تبقي ولا تذر" أي لا تترك لهم عظما ولا لحما ولا دما إلا أحرقته. وقيل: لا تبقي منهم شيئا ثم يعادون خلقا جديدا، فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبدا. وقال مجاهد: لا تبقى من فيها حيا ولا تذره ميتا، تحرقهم كلما جددوا. وقال السدي: لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما "لواحة للبشر" أي مغيرة من لاحه إذا غيره. وقراءة العامة "لواحة" بالرفع نعت لـ "سقر" في قوله تعالى: "وما أدراك ما سقر". وقرأ عطية العوفي ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر "لواحة" بالنصب على الاختصاص، للتهويل. وقال أبو رزين: تلفح وجوههم لفحة تدعها أشد سوادا من الليل؛ وقاله مجاهد. والعرب تقول: لاحه البرد والحر والسقم والحزن: إذا غيره، ومنه قول الشاعر:
تقول ما لا حك يا مسافر يا ابنة عمي لاحني الهواجر
وقال آخر:
وتعجب هند أن رأتني شاحبا تقول لشيء لوحته السمائم
وقال رؤبة بن العجاج:
لوح منه بعد بدن وسنق تلويحك الضامر يطوى للسبق
وقيل: إن اللوح شدة العطش؛ يقال: لاحة العطش ولوحه أي غيره. والمعنى أنها معطشة للبشر أي لأهلها؛ قاله الأخفش؛ وأنشد:
سقتني على لوح من الماء شربة سقاها بها الله الرهام الغواديا
يعني باللوح شدة العطش، والتاح أي عطش، والرهام جمع رهمة بالكسر وهي المطرة الضعيفة وأرهمت السحابة أتت بالرهام. وقال ابن عباس: "لواحة" أي تلوح للبشر من مسيرة خمسمائة عام. الحسن وابن كيسان: تلوح لهم جهنم حتى يروها عيانا. نظيره: "وبرزت الجحيم للغاوين" [الشعراء: 91] وفي البشر وجهان: أحدهما: أنه الإنس من أهل النار؛ قاله الأخفش والأكثرون. الثاني: أنه جمع بشرة، وهي جلدة الإنسان الظاهرة؛ قال مجاهد وقتادة، وجمع البشر أبشار، وهذا على التفسير الأول، وأما على تفسير ابن عباس فلا يستقيم فيه إلا الناس لا الجلود؛ لأنه من لاح الشيء يلوح، إذا لمع.
الآية: 30 - 31 {عليها تسعة عشر، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر}
قوله تعالى: "عليها تسعة عشر" أي على سقر تسعه عشر من الملائكة يلقون فيها أهلها. ثم قيل: على جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتها؛ مالك وثمانية عشر ملكا. ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيبا، ويحتمل أن يكون تسعة عشر ملكا بأعيانهم. وعلى هذا أكثر المفسرين. الثعلبي: ولا ينكر هذا، فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق. وقال ابن جريج: نعت النبي صلى الله عليه وسلم خزنة جهنم فقال: [فكأن أعينهم البرق، وكأن أفواههم الصياصي، يجرون أشعارهم، لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين، يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل، فيرميهم في النار، ويرمي فوقهم الجبل].
قلت: وذكر ابن المبارك قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن رجل من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام، فقرأ هذه الآية: "وما أدراك ما سقر. لا تبقى ولا تذر. لواحة للبشر. عليها تسعة عشر" فقال ما تسعة عشر؟ تسعة عشر ألف ملك، أو تسعة عشر ملكا؟ قال: قلت: لا بل تسعة عشر ملكا. فقال: وأنى تعلم ذلك؟ فقلت: لقول الله عز وجل: "وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا" قال: صدقت هم تسعة عشر ملكا، بيد كل ملك منهم مرزبة لها شعبتان، فيضرب الضربة فيهوي بها في النار سبعين ألفا. وعن عمرو بن دينار: كل واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر. خرج الترمذي عن جابر بن عبدالله. قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد غلب أصحابك اليوم؛ فقال: (وماذا غلبوا)؟ قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال: (فماذا قالوا) قال: قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا. قال: (أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون، فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا؟ لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا الله جهرة، علي بأعداء الله! إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك). فلما جاؤوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: (هكذا وهكذا) في مرة عشرة وفي مرة تسعة. قالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (ما تربة الجنة) قال: فسكتوا هنيهة ثم قالوا: أخبزة يا أبا القاسم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخبز من الدرمك). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر. وذكر ابن وهب قال: حدثنا عبدالرحمن بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزنة جهنم: [ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب].
وقال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم.
قلت: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر، هم الرؤساء والنقباء، وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها؛ كما قال الله تعالى: "وما يعلم جنود ربك إلا هو" وقد ثبت في الصحيح عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها). وقال ابن عباس وقتادة والضحاك: لما نزل: "عليها تسعة عشر" قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم! أسمع بن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم تسعة عشر، وأنتم الدهم - أي العدد - والشجعان، فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم! قال السدي: فقال أبو الأسود بن كلدة الجمحي: لا يهولنكم التسعة عشر، أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة، وبمنكبي الأيسر التسعة، ثم تمرون إلى الجنة؛ يقولها مستهزئا. في رواية: أن الحرث بن كلدة قال أنا أكفيكم سبعة عشر، واكفوني أنتم اثنين. وقيل: إن أبا جهل قال أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم، ثم تخرجون من النار؟ فنزل قوله تعالى: "وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة" أي لم نجعلهم رجالا فتتعاطون مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المعذبين من الجن والإنس، فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة، ولا يستروحون إليهم؛ ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له، فتؤمن هوادتهم؛ ولأنهم أشد خلق الله بأسا وأقواهم بطشا. "وما جعلنا عدتهم إلا فتنة" أي بلية. وروي عن ابن عباس من غير وجه قال: ضلالة للذين كفروا، يريد أبا جهل وذويه. وقيل: إلا عذابا، كما قال تعالى: "يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم" [الذاريات: 14]. أي جعلنا ذلك سبب كفرهم وسبب العذاب. وفي "تسعة عشر" سبع قراءات: قراءة العامة "تسعة عشر". وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن سليمان "تسعة عشر" بإسكان العين. وعن ابن عباس "تسعة عشر" بضم الهاء. وعن أنس بن مالك "تسعة وعشر" وعنه أيضا "تسعة وعشر". وعنه أيضا "تسعة أعشر" ذكرها المهدوي وقال: من قرأ "تسعة عشر" أسكن العين لتوالي الحركات. ومن قرأ "تسعة وعشر" جاء به على الأصل قبل التركيب، وعطف عشرا على تسعة، وحذف التنوين لكثرة الاستعمال، وأسكن الراء من عشر على نية السكوت عليها. ومن قرأ "تسعة عشر" فكأنه من التداخل؛ كأنه أراد العطف وترك التركيب، فرفع هاء التأنيث، ثم راجع البناء وأسكن. وأما "تسعة أعشر": فغير معروف، وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك "تسعة وعشر" لأنها محمولة على "تسعة أعشر" والواو بدل من الهمزة، وليس لذلك وجه عند النحويين. الزمخشري: وقرئ: "تسعة أعشر" جمع عشير، مثل يمين وأيمن.
قوله تعالى: "ليستيقن الذين أوتوا الكتاب" أي ليوقن الذين أعطوا التوراة والإنجيل أن عدة خزنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم. ثم يحتمل أنه يريد الذين آمنوا منهم كعبدالله بن سلام. ويحتمل أنه يريد الكل. ويزداد الذين آمنوا إيمانا" بذلك؛ لأنهم كلما صدقوا بما في كتاب الله آمنوا، ثم ازدادوا إيمانا لتصديقهم بعدد خزنة جهنم. "ولا يرتاب" أي ولا يشك "الذين أوتوا الكتاب" أي أعطوا الكتاب "والمؤمنون" أي المصدقون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر. "وليقول الذين في قلوبهم مرض" أي في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المدينة، الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة ولم يكن بمكة نفاق وإنما نجم بالمدينة. وقيل: المعنى؛ أي وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة. "والكافرون" أي اليهود والنصارى "ماذا أراد الله بهذا مثلا" يعني بعدد خزنة جهنم. وقال الحسين بن الفضل: السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه الآية الخلاف و"الكافرون" أي مشركو العرب. وعلى القول الأول أكثر المفسرين. ويجوز أن يراد بالمرض: الشك والارتياب؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين، وبعضهم قاطعين بالكذب وقوله تعالى إخبارا عنهم: "ماذا أراد الله" أي ما أراد "بهذا" العدد الذي ذكره حديثا، أي ما هذا من الحديث. قال الليث: المثل الحديث؛ ومنه: "مثل الجنة التي وعد المتقون" أي حديثها والخبر عنها "كذلك" أي كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم "يضل الله" أي يخزي ويعمي "من يشاء ويهدي" أي ويرشد "من يشاء" كإرشاد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: "كذلك يضل الله" عن الجنة "من يشاء ويهدي" إليها "من يشاء". "وما يعلم جنود ربك إلا هو" أي وما يدري عدد ملائكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار "إلا هو" أي إلا الله جل ثناؤه وهذا جواب لأبي جهل حين قال: أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر! وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم حنين، فأتاه جبريل فجلس عنده، فأتى ملك فقال: إن ربك يأمرك بكذا وكذا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شيطانا، فقال: (يا جبريل أتعرفه)؟ فقال: هو ملك وما كل ملائكة ربك أعرف. وقال الأوزاعي: قال موسى: "يا رب من في السماء؟ قال ملائكتي. قال كم عدتهم يا رب؟ قال: اثني عشر سبطا. قال: كم عدة كل سبط؟ قال: عدد التراب" ذكرهما الثعلبي. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا).
قوله تعالى: "وما هي إلا ذكرى للبشر" يعني الدلائل والحجج والقرآن. وقيل: "وما هي" أي وما هذه النار التي هي سقر "إلا ذكري" أي عظة "للبشر" أي للخلق. وقيل: نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة. قال الزجاج. وقيل: أي ما هذه العدة "إلا ذكري للبشر" أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله تعالى، وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار؛ فالكناية على هذا في قوله تعالى: "وما هي" ترجع إلى الجنود؛ لأنه أقرب مذكور.
الآية: 32 - 48 {كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون، عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين}
قوله تعالى: "كلا والقمر" قال الفراء: "كلا" صلة للقسم، التقدير أي والقمر. وقيل: المعنى حقا والقمر؛ فلا يوقف على هذين التقديرين على "كلا" وأجاز الطبري الوقف عليها، وجعلها ردا للذين زعموا أنهم يقاومون خزنة جهنم؛ أي ليس الأم كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النار. ثم أقسم على ذلك جل وعز بالقمر وبما بعده، فقال: "والليل إذا أدبر" أي ولى وكذلك "دبر". وقرأ نافع وحمزة وحفص "إذ أدبر" الباقون "إذا" بألف و"دبر" بغير ألف وهما لغتان بمعنى؛ يقال دبر وأدبر، وكذلك قبل الليل وأقبل. وقد قالوا: أمس الدابر والمدابر؛ قال صخر بن عمرو بن الشريد السلمي:
ولقد قتلناكم ثناء وموحدا وتركت مرة مثل أمس الدابر
ويروي المدبر. وهذا قول الفراء والأخفش.
وقال بعض أهل اللغة: دبر الليل: إذا مضى، وأدبر: أخذ في الإدبار. وقال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: "والليل إذا دبر" فسكت حتى إذا دبر قال: يا مجاهد، هذا حين دبر الليل. وقرأ محمد بن السميقع "والليل إذا أدبر" بألفين، وكذلك في مصحف عبدالله وأبي بألفين. وقال قطرب من قرأ "دبر" فيعني أقبل، من قول العرب دبر فلان: إذا جاء من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش. وقال ابن عباس في رواية عنه: الصواب: "أدبر"، إنما يدبر ظهر البعير. واختار أبو عبيد: "إذا أدبر" قال: لأنها أكثر موافقة للحروف التي تليه؛ ألا تراه يقول: "والصبح إذا أسفر"، فكيف يكون أحدهما "إذ" والآخر "إذا" وليس في القرآن قسم تعقبه "إذ" وإنما يتعقبه "إذا". ومعنى "أسفر": ضاء. وقراءة العامة "أسفر" بالألف. وقرأ ابن السميقع: "سفر". وهما لغتان. يقال: سفر وجه فلان وأسفر: إذا أضاء.
وفي الحديث: (أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر) أي صلوا صلاة الصبح مسفرين، ويقال: طولوها إلى الإسفار، والإسفار: الإنارة. وأسفر وجهه حسنا أي أشرق، وسفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر. ويجوز أن يكون (من) سفر الظلام أي كنسه، كما يسفر البيت، أي يكنس؛ ومنه السفير: لما سقط من ورق الشجر وتحات؛ يقال: إنما سمي سفيرا لأن الريح تسفره أي تكنسه. والمسفرة: المكنسة.
قوله تعالى: "إنها لإحدى الكبر" جواب القسم؛ أي إن هذه النار "لإحدى الكبر" أي لإحدى الدواهي. وفي تفسير مقاتل "الكبر": اسم من أسماء النار. وروي عن ابن عباس "إنها" أي إن تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم "لإحدى الكبر" أي لكبيرة من الكبائر. وقيل: أي إن قيام الساعة لإحدى الكبر. والكبر: هي العظائم من العقوبات؛ قال الراجز:
يا ابن المعلى نزلت إحدى الكبر داهية الدهر وصماء الغير
وواحدة (الكبر)، كبرى مثل الصغرى والصغر، والعظمى والعظم. وقرأ العامة (لإحدى) وهو اسم بني ابتداء للتأنيث، وليس مبنيا على المذكر؛ نحو عقبى وأخرى، وألفه ألف قطع، لا تذهب في الوصل. وروى جرير بن حازم عن ابن كثير "إنها لحدى الكبر" بحذف الهمزة. "نذيرا للبشر" يريد النار؛ أي أن هذه النار الموصوفة "نذيرا للبشر" فهو نصب على الحال من المضمر في "إنها" قال الزجاج. وذكر؛ لأن معناه معنى العذاب، أو أراد ذات إنذار على معنى النسب؛ كقولهم: امرأة طالق وطاهر. وقال الخليل: النذير: مصدر كالنكير، ولذلك يوصف به المؤنث. وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها. وقيل: المراد بالنذير محمد صلى الله عليه وسلم؛ أي قم نذيرا للبشر، أي مخوفا لهم "فنذيرا" حال من "قم" في أول السورة حين قال: "قم فأنذر" [المدثر: 2] قال أبو علي الفارسي وابن زيد، وروي عن ابن عباس وأنكره الفراء. ابن الأنباري: وقال بعض المفسرين معناه "يا أيها المدثر قم نذيرا للبشر". وهذا قبيح؛ لأن الكلام قد طال فيما بينهما. وقيل. هو من صفة الله تعالى. روى أبو معاوية الضرير: حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين "نذيرا للبشر" قال: يقول الله عز وجل: أنا لكم منها نذير فاتقوها. و(نذيرا) على هذا نصب على الحال؛ أي "وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة" منذرا بذلك البشر. وقيل: هو حال من "هو" في قوله تعالى: "وما يعلم جنود ربك إلا هو". وقيل: هو في موضع المصدر، كأنه قال: إنذار للبشر. قال الفراء: يجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار، أي أنذر إنذارا؛ فهو كقوله تعالى: "فكيف كان نذير" أي إنذاري؛ فعلى هذا يكون راجعا إلى أول السورة؛ أي (قم فأنذر) أي إنذارا. وقيل: هو منصوب بإضمار فعل. وقرأ ابن أبي عبلة "نذير" بالرفع على إضمار هو. وقيل: أي إن القرآن نذير للبشر، لما تضمنه من الوعد والوعيد.
قوله تعالى: "لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر" اللام متعلقة "بنذيرا"، أي نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير والطاعة، أو يتأخر إلى الشر والمعصية؛ نظيره: "ولقد علمنا المستقدمين منكم" [الحجر: 24] أي في الخير "ولقد علمنا المستأخرين" [الحجر: 24] عنه. قال الحسن: هذا وعيد وتهديد وإن خرج مخرج الخبر؛ كقوله تعالى: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" [الكهف: 29]. وقال بعض أهل التأويل: معناه لمن شاء الله أن يتقدم أو يتأخر، فالمشيئة متصلة بالله جل ثناؤه، والتقديم الإيمان، والتأخير الكفر. وكان ابن عباس يقول: هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم جوزي بثواب لا ينقطع، ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمدا صلى الله عليه وسلم عوقب عقابا لا ينقطع.
وقال السدي: "لمن شاء منكم أن يتقدم" إلى النار المتقدم ذكرها، "أو يتأخر" عنها إلى الجنة.
قوله تعالى: "كل نفس بما كسبت رهينة" أي مرتهنة بكسبها، مأخوذة بعملها، إما خلصها وإما أوبقها. وليست "رهينة" تأنيث رهين في قوله تعالى: "كل امرئ بما كسب رهين" [الطور: 21] لتأنيث النفس؛ لأنه لو قصدت الصفة لقيل رهين؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإنما هو اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم؛ كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهين؛ ومنه بيت الحماسة:
أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل
كأنه قال رهن رمس. والمعنى: كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك "إلا أصحاب اليمين" فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم. واختلف في تعيينهم؛ فقال ابن عباس: الملائكة. علي بن أبي طالب: أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم. الضحاك: الذين سبقت لهم من الله الحسنى، ونحوه عن ابن جريج؛ قال: كل نفس بعملها محاسبة "إلا أصحاب اليمين" وهم أهل الجنة، فإنهم لا يحاسبون. وكذا قال مقاتل أيضا: هم أصحاب الجنة الذين كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق حين قال الله لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقال الحسن وابن كيسان: هم المسلمون المخلصون ليسوا بمرتهنين؛ لأنهم أدوا ما كان عليهم. وعن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: هم المسلمون. وقيل: إلا أصحاب الحق وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين، وكل من أبغضنا أهل البيت فهم المرتهنون. وقال الحكم: هم الذين اختارهم الله لخدمته، فلم يدخلوا في الرهن، لأنهم خدام الله وصفوته وكسبهم لم يضرهم. وقال القاسم: كل نفس مأخوذة بكسبها من خير أو شر، إلا من اعتمد على الفضل والرحمة، دون الكسب والخدمة، فكل من اعتمد على الكسب فهو مرهون، وكل من اعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به. "في جنات" أي في بساتين "يتساءلون" أي يسألون "عن المجرمين" أي المشركين "ما سلككم" أي أدخلكم "في سقر" كما تقول: سلكت الخيط في كذا أي أدخلته فيه. قال الكلبي: فيسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمه، فيقول له: يا فلان. وفي قراءة عبدالله بن الزبير "يا فلان ما سلكك في سقر"؟ وعنه قال: قرأ عمر بن الخطاب "يا فلان ما سلككم في سقر" وهي قراءة على التفسير؛ لا أنها قرآن كما زعم من طعن في القرآن؛ قال أبو بكر بن الأنباري.
وقيل: إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم، فتسأل الملائكة المشركين فيقولون لهم: "ما سلككم في سقر". قال الفراء: في هذا ما يقوي أن أصحاب اليمين الولدان؛ لأنهم لا يعرفون الذنوب. "قالوا" يعني أهل النار "لم نك من المصلين" أي المؤمنين الذين يصلون. "ولم نك نطعم المسكين" أي لم نك نتصدق. "وكنا نخوض مع الخائضين" أي كنا نخالط أهل الباطل في باطلهم. وقال ابن زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم - لعنهم الله - كاهن، مجنون، شاعر، ساحر. وقال السدي: أي وكنا نكذب مع المكذبين. وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه. وقيل معناه: وكنا أتباعا ولم نكن متبوعين. "وكنا نكذب بيوم الدين" أي لم نك نصدق بيوم القيامة، يوم الجزاء والحكم. "حتى أتانا اليقين" أي جاءنا ونزل بنا الموت؛ ومنه قوله تعالى: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" [الحجر: 99].
قوله تعالى: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين؛ وذلك أن قوما من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم، ثم شفع فيهم، فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة، فأخرجوا من النار، وليس للكفار شفيع يشفع فيهم.
وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: يشفع نبيكم صلى الله عليه وسلم رابع أربعة: جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى أو عيسى، ثم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ويبقى قوم في جهنم، فيقال لهم: "ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين" إلى قوله: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" قال عبدالله بن مسعود: فهؤلاء هم الذين يبقون في جهنم؛ وقد ذكرنا إسناده في كتاب (التذكرة).
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 576
576- تفسير الصفحة رقم576 من المصحفالآية: 18 - 25 {إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر}
قوله تعالى: "إنه فكر وقدر" يعني الوليد فكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن و"قدر" أي هيأ الكلام في نفسه، والعرب تقول: قدرت الشيء إذا هيأته، وذلك أنه لما نزل: "حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم" [غافر: 1] إلى قوله: "إليه المصير" سمعه الوليد يقرؤها فقال: والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. فقالت قريش: صبا الوليد لتصبون قريش كلها. وكان يقال للوليد ريحانة قريش؛ فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فمضى إليه حزينا؟ فقال له: مالي أراك حزينا. فقال له: ومالي لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد، وتدخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهما؛ فغضب الوليد وتكبر، وقال: أنا أحتاج إلى كسر محمد وصاحبه، فأنتم تعرفون قدر مالي، واللات والعزى ما بي حاجة إلى ذلك، وإنما أنتم تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه قط يخنق؟ قالوا: لا والله، قال: وتزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا والله. قال: فتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا: لا والله. قال: فتزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط، ولقد رأينا للكهنة أسجاعا وتخالجا فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الصادق الأمين من كثرة صدقه. فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه، ثم نظر، ثم عبس، فقال ما هو إلا ساحر! أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فذلك قوله تعالى: "إنه فكر" أي في أمر محمد والقرآن "وقدر" في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما. "فقتل" أي لعن. وكان بعض أهل التأويل يقول: معناها فقهر وغلب، وكل مذلل مقتل؛ قال الشاعر:
وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتل
وقال الزهري: عذب؛ وهو من باب الدعاء. "كيف قدر" قال ناس: "كيف" تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجب من صنيعه: كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله: "انظر كيف ضربوا لك الأمثال" [الإسراء: 48]. "ثم قتل" أي لعن لعنا بعد لعن. وقيل: فقتل بضرب من العقوبة، ثم قتل بضرب آخر من العقوبة "كيف قدر" أي على أي حال قدر. "ثم نظر" بأي شيء يرد الحق ويدفعه. "ثم عبس" أي قطب بين عينيه في وجوه المؤمنين؛ وذلك أنه لما حمل قريشا على ما حملهم عليه من القول في محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، مر على جماعة من المسلمين، فدعوه إلى الإسلام، فعبس في وجوههم.. قيل: عبس وبسر على النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه. والعبس مخففا مصدر عبس يعبس عبسا وعبوسا: إذا قطب. والعبس ما يتعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ قال أبو النجم:
كأن في أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الأيل
قوله تعالى: "وبسر" أي كلح وجهه وتغير لونه؛ قال قتادة والسدي؛ ومنه قول بشر بن أبي خازم:
صبحنا تميما غداة الجفار بشهباء ملمومة باسره
وقال آخر:
وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها
وقيل: إن ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة، وظهور البسور في الوجه قبل المحاورة. وقال قوم: "بسر" وقف لا يتقدم ولا يتأخر. قالوا: وكذلك يقول أهل اليمن إذا وقف المركب، فلم يجيء ولم يذهب: قد بسر المركب، وأبسر أي وقف وقد أبسرنا. والعرب تقول: وجه باسر بين البسور: إذا تغير واسود. "ثم أدبر" أي ولى وأعرض ذاهبا إلى أهله. "واستكبر" أي تعظم عن أن يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان واستكبر حين دعي إليه. "فقال إن هذا" أي ما هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم "إلا سحر يؤثر" أي يأثره عن غيره. والسحر: الخديعة. وقد تقدم بيانه في سورة (البقرة). وقال قوم: السحر: إظهار الباطل في صورة الحق. والأثره: مصدر قولك: أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك؛ ومنه قيل: حديث مأثور: أي ينقله خلف عن سلف؛ قال امرؤ القيس:
ولو عن نثا غيره جاءني وجرح اللسان كجرح اليد
لقلت من القول ما لا يزا ل يؤثر عني يد المسند
يريد: آخر الدهر، وقال الأعشى:
إن الذي فيه تماريتما بين للسامع والآثر
ويروى: بين. "إن هذا إلا قول البشر" أي ما هذا إلا كلام المخلوقين، يختدع به القلوب كما تختدع بالسحر، قال السدي: يعنون أنه من قول سيار عبد لبني الحضرمي، كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك.
وقيل: أراد أنه تلقنه من أهل بابل. وقيل: عن مسيلمة. وقيل: عن عدي الحضرمي الكاهن. وقيل: إنما تلقنه ممن ادعى النبوة قبله، فنسج على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير: إن هذا إلا أمر سحر يؤثر؛ أي يورث.
الآية: 26 - 29 {سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر}
أي سأدخله سقر كي يصلى حرها. وإنما سميت سقر من سقرته الشمس: إذا أذابته ولوحته، وأحرقت جلدة وجهه. ولا ينصرف للتعريف والتأنيث. قال ابن عباس: هي الطبق السادس من جهنم. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [سأل موسى ربه فقال: أي رب، أي عبادك أفقر؟ قال صاحب سقر] ذكره الثعلبي: "وما أدراك ما سقر"؟ هذه مبالغة في وصفها؛ أي وما أعلمك أي شيء هي؟ وهي كلمة تعظيم، ثم فسر حالها فقال: "لا تبقي ولا تذر" أي لا تترك لهم عظما ولا لحما ولا دما إلا أحرقته. وقيل: لا تبقي منهم شيئا ثم يعادون خلقا جديدا، فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبدا. وقال مجاهد: لا تبقى من فيها حيا ولا تذره ميتا، تحرقهم كلما جددوا. وقال السدي: لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما "لواحة للبشر" أي مغيرة من لاحه إذا غيره. وقراءة العامة "لواحة" بالرفع نعت لـ "سقر" في قوله تعالى: "وما أدراك ما سقر". وقرأ عطية العوفي ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر "لواحة" بالنصب على الاختصاص، للتهويل. وقال أبو رزين: تلفح وجوههم لفحة تدعها أشد سوادا من الليل؛ وقاله مجاهد. والعرب تقول: لاحه البرد والحر والسقم والحزن: إذا غيره، ومنه قول الشاعر:
تقول ما لا حك يا مسافر يا ابنة عمي لاحني الهواجر
وقال آخر:
وتعجب هند أن رأتني شاحبا تقول لشيء لوحته السمائم
وقال رؤبة بن العجاج:
لوح منه بعد بدن وسنق تلويحك الضامر يطوى للسبق
وقيل: إن اللوح شدة العطش؛ يقال: لاحة العطش ولوحه أي غيره. والمعنى أنها معطشة للبشر أي لأهلها؛ قاله الأخفش؛ وأنشد:
سقتني على لوح من الماء شربة سقاها بها الله الرهام الغواديا
يعني باللوح شدة العطش، والتاح أي عطش، والرهام جمع رهمة بالكسر وهي المطرة الضعيفة وأرهمت السحابة أتت بالرهام. وقال ابن عباس: "لواحة" أي تلوح للبشر من مسيرة خمسمائة عام. الحسن وابن كيسان: تلوح لهم جهنم حتى يروها عيانا. نظيره: "وبرزت الجحيم للغاوين" [الشعراء: 91] وفي البشر وجهان: أحدهما: أنه الإنس من أهل النار؛ قاله الأخفش والأكثرون. الثاني: أنه جمع بشرة، وهي جلدة الإنسان الظاهرة؛ قال مجاهد وقتادة، وجمع البشر أبشار، وهذا على التفسير الأول، وأما على تفسير ابن عباس فلا يستقيم فيه إلا الناس لا الجلود؛ لأنه من لاح الشيء يلوح، إذا لمع.
الآية: 30 - 31 {عليها تسعة عشر، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر}
قوله تعالى: "عليها تسعة عشر" أي على سقر تسعه عشر من الملائكة يلقون فيها أهلها. ثم قيل: على جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتها؛ مالك وثمانية عشر ملكا. ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيبا، ويحتمل أن يكون تسعة عشر ملكا بأعيانهم. وعلى هذا أكثر المفسرين. الثعلبي: ولا ينكر هذا، فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق. وقال ابن جريج: نعت النبي صلى الله عليه وسلم خزنة جهنم فقال: [فكأن أعينهم البرق، وكأن أفواههم الصياصي، يجرون أشعارهم، لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين، يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل، فيرميهم في النار، ويرمي فوقهم الجبل].
قلت: وذكر ابن المبارك قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن رجل من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام، فقرأ هذه الآية: "وما أدراك ما سقر. لا تبقى ولا تذر. لواحة للبشر. عليها تسعة عشر" فقال ما تسعة عشر؟ تسعة عشر ألف ملك، أو تسعة عشر ملكا؟ قال: قلت: لا بل تسعة عشر ملكا. فقال: وأنى تعلم ذلك؟ فقلت: لقول الله عز وجل: "وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا" قال: صدقت هم تسعة عشر ملكا، بيد كل ملك منهم مرزبة لها شعبتان، فيضرب الضربة فيهوي بها في النار سبعين ألفا. وعن عمرو بن دينار: كل واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر. خرج الترمذي عن جابر بن عبدالله. قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد غلب أصحابك اليوم؛ فقال: (وماذا غلبوا)؟ قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال: (فماذا قالوا) قال: قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا. قال: (أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون، فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا؟ لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا الله جهرة، علي بأعداء الله! إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك). فلما جاؤوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: (هكذا وهكذا) في مرة عشرة وفي مرة تسعة. قالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (ما تربة الجنة) قال: فسكتوا هنيهة ثم قالوا: أخبزة يا أبا القاسم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخبز من الدرمك). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر. وذكر ابن وهب قال: حدثنا عبدالرحمن بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزنة جهنم: [ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب].
وقال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم.
قلت: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر، هم الرؤساء والنقباء، وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها؛ كما قال الله تعالى: "وما يعلم جنود ربك إلا هو" وقد ثبت في الصحيح عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها). وقال ابن عباس وقتادة والضحاك: لما نزل: "عليها تسعة عشر" قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم! أسمع بن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم تسعة عشر، وأنتم الدهم - أي العدد - والشجعان، فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم! قال السدي: فقال أبو الأسود بن كلدة الجمحي: لا يهولنكم التسعة عشر، أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة، وبمنكبي الأيسر التسعة، ثم تمرون إلى الجنة؛ يقولها مستهزئا. في رواية: أن الحرث بن كلدة قال أنا أكفيكم سبعة عشر، واكفوني أنتم اثنين. وقيل: إن أبا جهل قال أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم، ثم تخرجون من النار؟ فنزل قوله تعالى: "وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة" أي لم نجعلهم رجالا فتتعاطون مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المعذبين من الجن والإنس، فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة، ولا يستروحون إليهم؛ ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له، فتؤمن هوادتهم؛ ولأنهم أشد خلق الله بأسا وأقواهم بطشا. "وما جعلنا عدتهم إلا فتنة" أي بلية. وروي عن ابن عباس من غير وجه قال: ضلالة للذين كفروا، يريد أبا جهل وذويه. وقيل: إلا عذابا، كما قال تعالى: "يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم" [الذاريات: 14]. أي جعلنا ذلك سبب كفرهم وسبب العذاب. وفي "تسعة عشر" سبع قراءات: قراءة العامة "تسعة عشر". وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن سليمان "تسعة عشر" بإسكان العين. وعن ابن عباس "تسعة عشر" بضم الهاء. وعن أنس بن مالك "تسعة وعشر" وعنه أيضا "تسعة وعشر". وعنه أيضا "تسعة أعشر" ذكرها المهدوي وقال: من قرأ "تسعة عشر" أسكن العين لتوالي الحركات. ومن قرأ "تسعة وعشر" جاء به على الأصل قبل التركيب، وعطف عشرا على تسعة، وحذف التنوين لكثرة الاستعمال، وأسكن الراء من عشر على نية السكوت عليها. ومن قرأ "تسعة عشر" فكأنه من التداخل؛ كأنه أراد العطف وترك التركيب، فرفع هاء التأنيث، ثم راجع البناء وأسكن. وأما "تسعة أعشر": فغير معروف، وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك "تسعة وعشر" لأنها محمولة على "تسعة أعشر" والواو بدل من الهمزة، وليس لذلك وجه عند النحويين. الزمخشري: وقرئ: "تسعة أعشر" جمع عشير، مثل يمين وأيمن.
قوله تعالى: "ليستيقن الذين أوتوا الكتاب" أي ليوقن الذين أعطوا التوراة والإنجيل أن عدة خزنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم. ثم يحتمل أنه يريد الذين آمنوا منهم كعبدالله بن سلام. ويحتمل أنه يريد الكل. ويزداد الذين آمنوا إيمانا" بذلك؛ لأنهم كلما صدقوا بما في كتاب الله آمنوا، ثم ازدادوا إيمانا لتصديقهم بعدد خزنة جهنم. "ولا يرتاب" أي ولا يشك "الذين أوتوا الكتاب" أي أعطوا الكتاب "والمؤمنون" أي المصدقون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر. "وليقول الذين في قلوبهم مرض" أي في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المدينة، الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة ولم يكن بمكة نفاق وإنما نجم بالمدينة. وقيل: المعنى؛ أي وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة. "والكافرون" أي اليهود والنصارى "ماذا أراد الله بهذا مثلا" يعني بعدد خزنة جهنم. وقال الحسين بن الفضل: السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه الآية الخلاف و"الكافرون" أي مشركو العرب. وعلى القول الأول أكثر المفسرين. ويجوز أن يراد بالمرض: الشك والارتياب؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين، وبعضهم قاطعين بالكذب وقوله تعالى إخبارا عنهم: "ماذا أراد الله" أي ما أراد "بهذا" العدد الذي ذكره حديثا، أي ما هذا من الحديث. قال الليث: المثل الحديث؛ ومنه: "مثل الجنة التي وعد المتقون" أي حديثها والخبر عنها "كذلك" أي كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم "يضل الله" أي يخزي ويعمي "من يشاء ويهدي" أي ويرشد "من يشاء" كإرشاد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: "كذلك يضل الله" عن الجنة "من يشاء ويهدي" إليها "من يشاء". "وما يعلم جنود ربك إلا هو" أي وما يدري عدد ملائكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار "إلا هو" أي إلا الله جل ثناؤه وهذا جواب لأبي جهل حين قال: أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر! وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم حنين، فأتاه جبريل فجلس عنده، فأتى ملك فقال: إن ربك يأمرك بكذا وكذا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شيطانا، فقال: (يا جبريل أتعرفه)؟ فقال: هو ملك وما كل ملائكة ربك أعرف. وقال الأوزاعي: قال موسى: "يا رب من في السماء؟ قال ملائكتي. قال كم عدتهم يا رب؟ قال: اثني عشر سبطا. قال: كم عدة كل سبط؟ قال: عدد التراب" ذكرهما الثعلبي. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا).
قوله تعالى: "وما هي إلا ذكرى للبشر" يعني الدلائل والحجج والقرآن. وقيل: "وما هي" أي وما هذه النار التي هي سقر "إلا ذكري" أي عظة "للبشر" أي للخلق. وقيل: نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة. قال الزجاج. وقيل: أي ما هذه العدة "إلا ذكري للبشر" أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله تعالى، وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار؛ فالكناية على هذا في قوله تعالى: "وما هي" ترجع إلى الجنود؛ لأنه أقرب مذكور.
الآية: 32 - 48 {كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون، عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين}
قوله تعالى: "كلا والقمر" قال الفراء: "كلا" صلة للقسم، التقدير أي والقمر. وقيل: المعنى حقا والقمر؛ فلا يوقف على هذين التقديرين على "كلا" وأجاز الطبري الوقف عليها، وجعلها ردا للذين زعموا أنهم يقاومون خزنة جهنم؛ أي ليس الأم كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النار. ثم أقسم على ذلك جل وعز بالقمر وبما بعده، فقال: "والليل إذا أدبر" أي ولى وكذلك "دبر". وقرأ نافع وحمزة وحفص "إذ أدبر" الباقون "إذا" بألف و"دبر" بغير ألف وهما لغتان بمعنى؛ يقال دبر وأدبر، وكذلك قبل الليل وأقبل. وقد قالوا: أمس الدابر والمدابر؛ قال صخر بن عمرو بن الشريد السلمي:
ولقد قتلناكم ثناء وموحدا وتركت مرة مثل أمس الدابر
ويروي المدبر. وهذا قول الفراء والأخفش.
وقال بعض أهل اللغة: دبر الليل: إذا مضى، وأدبر: أخذ في الإدبار. وقال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: "والليل إذا دبر" فسكت حتى إذا دبر قال: يا مجاهد، هذا حين دبر الليل. وقرأ محمد بن السميقع "والليل إذا أدبر" بألفين، وكذلك في مصحف عبدالله وأبي بألفين. وقال قطرب من قرأ "دبر" فيعني أقبل، من قول العرب دبر فلان: إذا جاء من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش. وقال ابن عباس في رواية عنه: الصواب: "أدبر"، إنما يدبر ظهر البعير. واختار أبو عبيد: "إذا أدبر" قال: لأنها أكثر موافقة للحروف التي تليه؛ ألا تراه يقول: "والصبح إذا أسفر"، فكيف يكون أحدهما "إذ" والآخر "إذا" وليس في القرآن قسم تعقبه "إذ" وإنما يتعقبه "إذا". ومعنى "أسفر": ضاء. وقراءة العامة "أسفر" بالألف. وقرأ ابن السميقع: "سفر". وهما لغتان. يقال: سفر وجه فلان وأسفر: إذا أضاء.
وفي الحديث: (أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر) أي صلوا صلاة الصبح مسفرين، ويقال: طولوها إلى الإسفار، والإسفار: الإنارة. وأسفر وجهه حسنا أي أشرق، وسفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر. ويجوز أن يكون (من) سفر الظلام أي كنسه، كما يسفر البيت، أي يكنس؛ ومنه السفير: لما سقط من ورق الشجر وتحات؛ يقال: إنما سمي سفيرا لأن الريح تسفره أي تكنسه. والمسفرة: المكنسة.
قوله تعالى: "إنها لإحدى الكبر" جواب القسم؛ أي إن هذه النار "لإحدى الكبر" أي لإحدى الدواهي. وفي تفسير مقاتل "الكبر": اسم من أسماء النار. وروي عن ابن عباس "إنها" أي إن تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم "لإحدى الكبر" أي لكبيرة من الكبائر. وقيل: أي إن قيام الساعة لإحدى الكبر. والكبر: هي العظائم من العقوبات؛ قال الراجز:
يا ابن المعلى نزلت إحدى الكبر داهية الدهر وصماء الغير
وواحدة (الكبر)، كبرى مثل الصغرى والصغر، والعظمى والعظم. وقرأ العامة (لإحدى) وهو اسم بني ابتداء للتأنيث، وليس مبنيا على المذكر؛ نحو عقبى وأخرى، وألفه ألف قطع، لا تذهب في الوصل. وروى جرير بن حازم عن ابن كثير "إنها لحدى الكبر" بحذف الهمزة. "نذيرا للبشر" يريد النار؛ أي أن هذه النار الموصوفة "نذيرا للبشر" فهو نصب على الحال من المضمر في "إنها" قال الزجاج. وذكر؛ لأن معناه معنى العذاب، أو أراد ذات إنذار على معنى النسب؛ كقولهم: امرأة طالق وطاهر. وقال الخليل: النذير: مصدر كالنكير، ولذلك يوصف به المؤنث. وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها. وقيل: المراد بالنذير محمد صلى الله عليه وسلم؛ أي قم نذيرا للبشر، أي مخوفا لهم "فنذيرا" حال من "قم" في أول السورة حين قال: "قم فأنذر" [المدثر: 2] قال أبو علي الفارسي وابن زيد، وروي عن ابن عباس وأنكره الفراء. ابن الأنباري: وقال بعض المفسرين معناه "يا أيها المدثر قم نذيرا للبشر". وهذا قبيح؛ لأن الكلام قد طال فيما بينهما. وقيل. هو من صفة الله تعالى. روى أبو معاوية الضرير: حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين "نذيرا للبشر" قال: يقول الله عز وجل: أنا لكم منها نذير فاتقوها. و(نذيرا) على هذا نصب على الحال؛ أي "وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة" منذرا بذلك البشر. وقيل: هو حال من "هو" في قوله تعالى: "وما يعلم جنود ربك إلا هو". وقيل: هو في موضع المصدر، كأنه قال: إنذار للبشر. قال الفراء: يجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار، أي أنذر إنذارا؛ فهو كقوله تعالى: "فكيف كان نذير" أي إنذاري؛ فعلى هذا يكون راجعا إلى أول السورة؛ أي (قم فأنذر) أي إنذارا. وقيل: هو منصوب بإضمار فعل. وقرأ ابن أبي عبلة "نذير" بالرفع على إضمار هو. وقيل: أي إن القرآن نذير للبشر، لما تضمنه من الوعد والوعيد.
قوله تعالى: "لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر" اللام متعلقة "بنذيرا"، أي نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير والطاعة، أو يتأخر إلى الشر والمعصية؛ نظيره: "ولقد علمنا المستقدمين منكم" [الحجر: 24] أي في الخير "ولقد علمنا المستأخرين" [الحجر: 24] عنه. قال الحسن: هذا وعيد وتهديد وإن خرج مخرج الخبر؛ كقوله تعالى: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" [الكهف: 29]. وقال بعض أهل التأويل: معناه لمن شاء الله أن يتقدم أو يتأخر، فالمشيئة متصلة بالله جل ثناؤه، والتقديم الإيمان، والتأخير الكفر. وكان ابن عباس يقول: هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم جوزي بثواب لا ينقطع، ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمدا صلى الله عليه وسلم عوقب عقابا لا ينقطع.
وقال السدي: "لمن شاء منكم أن يتقدم" إلى النار المتقدم ذكرها، "أو يتأخر" عنها إلى الجنة.
قوله تعالى: "كل نفس بما كسبت رهينة" أي مرتهنة بكسبها، مأخوذة بعملها، إما خلصها وإما أوبقها. وليست "رهينة" تأنيث رهين في قوله تعالى: "كل امرئ بما كسب رهين" [الطور: 21] لتأنيث النفس؛ لأنه لو قصدت الصفة لقيل رهين؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإنما هو اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم؛ كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهين؛ ومنه بيت الحماسة:
أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل
كأنه قال رهن رمس. والمعنى: كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك "إلا أصحاب اليمين" فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم. واختلف في تعيينهم؛ فقال ابن عباس: الملائكة. علي بن أبي طالب: أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم. الضحاك: الذين سبقت لهم من الله الحسنى، ونحوه عن ابن جريج؛ قال: كل نفس بعملها محاسبة "إلا أصحاب اليمين" وهم أهل الجنة، فإنهم لا يحاسبون. وكذا قال مقاتل أيضا: هم أصحاب الجنة الذين كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق حين قال الله لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقال الحسن وابن كيسان: هم المسلمون المخلصون ليسوا بمرتهنين؛ لأنهم أدوا ما كان عليهم. وعن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: هم المسلمون. وقيل: إلا أصحاب الحق وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين، وكل من أبغضنا أهل البيت فهم المرتهنون. وقال الحكم: هم الذين اختارهم الله لخدمته، فلم يدخلوا في الرهن، لأنهم خدام الله وصفوته وكسبهم لم يضرهم. وقال القاسم: كل نفس مأخوذة بكسبها من خير أو شر، إلا من اعتمد على الفضل والرحمة، دون الكسب والخدمة، فكل من اعتمد على الكسب فهو مرهون، وكل من اعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به. "في جنات" أي في بساتين "يتساءلون" أي يسألون "عن المجرمين" أي المشركين "ما سلككم" أي أدخلكم "في سقر" كما تقول: سلكت الخيط في كذا أي أدخلته فيه. قال الكلبي: فيسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمه، فيقول له: يا فلان. وفي قراءة عبدالله بن الزبير "يا فلان ما سلكك في سقر"؟ وعنه قال: قرأ عمر بن الخطاب "يا فلان ما سلككم في سقر" وهي قراءة على التفسير؛ لا أنها قرآن كما زعم من طعن في القرآن؛ قال أبو بكر بن الأنباري.
وقيل: إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم، فتسأل الملائكة المشركين فيقولون لهم: "ما سلككم في سقر". قال الفراء: في هذا ما يقوي أن أصحاب اليمين الولدان؛ لأنهم لا يعرفون الذنوب. "قالوا" يعني أهل النار "لم نك من المصلين" أي المؤمنين الذين يصلون. "ولم نك نطعم المسكين" أي لم نك نتصدق. "وكنا نخوض مع الخائضين" أي كنا نخالط أهل الباطل في باطلهم. وقال ابن زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم - لعنهم الله - كاهن، مجنون، شاعر، ساحر. وقال السدي: أي وكنا نكذب مع المكذبين. وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه. وقيل معناه: وكنا أتباعا ولم نكن متبوعين. "وكنا نكذب بيوم الدين" أي لم نك نصدق بيوم القيامة، يوم الجزاء والحكم. "حتى أتانا اليقين" أي جاءنا ونزل بنا الموت؛ ومنه قوله تعالى: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" [الحجر: 99].
قوله تعالى: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين؛ وذلك أن قوما من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم، ثم شفع فيهم، فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة، فأخرجوا من النار، وليس للكفار شفيع يشفع فيهم.
وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: يشفع نبيكم صلى الله عليه وسلم رابع أربعة: جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى أو عيسى، ثم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ويبقى قوم في جهنم، فيقال لهم: "ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين" إلى قوله: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" قال عبدالله بن مسعود: فهؤلاء هم الذين يبقون في جهنم؛ وقد ذكرنا إسناده في كتاب (التذكرة).










الصفحة رقم 576 من المصحف تحميل و استماع mp3