سورة النساء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
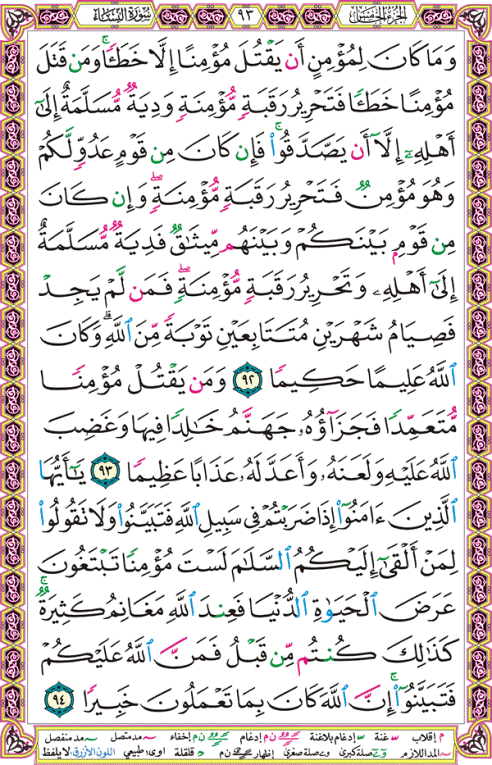
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 93 من المصحف
الآية: 92 {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيم}
قوله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ" هذه آية من أمهات الأحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؛ فقوله: "وما كان "ليس على النفي وإنما هو على التحريم والنهي، كقوله: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله "[الأحزاب:53] ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط؛ لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده، كقوله تعالى: "ما كان لكم أن تنبتوا شجرها "[النمل:60]. فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا. وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك في عهد الله. وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف، كما ليس له الآن ذلك بوجه، ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الأول وهو الذي يكون فيه "إلا "بمعنى "لكن "والتقدير ما كان له أن يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا قول سيبويه والزجاج رحمهما الله. ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى: "ما لهم به من علم إلا اتباع الظن "[النساء:157]: وقال النابغة:
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد
إلا الأواري لأيا ما أبينها والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد
فلما لم تكن "الأواري "من جنس أحد حقيقة لم تدخل في لفظه. ومثله قول الآخر:
أمسى سقام خلاء لا أنيس به إلا السباع ومر الريح بالغرف
وقال آخر:
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس
وقال آخر:
وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعذ من النخل
أنشده سيبويه؛ ومثله كثير، ومن أبدعه قول جرير:
من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ذيل مرط مرحل
كأنه قال: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد. ونزلت الآية بسبب قتل عياش بن أبي ربيعة الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة العامري لحنة كانت بينهما، فلما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله ولم يشعر بإسلامه، فلما أخبر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، ولم أشعر بإسلامه حتى قتلته فنزلت الآية. وقيل: هو استثناء متصل، أي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه إلا أن يكون خطأ؛ فلا يقتص منه؛ ولكن فيه كذا وكذا. ووجه آخر وهو أن يقدر كان بمعنى استقر ووجد؛ كأنه قال: وما وجد وما تقرر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحيانا؛ فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد وبشاعة شأنه؛ كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسيا ؟ إعظاما للعمد والقصد مع حظر الكلام به البتة. وقيل: المعنى ولا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز أن تكون "إلا" بمعنى الواو، ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى؛ لأن الخطأ لا يحظر. ولا يفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم فإن المسلم محترم الدم، وإنما خص المؤمن بالذكر تأكيدا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته. وقرأ الأعمش "خطاء "ممدودا في المواضع الثلاثة. ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى يربطها عدم القصد؛ مثل أن يرمي صفوف المشركين فيصيب مسلما. أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان أو محارب أو مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض فيصيب إنسانا أو ما جرى مجراه؛ وهذا مما لا خلاف فيه. والخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا لم يصنع عن تعمد؛ فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن أراد شيئا ففعل غير: أخطأ، ولمن فعل غير الصواب: أخطأ. قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ "إلى قوله تعالى: "ودية مسلمة إلى أهله "فحكم الله جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية، وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به.
ذهب داود إلى القصاص بين الحر والعبد في النفس، وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسكا بقوله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس "[المائدة: 45] إلى قوله تعالى: "والجروح قصاص "[المائدة: 45]، وقوله عليه السلام: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ) فلم يفرق بين حر وعبد؛ وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيقتل الحر بالعبد، كما يقتل العبد بالحر، ولا قصاص بينهما في شيء من الجراح والأعضاء. وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ" أنه لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله عليه السلام: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ) أريد به الأحرار خاصة. والجمهور على ذلك وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس فالنفس أحرى بذلك؛ وقد مضى هذا في "البقرة".
قوله تعالى: "فتحرير رقبة مؤمنة" أي فعليه تحرير رقبة؛ هذه الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضا على ما يأتي. واختلف العلماء فيما يجزئ منها، فقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلت الإيمان، لا تجزئ في ذلك الصغيرة، وهو الصحيح في هذا الباب قال عطاء بن أبي رباح: يجزئ الصغير المولود بين مسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزئ كل من حكم له بحكم في الصلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: من صلى وصام أحب إلي. ولا يجزئ في قول كافة العلماء أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلهما، ويجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعور. قال مالك: إلا أن يكون عرجا شديدا. ولا يجزئ عند مالك والشافعي وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ويجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم المجنون المطبق ولا يجزئ عند مالك الذي يجن ويفيق، ويجزئ عند الشافعي. ولا يجزئ عند مالك المعتق إلى سنين، ويجزئ عند الشافعي. ولا يجزئ المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، ويجزئ في قول الشافعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. وقال مالك: لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعالى: "فتحرير رقبة". ومن أعتق البعض لا يقال حرر رقبة وإنما حرر بعضها. واختلفوا أيضا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل، وذنه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. وقيل: أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من أمر العبودية صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا ما يتميز به عن البهائم والدواب، ويرتجى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرنا، والمعنى الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارة. وأي واحد من هذين المعنيين كان، ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله، بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه، على ما يأتي بيانه، والله أعلم.
قوله تعالى: "ودية مسلمة" الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه. "مسلمة" مدفوعة مؤداة، ولم يعين الله في كتابه ما يعطى في الدية، وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل، وإنما أخذ ذلك من السنة، ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات، والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظا، ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة محضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه. وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية مائة من الإبل، ووداها صلى الله عليه وسلم في عبدالله بن سهل المقتول بخيبر لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن، فكان ذلك بيانا على لسان نبيه عليه السلام لمجمل كتابه. وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل مائة من الإبل واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفة: على أهل الذهب ألف دينار، وهم أهل الشام ومصر والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه، في القديم. وروي هذا عن عمر وعروة بن الزبير وقتادة. وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم، وهم أهل العراق وفارس وخراسان؛ هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقال المزني: قال الشافعي الدية الإبل؛ فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قومها عمر، ألف دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق. وقال أبو حنيفة (أصحابه والثوري: الدية من الورق عشرة آلاف درهم. رواه الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألف شاة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهر من الحديث عن عثمان وعلي وابن عباس. وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر في البقر والشاء والحلل. وبه قال عطاء وطاوس وطائفة من التابعين، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الشافعي وبه قال طاوس. قال ابن المنذر: دية الحر المسلم مائة من الإبل في كل زمان، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه في أعداد الدراهم وما منها شيء يصح عنه لأنها مراسيل، وقد عرفتك مذهب الشافعي وبه ونقول.
واختلف الفقهاء في أسنان دية الإبل؛ فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشر بني لبون. قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء، وإنما قال أكثر العلماء: دية الخطأ أخماس. كذا قال أصحاب الرأي والثوري، وكذلك مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا في الأصناف؛ قال أصحاب الرأي وأحمد: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع. وروي هذا القول عن ابن مسعود. وقال مالك والشافعي: خمس حقاق، وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والليث بن سعد. قال الخطابي: ولأصحاب الرأي فيه أثر، إلا أن راويه عبدالله بن خشف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وعدل الشافعي عن القول به. لما ذكرنا من العلة في راويه، ولأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر مائة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. قال أبو عمر: وقد روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا، إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفي الطائي وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الطائي الجشمي من بني جشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين.
قلت: قد ذكر الدارقطني في سننه حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبدالله بن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ مائة من الإبل؛ منها عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض. قال الدارقطني: "هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة؛ أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه، الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبدالله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه؛ هذا لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني؛ ثم بلغه بعه ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا شديدا لم يروه فرح مثله، لموافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هذه صفته وهذا حال فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويخالفه. ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهورا، أو رجلا قد ارتفع عنه اسم الجهالة، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا؛ فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره. والله أعلم.
ووجه آخر: وهو أن حديث خشف بن مالك لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا الحجاج بن أرطأة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه، وكفاك بهم علما بالرجل ونبلا. وقال يحيى بن معين: حجاج بن أرطأة لا يحتج بحديثه. وقال عبدالله بن إدريس: سمعت الحجاج يقول لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة. وقال عيسى بن يونس: سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون. وقال جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. وذكر أوجها أخر؛ منها أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه. إلى غير ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدية، وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره على ما يأتي. وروى حماد بن سلمة حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور. قال الدارقطني: هذا إسناد حسن ورواته ثقات، وقد روي عن علقمة عن عبدالله نحو هذا.
قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الدية تكون مخمسة. قال الخطابي: وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع؛ وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ إلا أنهم قالوا: خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب. قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعي فروي عن سليمان بن يسار وليس فيه عن صحابي شيء؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب.
قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعي. قال أبو عمر: وأسنان الإبل في الدبات لم تؤخذ قياسا ولا نظرا، وإنما أخذت اتباعا وتسليما، وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر؛ فكل يقول بما قد صح عنده من سلفه؛ رضي الله عنهم أجمعين.
قلت: وأما ما حكاه الخطابي من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهد، إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت مخاض ثلاثين جذعة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبدالله وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدارقطني والخطابي، وابن عبدالبر قال: لأنه الأقل مما قيل؛ وبحديث. مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق هذا القول.
قلت: وعجبا لابن المنذر ؟ مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقد على صحته ! لكن الذهول والنسيان قد يعتري الإنسان، وإنما الكمال لعزة ذي الجلال.
ثبتت الأخبار عن النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه: (إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ) العمد دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث؛ والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا، ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما دون الثلث في مال الجاني. وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد. في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول الشافعي.
وحكمها أن تكون منجمة على العاقلة، والعاقلة العصبة. وليس ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلة. ولا الإخوة من الأم بعصبة لإخوتهم من الأب والأم، فلا يعقلون عنهم شيئا. وكذلك الديوان لا يكون عاقلة في قول جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان؛ فتنجم الدية على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاه عمر وعلي؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضر به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا. ومنها أنه كان يعجلها تأليفا. فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربي. وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل الديوان. واتفق الفقهاء عل رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو.
قلت: ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قتل الجنين في بطن أمه؛ وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه الدية كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة. وقيل: بغير قسامة. واختلفوا فيما به تعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضع أو تنفس نفسا محققة حي، فيه الدية كاملة؛ فإن تحرك فقال الشافعي وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته. وقال مالك: لا، إلا أن يقارنها طول إقامة. والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء. فإن ألقته ميتا ففيه غرة: عبد أو وليدة. فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه. وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. وروي عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها: ففيه الغرة، وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا خرج ميتا من بطنها بعد موتها. قال الطحاوي محتجا لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موتها.
ولا تكون الغرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في الجنين غرة عبد أو أمة ) - لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى لقال: في الجنين عبد أو أمة، ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل في الدية إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء، لا يقبل فيها أسود ولا سوداء. واختلف العلماء في قيمتها؛ فقال مالك: تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم؛ نصف عشر دية الحر المسلم، وعشر دية أمه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسمائة درهم. وقال الشافعي: سن الغرة سبع سنين أو ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها معيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم، من الذهب عشرون دينارا إن كانوا أهل ذهب، ومن الورق - إن كانوا أهل ورق - ستمائة درهم، أو خمس فرائض من الإبل. قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حي. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، هي على العاقلة. وهو أصح؛ لحديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار - في رواية فتغايرتا - فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان فقالا: ندي من لا صاح ولا أكل، ولا شرب ولا استهل. فمثل ذلك يطل !، فقال: (أسجع كسجع الأعراب ) ؟ فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة. وهو حديث ثابت صحيح، نص في موضع الخلاف يوجب الحكم. ولما كانت دية المرأة المضروبة على العاقلة كان الجنين كذلك في القياس والنظر. واحتج علماؤنا بقول الذي قضي عليه: كيف أغرم ؟ قالوا: وهذا يدل على أن الذي قضي عليه معين وهو الجاني. ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة لقال: فقال الذي قضى عليهم. وفي القياس أن كل جان جنايته عليه، إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض له؛ مثل إجماع لا يجوز خلافه، أو نص سنة من جهة نقل الآحاد العدول لا معارض لها، فيجب الحكم بها، وقد قال الله تعالى: "ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى" [الأنعام: 164].
ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا؛ فقال مالك: فيه الغرة والكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعي: فيه الغرة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرة عن الجنين؛ فقال مالك والشافعي وأصحابهما: الغرة في الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها دية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة للأم وحدها؛ لأنها جناية جنى عليها بقطع عضو من أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على ذلك أنه لم يعتبر فيه الذكر والأنثى كما يلزم في الديات، فدل على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هرمز يقول: ديته لأبويه خاصة؛ لأبيه ثلثاها ولأمه ثلثها، من كان منهما حيا كان ذلك له، فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي منهما أبا كان أو أما، ولا يرث الإخوة شيئا.
قوله تعالى: "إلا أن يصدقوا" أصله "أن يتصدقوا "فأدغمت التاء في الصاد. والتصدق الإعطاء؛ يعني إلا أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول القاتلين مما أوجب لهم من الدية عليهم. فهو استثناء ليس من الأول. وقرأ أبو عبدالرحمن ونبيح "إلا أن تصدقوا "بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك قرأ أبو عمرو، إلا أنه شدد الصاد. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية، ولا يجوز حذفها على قراءة الياء. وفي حرف أبي وابن مسعود "إلا أن يتصدقوا". وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه وإنما تسقط الدية التي هي حق لهم. وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تتحمل.
قوله تعالى: "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن" هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعي: فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد أمن وبقي في قومه وهم كفرة "عدو لكم "فلا دية فيه؛ وإنما كفارته تحرير. الرقبة. وهو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة. وسقطت الدية لوجهين: أحدهما: أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بها. والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة، فلا دية؛ لقوله تعالى: "والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا "[الأنفال: 72]. وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط؛ فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية فيه، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. هذا قول الشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة.
قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله؛ فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقال لا إله إلا الله وقتلته ) ! قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح؛ قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ ). فلم يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بقصاص ولا دية. وروي عن أسامة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي بعد ثلاث مرات، وقال: (أعتق رقبة ) ولم يحكم بقصاص ولا دية. فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدوانا؛ وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة: الأول: لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا كالخاتن والطبيب. الثاني: لكونه من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديته؛ لقوله تعالى: "فإن كان من قوم عدو لكم "كما ذكرنا. الثالث: أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافا، ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعلم.
قوله تعالى: "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق" هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي. واختاره الطبري قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية. وقرأها الحسن: "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن". قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه. قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ "ثم قال تعالى: "وإن كان من قوم" يريد ذلك المؤمن. والله أعلم. قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد.
قلت: وهذا معنى ما قال الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. وقوله "فدية مسلمة "على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه السلام عهد على أن يسلموا أو يؤذنوا بحرب إلى أجل معلوم: فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة ثم نسخ بقوله تعالى: "براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين "[التوبة: 1].
وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال أبو عمر: إنما صارت ديتها - والله أعلم - على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: "النفس بالنفس "[المائدة: 45]. و"الحر بالحر "كما تقدم في "البقرة".
روى الدارقطني من حديث موسى بن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت أبي يقول إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول:
يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا مما كلاهما تكسرا
وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير؛ فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. وقد اختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما؛ فروي عن ابن الزبير: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى. وهذا قول شريح والنخعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه. حتى سقطا وماتا: على عاقلة الذي جبذه الدية. قال أبو عمر: ما أظن في هذا خلافا - والله أعلم - إلا ما قال بعض المتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعي: يضمن نصف الدية؛ لأنه مات من فعله، ومن سقوط الساقط عليه. وقال الحكم وابن شبرمة: إن سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهما، قالا: يضمن الحي منهما. وقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر. وقال في الفارسين إذا اصطدما فماتا: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه؛ وقال عثمان البتي وزفر. وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسين يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. قال ابن خويز منداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن النوتي صرف السفينة ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين والفارسين. على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا.
واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب؛ فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ودية نسائهم على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن شعيب وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم. وعبدالرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيضا. وقال ابن عباس والشعبي والنخعي: المقتول من أهل العهد خطأ لا تبالي مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فيه الدية كدية المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي؛ جعلوا الديات كلها سواء، المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي، وهو قول عطاء والزهري وسعيد بن المسيب. وحجتهم قوله تعالى: "فدية "وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المسلم. وعضدوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة بني قريظة والنضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ديتهم سواء دية كاملة. قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة. وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم؛ وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عمر وعثمان، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار وأبو ثور وإسحاق.
قوله تعالى: "فمن لم يجد" أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها. "فصيام شهرين" أي فعليه صيام شهرين. "متتابعين "حتى لو أفطر يوما استأنف؛ هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي: إن صيام الشهرين يجزئ عن الدية والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وهم؛ لأن الدية إنما هي على العاقلة وليست على القاتل. والطبري حكى هذا القول عن مسروق.
والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف، وإنها إذا طهرت ولم تؤخر وصلت باقي صيامها بما سلف منه، لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة من العلماء؛ قاله أبو عمر. واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين؛ فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر إلا من عذر أو مرض أو حيض، وليس له أن يسافر فيفطر. وممن قال يبني في المرض سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عيينة وعطاء الخراساني: يستأنف في المرض؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي؛ وأحد قولي الشافعي؛ وله قول آخر: أنه يبني كما قال مالك. وقال ابن شبرمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب، كصوم رمضان. قال أبو عمر: حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمد، وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحجة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط لعذر، وإنما يسقط المأثم؛ قياسا على الصلاة؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبن.
قوله تعالى: "توبة من الله" نصب على المصدر، ومعناه رجوعا. وإنما مست حاجة المخطئ إلى التوبة لأنه لم يتحرز وكان من حقه أن يتحفظ. وقيل: أي فليأت بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الرقبة؛ ومنه قوله تعالى: "علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم "[البقرة: 187] أي خفف، وقوله تعالى: "علم أن لن تحصوه فتاب عليكم" [المزمل: 20].
قوله تعالى: "وكان الله" أي في أزله وأبده. "عليما" بجميع المعلومات "حكيما "فيما حكم وأبرم.
الآية: 93 {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم}
قوله تعالى: "ومن يقتل ""من "شرط، وجوابه "فجزاؤه "وسيأتي. واختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل؛ فقال عطاء والنخعي وغيرهما: هو من قتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد للقطع أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمد كل من قتل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك؛ وهذا قول الجمهور.
ذكر الله عز وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد وقد اختلف العلماء في القول به؛ فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك، وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وذكره الخطابي أيضا عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قتل عندهما بما لا يقتل مثله غالبا كالعضة واللطمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد. وقد ذكر عن مالك وقال ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل به عندنا. وممن أثبت شبه العمد الشعبي والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثري وأهل العراق والشافعي، وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها في أهبها، فلا تستباح إلا بأمرين لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان مترددا بين العمد والخطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود، وإنما وقع بغير القصد فيسقط القود وتغلظ الدية. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ). وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل ). وروي أيضا من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه ). وهذا نص. وقال طاوس في الرجل يصاب في ماء الرميا في القتال بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة يودي ولا يقتل به من أجل أنه لا يدرك، من قاتله. وقال أحمد بن حنبل: العميا هو الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهه. وقال إسحاق: هذا في تحارج القوم وقتل. بعضهم بعضا. فكأن أصله من التعمية وهو التلبيس؛ ذكره الدارقطني.
مسألة: واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلظة، فقال عطاء والشافعي: هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. وقد روي هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري؛ وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد، ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المدلجي بابنه حيث ضربه بالسيف. وقيل: هي مربعة ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض. هذا قول النعمان ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. وقيل: هي مخمسة: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة؛ هذا قول أبي ثور. وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. وروي عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصري وطاوس والزهري. وقيل: أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبي والنخعي، وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي.
واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وقتادة وأبو ثور: هو عليه في ماله. وقال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن المنذر: قول الشعبي أصح؛ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.
أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني؛ وقد تقدم ذكرها في "البقرة". وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ. قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى. وقال: إذا شرع السجود في السهو فلأن يشرع في العمد أولى، وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل، فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. وقيل تجب. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل. وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت.
واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: على كل واحد منهم الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة؛ هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وفرق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة، وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين.
روى النسائي: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي - ثقة قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ). وروي عن عبدالله قال: قال رسول الله: (أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء). وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبدالله بن عباس أنه سأل سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة ؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول ! مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس: ويحك ! أنى له توبة ! سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: (يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يوقفا فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى رب هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تعست ويذهب به إلى النار ). وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قتل المؤمن فلم يجبني ).
واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة ؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى النسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر "[الفرقان: 68] قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه". وروي عن زيد بن ثابت نحوه، وإن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر، وفي رواية بثمانية أشهر؛ ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت. وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا: هذا مخصص عموم قوله تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[النساء: 48] ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا. وذهب جماعة من العلماء منهم. عبدالله بن عمر - وهو أيضا مروي عن زيد وابن عباس - إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة ؟ قال: لا، إلا النار؛ قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا ؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؛ قال: إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وإن هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن ضبابة؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة؛ فوجد هشاما قتيلا في بني النجار فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر؛ فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي الدية؛ فأعطوه مائة من الإبل؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتدا؛ وجعل ينشد:
قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع
حللت به وتري وأدركت ثورتي وكنت إلى الأوثان أول راجع
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أؤمنه في حل ولا حرم ). وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة. وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين، ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله: "إن الحسنات يذهبن السيئات "[هود: 114] وقوله تعالى: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده "[الشورى: 25] وقوله: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[النساء: 48]. والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص. ثم إن الجمع بين آية "الفرقان "وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض، وذلك أن يحمل مطلق آية "النساء "على مقيد آية "الفرقان "فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو التواعد بالعقاب. وأما الأخبار فكثيرة كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه: (تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ). رواه الأئمة أخرجه الصحيحان. وكحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل مائة نفس. أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل، ويقر بأنه قتل عمدا، ويأتي السلطان الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا، فهذا غير متبع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة؛ فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "ودخله التخصيص بما ذكرنا، وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بينا، أو تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس أنه قال: متعمدا معناه مستحلا لقتله؛ فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماعا. وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب؛ قال أبو حنيفة وأصحابه. فإن قيل: إن قوله تعالى: "فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه "دليل على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. قلنا: هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم؛ كما قال:
وإني متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
وقد تقدم. جواب ثان: إن جازاه بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه. نص على هذا أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو منجزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ). وفي هذين التأويلين دخل؛ أما الأول - فقال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن كلام الرب لا يقبل الخلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ فهو إذا جائز في الكلام. وأما الثاني: وإن روي أنه مرفوع فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بين، وقد قال الله عز وجل: "ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا "[الكهف: 106] ولم يقل أحد: إن جازاهم؛ وهو خطأ في العربية لأن بعده "وغضب الله عليه "وهو محمول على معنى جازاه. وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشؤم المعاصي. وذكر هبة الله في كتاب "الناسخ والمنسوخ "أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[النساء: 48]، وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا هي محكمة. وفي هذا الذي قال نظر؛ لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع نسخ؛ قال ابن عطية. قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. وقال النحاس في "معاني القرآن "له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم وأنه يجازيه إذا لم يتب، فإن تاب فقد بين أمره بقوله: "وإني لغفار لمن تاب "[طه: 82] فهذا لا يخرج عنه، والخلود لا يقتضي الدوام، قال الله تعالى: "وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد "[الأنبياء: 34] الآية. وقال تعالى: "يحسب أن ماله أخلده "[الهمزة: 3]. وقال زهير:
ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا
وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلانا في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خلد الله ملكه وأبد أيامه. وقد تقدم هذا كله لفظا ومعنى. والحمد لله.
الآية: 94 {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير}
قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله" هذا متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السير في الأرض؛ تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره؛ مقترنة بفي. وتقول: ضربت الأرض دون "في" إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فرجيهما فإن الله يمقت على ذلك ). وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعها فسلم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ونزلت الآية. وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: "عرض الحياة الدنيا "تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس "السلام". في غير البخاري: وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله ورد عليه غنيماته.
واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة، فالذي عليه الأكثر وهو في سير ابن إسحاق ومصنف أبي داود والاستيعاب لابن عبدالبر أن القاتل محلم بن جثامة، والمقتول عامر بن الأضبط فدعا عليه السلام على محلم فما عاش بعد ذلك إلا سبعا ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله؛ فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك الشعاب؛ وقال عليه السلام: (إن الأرض لتقبل من هو شر منه ). قال الحسن: أما إنها تحبس من هو شر منه ولكنه وعظ القوم ألا يعودوا. وفي سنن ابن ماجة عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا، فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ إني مسلم؛ فطعنه فقتله؛ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت ! قال: (وما الذي صنعت ) ؟ مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه ) فقال: يا رسول الله لو شققت بطنه أكنت أعلم ما في قلبه ؟ قال: (لا فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه ). فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه، فأصبح على وجه الأرض. فقلنا: لعل عدوا نبشه، فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا: لعل الغلمان نعسوا، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب. وقيل: إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك الغطفاني ثم الفزاري من بني مرة من أهل فدك. وقال ابن القاسم عن مالك. وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله؛ ولما عظم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله. وقد تقدم القول فيه. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض حين مات هو محرم الذي ذكرناه. ولعل هذه الأحوال جرت في زمان متقارب فنزلت الآية في الجميع. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل المسلم الغنم والجمل وحمل ديته على طريق الائتلاف والله أعلم. وذكر الثعلبي أن أمير تلك السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي. وقيل: المقداد حكاه السهيلي.
قوله تعالى: "فتبينوا" أي تأملوا. و"تبينوا "قراءة الجماعة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وقالا: من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبيت؛ يقال: تبينت الأمر وتبين الأمر بنفسه، فهو متعد ولازم. وقرأ حمزة "فتثبتوا "من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحدة "وتبينوا "في هذا أوكد؛ لأن الإنسان قد يتثبت ولا يبين. وفي "إذا "معنى الشرط، فلذلك دخلت الفاء في قوله "فتبينوا". وقد يجازى بها كما قال:
وإذا تصبك خصاصة فتجمل
والجيد ألا يجازى بها كما قال الشاعر:
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع
والتبين التثبت في القتل واجب حضرا وسفرا ولا خلاف فيه، وإنما خص السفر بالذكر لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر.
قوله تعالى: "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا" السلم والسلم، والسلام واحد، قال البخاري. وقرئ بها كلها. واختار أبو عبيد القاسم بن سلام "السلام". وخالفه أهل النظر فقالوا: "السلم "ههنا أشبه؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسليم، كما قال عز وجل: "فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء "[النحل: 28] فالسلم الاستسلام والانقياد. أي لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست مؤمنا. وقيل: السلام قول السلام عليكم، وهو راجع إلى الأول؛ لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده، ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. قال الأخفش: يقال فلان سلام إذا كان لا يخالط أحدا. والسلم (بشد السين وكسرها وسكون اللام) الصلح.
وروي عن أبي جعفر أنه قرأ "لست مؤمَنا "بفتح الميم الثانية، من آمنته إذا أجرته فهو مؤمن.
والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله؛ فإن قال: لا إله إلا الله لم يجز قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله: فإن قتله بعد ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح، وأن العاصم قولها مطمئنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاصم كيفما قالها؛ ولذلك قال لأسامة: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ) أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب ؟ وذلك لا يمكن فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر.
فإن قال: سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضا حتى يعلم ما وراء هذا؛ لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئت مستأمنا أطلب الأمان: هذه أمور مشكلة، وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد ثبت له فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله، ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ).
فإن صلى أو فعل فعلا من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا؛ فقال ابن العربي: نرى أنه لا يكون بذلك مسلما، أما أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة ؟ فإن قال: صلاة مسلم، قيل له: قل لا إله إلا الله؛ فإن قالها تبين صدقه، وإن أبى علمنا أن ذلك تلاعب، وكانت عند من يرى إسلامه ردة؛ والصحيح أنه كفر أصلي ليس بردة. وكذلك هذا الذي قال: سلام عليكم، يكلف الكلمة؛ فإن قالها تحقق رشاده، وإن أبى تبين عناده وقتل. وهذا معنى قوله: "فتبينوا "أي الأمر المشكل، أو "تثبتوا "ولا تعجلوا المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه. فإن قيل: فتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على محلم، ونبذه من قبره كيف مخرجه ؟ قلنا: لأنه علم من نيته أنه لم يبال بإسلامه فقتله متعمدا لأجل الحنة التي كانت بينهما في الجاهلية.
قوله تعالى: "تبتغون عرض الحياة الدنيا" أي تبتغون أخذ ماله: ويسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الحياة الدنيا عرض بفتح الراء؛ ومنه: (الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ). والعرض (بسكون الراء ) ما سوى الدنانير والدراهم؛ فكل عرض عرض، وليس كل عرض عرضا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس ). وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه:
تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي
فليس الغنى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس
وهذا يصحح قول أبي عبيدة: فإن المال يشمل كل ما يتمول. وفي كتاب العين: العرض ما نيل من الدنيا؛ ومنه قوله تعالى: "تريدون عرض الدنيا "[الأنفال: 67] وجمعه عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض الإنسان من مرض أو نحوه وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كثر. والعرض من الأثاث ما كان غير نقد. وأعرض الشيء إذا ظهر وأمكن. والعرض خلاف الطول.
قوله تعالى: "فعند الله مغانم كثيرة" عدة من الله تعالى بما يأتي به على وجهه ومن حله دون ارتكاب محظور، أي فلا تتهافتوا. "كذلك كنتم من قبل "أي كذلك كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا منكم على أنفسكم حتى من الله عليكم بإعزاز الدين وغلبة المشركين، فهم الآن كذلك كل واحد منهم في قومه متربص أن يصل إليكم، فلا يصلح إذ وصل إليكم أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى كذلك كنتم كفرة "فمن الله عليكم "بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك ثم يسلم لحينه حين لقيكم فيجب أن تتثبتوا في أمره.
استدل بهذه الآية من قال: إن الإيمان هو القول، لقوله تعالى: "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا". قالوا: ولما منع أن يقال لمن قال لا إله إلا الله لست مؤمنا منع من قتلهم بمجرد القول. ولولا الإيمان الذي هو هذا القول لم يعب قولهم. قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعوذا فقتلوه، والله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط؛ ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين حسب ما تقدم بيانه في "البقرة "وقد كشف البيان في هذا قوله عليه السلام: (أفلا شققت عن قلبه ) ؟ فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره، وأن حقيقته التصديق بالقلب، ولكن ليس للعبد طريق إليه إلا ما سمع منه فقط. واستدل بهذا أيضا من قال: إن الزنديق تقبل توبته إذا أظهر الإسلام؛ قال: لأن الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام. وقد مضى القول في هذا في أول البقرة. وفيها رد على القدرية، فإن الله تعالى أخبر أنه من على المؤمنين من بين جميع الخلق بأن خصهم بالتوفيق، والقدرية تقول: خلقهم كلهم للإيمان. ولو كان كما زعموا لما كان لاختصاص المؤمنين بالمنة من بين الخلق معنى.
قوله تعالى: "فتبينوا" أعاد الأمر بالتبيين للتأكيد. "إن الله كان بما تعملون خبيرا "تحذير عن مخالفة أمر الله؛ أي احفظوا أنفسكم وجنبوها الزلل الموبق لكم.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 93
93- تفسير الصفحة رقم93 من المصحفالآية: 92 {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيم}
قوله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ" هذه آية من أمهات الأحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؛ فقوله: "وما كان "ليس على النفي وإنما هو على التحريم والنهي، كقوله: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله "[الأحزاب:53] ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط؛ لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده، كقوله تعالى: "ما كان لكم أن تنبتوا شجرها "[النمل:60]. فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا. وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك في عهد الله. وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف، كما ليس له الآن ذلك بوجه، ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الأول وهو الذي يكون فيه "إلا "بمعنى "لكن "والتقدير ما كان له أن يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا قول سيبويه والزجاج رحمهما الله. ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى: "ما لهم به من علم إلا اتباع الظن "[النساء:157]: وقال النابغة:
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد
إلا الأواري لأيا ما أبينها والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد
فلما لم تكن "الأواري "من جنس أحد حقيقة لم تدخل في لفظه. ومثله قول الآخر:
أمسى سقام خلاء لا أنيس به إلا السباع ومر الريح بالغرف
وقال آخر:
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس
وقال آخر:
وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعذ من النخل
أنشده سيبويه؛ ومثله كثير، ومن أبدعه قول جرير:
من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ذيل مرط مرحل
كأنه قال: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد. ونزلت الآية بسبب قتل عياش بن أبي ربيعة الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة العامري لحنة كانت بينهما، فلما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله ولم يشعر بإسلامه، فلما أخبر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، ولم أشعر بإسلامه حتى قتلته فنزلت الآية. وقيل: هو استثناء متصل، أي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه إلا أن يكون خطأ؛ فلا يقتص منه؛ ولكن فيه كذا وكذا. ووجه آخر وهو أن يقدر كان بمعنى استقر ووجد؛ كأنه قال: وما وجد وما تقرر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحيانا؛ فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد وبشاعة شأنه؛ كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسيا ؟ إعظاما للعمد والقصد مع حظر الكلام به البتة. وقيل: المعنى ولا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز أن تكون "إلا" بمعنى الواو، ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى؛ لأن الخطأ لا يحظر. ولا يفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم فإن المسلم محترم الدم، وإنما خص المؤمن بالذكر تأكيدا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته. وقرأ الأعمش "خطاء "ممدودا في المواضع الثلاثة. ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى يربطها عدم القصد؛ مثل أن يرمي صفوف المشركين فيصيب مسلما. أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان أو محارب أو مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض فيصيب إنسانا أو ما جرى مجراه؛ وهذا مما لا خلاف فيه. والخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا لم يصنع عن تعمد؛ فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن أراد شيئا ففعل غير: أخطأ، ولمن فعل غير الصواب: أخطأ. قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ "إلى قوله تعالى: "ودية مسلمة إلى أهله "فحكم الله جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية، وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به.
ذهب داود إلى القصاص بين الحر والعبد في النفس، وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسكا بقوله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس "[المائدة: 45] إلى قوله تعالى: "والجروح قصاص "[المائدة: 45]، وقوله عليه السلام: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ) فلم يفرق بين حر وعبد؛ وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيقتل الحر بالعبد، كما يقتل العبد بالحر، ولا قصاص بينهما في شيء من الجراح والأعضاء. وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ" أنه لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله عليه السلام: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ) أريد به الأحرار خاصة. والجمهور على ذلك وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس فالنفس أحرى بذلك؛ وقد مضى هذا في "البقرة".
قوله تعالى: "فتحرير رقبة مؤمنة" أي فعليه تحرير رقبة؛ هذه الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضا على ما يأتي. واختلف العلماء فيما يجزئ منها، فقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلت الإيمان، لا تجزئ في ذلك الصغيرة، وهو الصحيح في هذا الباب قال عطاء بن أبي رباح: يجزئ الصغير المولود بين مسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزئ كل من حكم له بحكم في الصلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: من صلى وصام أحب إلي. ولا يجزئ في قول كافة العلماء أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلهما، ويجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعور. قال مالك: إلا أن يكون عرجا شديدا. ولا يجزئ عند مالك والشافعي وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ويجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم المجنون المطبق ولا يجزئ عند مالك الذي يجن ويفيق، ويجزئ عند الشافعي. ولا يجزئ عند مالك المعتق إلى سنين، ويجزئ عند الشافعي. ولا يجزئ المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، ويجزئ في قول الشافعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. وقال مالك: لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعالى: "فتحرير رقبة". ومن أعتق البعض لا يقال حرر رقبة وإنما حرر بعضها. واختلفوا أيضا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل، وذنه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. وقيل: أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من أمر العبودية صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا ما يتميز به عن البهائم والدواب، ويرتجى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرنا، والمعنى الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارة. وأي واحد من هذين المعنيين كان، ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله، بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه، على ما يأتي بيانه، والله أعلم.
قوله تعالى: "ودية مسلمة" الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه. "مسلمة" مدفوعة مؤداة، ولم يعين الله في كتابه ما يعطى في الدية، وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل، وإنما أخذ ذلك من السنة، ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات، والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظا، ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة محضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه. وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية مائة من الإبل، ووداها صلى الله عليه وسلم في عبدالله بن سهل المقتول بخيبر لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن، فكان ذلك بيانا على لسان نبيه عليه السلام لمجمل كتابه. وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل مائة من الإبل واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفة: على أهل الذهب ألف دينار، وهم أهل الشام ومصر والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه، في القديم. وروي هذا عن عمر وعروة بن الزبير وقتادة. وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم، وهم أهل العراق وفارس وخراسان؛ هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقال المزني: قال الشافعي الدية الإبل؛ فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قومها عمر، ألف دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق. وقال أبو حنيفة (أصحابه والثوري: الدية من الورق عشرة آلاف درهم. رواه الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألف شاة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهر من الحديث عن عثمان وعلي وابن عباس. وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر في البقر والشاء والحلل. وبه قال عطاء وطاوس وطائفة من التابعين، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الشافعي وبه قال طاوس. قال ابن المنذر: دية الحر المسلم مائة من الإبل في كل زمان، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه في أعداد الدراهم وما منها شيء يصح عنه لأنها مراسيل، وقد عرفتك مذهب الشافعي وبه ونقول.
واختلف الفقهاء في أسنان دية الإبل؛ فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشر بني لبون. قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء، وإنما قال أكثر العلماء: دية الخطأ أخماس. كذا قال أصحاب الرأي والثوري، وكذلك مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا في الأصناف؛ قال أصحاب الرأي وأحمد: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع. وروي هذا القول عن ابن مسعود. وقال مالك والشافعي: خمس حقاق، وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والليث بن سعد. قال الخطابي: ولأصحاب الرأي فيه أثر، إلا أن راويه عبدالله بن خشف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وعدل الشافعي عن القول به. لما ذكرنا من العلة في راويه، ولأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر مائة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. قال أبو عمر: وقد روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا، إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفي الطائي وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الطائي الجشمي من بني جشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين.
قلت: قد ذكر الدارقطني في سننه حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبدالله بن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ مائة من الإبل؛ منها عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض. قال الدارقطني: "هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة؛ أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه، الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبدالله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه؛ هذا لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني؛ ثم بلغه بعه ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا شديدا لم يروه فرح مثله، لموافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هذه صفته وهذا حال فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويخالفه. ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهورا، أو رجلا قد ارتفع عنه اسم الجهالة، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا؛ فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره. والله أعلم.
ووجه آخر: وهو أن حديث خشف بن مالك لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا الحجاج بن أرطأة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه، وكفاك بهم علما بالرجل ونبلا. وقال يحيى بن معين: حجاج بن أرطأة لا يحتج بحديثه. وقال عبدالله بن إدريس: سمعت الحجاج يقول لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة. وقال عيسى بن يونس: سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون. وقال جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. وذكر أوجها أخر؛ منها أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه. إلى غير ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدية، وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره على ما يأتي. وروى حماد بن سلمة حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور. قال الدارقطني: هذا إسناد حسن ورواته ثقات، وقد روي عن علقمة عن عبدالله نحو هذا.
قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الدية تكون مخمسة. قال الخطابي: وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع؛ وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ إلا أنهم قالوا: خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب. قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعي فروي عن سليمان بن يسار وليس فيه عن صحابي شيء؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب.
قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعي. قال أبو عمر: وأسنان الإبل في الدبات لم تؤخذ قياسا ولا نظرا، وإنما أخذت اتباعا وتسليما، وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر؛ فكل يقول بما قد صح عنده من سلفه؛ رضي الله عنهم أجمعين.
قلت: وأما ما حكاه الخطابي من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهد، إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت مخاض ثلاثين جذعة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبدالله وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدارقطني والخطابي، وابن عبدالبر قال: لأنه الأقل مما قيل؛ وبحديث. مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق هذا القول.
قلت: وعجبا لابن المنذر ؟ مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقد على صحته ! لكن الذهول والنسيان قد يعتري الإنسان، وإنما الكمال لعزة ذي الجلال.
ثبتت الأخبار عن النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه: (إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ) العمد دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث؛ والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا، ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما دون الثلث في مال الجاني. وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد. في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول الشافعي.
وحكمها أن تكون منجمة على العاقلة، والعاقلة العصبة. وليس ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلة. ولا الإخوة من الأم بعصبة لإخوتهم من الأب والأم، فلا يعقلون عنهم شيئا. وكذلك الديوان لا يكون عاقلة في قول جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان؛ فتنجم الدية على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاه عمر وعلي؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضر به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا. ومنها أنه كان يعجلها تأليفا. فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربي. وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل الديوان. واتفق الفقهاء عل رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو.
قلت: ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قتل الجنين في بطن أمه؛ وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه الدية كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة. وقيل: بغير قسامة. واختلفوا فيما به تعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضع أو تنفس نفسا محققة حي، فيه الدية كاملة؛ فإن تحرك فقال الشافعي وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته. وقال مالك: لا، إلا أن يقارنها طول إقامة. والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء. فإن ألقته ميتا ففيه غرة: عبد أو وليدة. فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه. وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. وروي عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها: ففيه الغرة، وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا خرج ميتا من بطنها بعد موتها. قال الطحاوي محتجا لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موتها.
ولا تكون الغرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في الجنين غرة عبد أو أمة ) - لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى لقال: في الجنين عبد أو أمة، ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل في الدية إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء، لا يقبل فيها أسود ولا سوداء. واختلف العلماء في قيمتها؛ فقال مالك: تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم؛ نصف عشر دية الحر المسلم، وعشر دية أمه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسمائة درهم. وقال الشافعي: سن الغرة سبع سنين أو ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها معيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم، من الذهب عشرون دينارا إن كانوا أهل ذهب، ومن الورق - إن كانوا أهل ورق - ستمائة درهم، أو خمس فرائض من الإبل. قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حي. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، هي على العاقلة. وهو أصح؛ لحديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار - في رواية فتغايرتا - فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان فقالا: ندي من لا صاح ولا أكل، ولا شرب ولا استهل. فمثل ذلك يطل !، فقال: (أسجع كسجع الأعراب ) ؟ فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة. وهو حديث ثابت صحيح، نص في موضع الخلاف يوجب الحكم. ولما كانت دية المرأة المضروبة على العاقلة كان الجنين كذلك في القياس والنظر. واحتج علماؤنا بقول الذي قضي عليه: كيف أغرم ؟ قالوا: وهذا يدل على أن الذي قضي عليه معين وهو الجاني. ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة لقال: فقال الذي قضى عليهم. وفي القياس أن كل جان جنايته عليه، إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض له؛ مثل إجماع لا يجوز خلافه، أو نص سنة من جهة نقل الآحاد العدول لا معارض لها، فيجب الحكم بها، وقد قال الله تعالى: "ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى" [الأنعام: 164].
ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا؛ فقال مالك: فيه الغرة والكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعي: فيه الغرة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرة عن الجنين؛ فقال مالك والشافعي وأصحابهما: الغرة في الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها دية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة للأم وحدها؛ لأنها جناية جنى عليها بقطع عضو من أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على ذلك أنه لم يعتبر فيه الذكر والأنثى كما يلزم في الديات، فدل على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هرمز يقول: ديته لأبويه خاصة؛ لأبيه ثلثاها ولأمه ثلثها، من كان منهما حيا كان ذلك له، فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي منهما أبا كان أو أما، ولا يرث الإخوة شيئا.
قوله تعالى: "إلا أن يصدقوا" أصله "أن يتصدقوا "فأدغمت التاء في الصاد. والتصدق الإعطاء؛ يعني إلا أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول القاتلين مما أوجب لهم من الدية عليهم. فهو استثناء ليس من الأول. وقرأ أبو عبدالرحمن ونبيح "إلا أن تصدقوا "بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك قرأ أبو عمرو، إلا أنه شدد الصاد. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية، ولا يجوز حذفها على قراءة الياء. وفي حرف أبي وابن مسعود "إلا أن يتصدقوا". وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه وإنما تسقط الدية التي هي حق لهم. وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تتحمل.
قوله تعالى: "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن" هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعي: فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد أمن وبقي في قومه وهم كفرة "عدو لكم "فلا دية فيه؛ وإنما كفارته تحرير. الرقبة. وهو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة. وسقطت الدية لوجهين: أحدهما: أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بها. والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة، فلا دية؛ لقوله تعالى: "والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا "[الأنفال: 72]. وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط؛ فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية فيه، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. هذا قول الشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة.
قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله؛ فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقال لا إله إلا الله وقتلته ) ! قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح؛ قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ ). فلم يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بقصاص ولا دية. وروي عن أسامة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي بعد ثلاث مرات، وقال: (أعتق رقبة ) ولم يحكم بقصاص ولا دية. فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدوانا؛ وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة: الأول: لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا كالخاتن والطبيب. الثاني: لكونه من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديته؛ لقوله تعالى: "فإن كان من قوم عدو لكم "كما ذكرنا. الثالث: أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافا، ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعلم.
قوله تعالى: "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق" هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي. واختاره الطبري قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية. وقرأها الحسن: "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن". قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه. قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ "ثم قال تعالى: "وإن كان من قوم" يريد ذلك المؤمن. والله أعلم. قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد.
قلت: وهذا معنى ما قال الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. وقوله "فدية مسلمة "على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه السلام عهد على أن يسلموا أو يؤذنوا بحرب إلى أجل معلوم: فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة ثم نسخ بقوله تعالى: "براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين "[التوبة: 1].
وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال أبو عمر: إنما صارت ديتها - والله أعلم - على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: "النفس بالنفس "[المائدة: 45]. و"الحر بالحر "كما تقدم في "البقرة".
روى الدارقطني من حديث موسى بن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت أبي يقول إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول:
يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا مما كلاهما تكسرا
وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير؛ فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. وقد اختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما؛ فروي عن ابن الزبير: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى. وهذا قول شريح والنخعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه. حتى سقطا وماتا: على عاقلة الذي جبذه الدية. قال أبو عمر: ما أظن في هذا خلافا - والله أعلم - إلا ما قال بعض المتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعي: يضمن نصف الدية؛ لأنه مات من فعله، ومن سقوط الساقط عليه. وقال الحكم وابن شبرمة: إن سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهما، قالا: يضمن الحي منهما. وقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر. وقال في الفارسين إذا اصطدما فماتا: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه؛ وقال عثمان البتي وزفر. وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسين يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. قال ابن خويز منداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن النوتي صرف السفينة ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين والفارسين. على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا.
واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب؛ فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ودية نسائهم على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن شعيب وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم. وعبدالرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيضا. وقال ابن عباس والشعبي والنخعي: المقتول من أهل العهد خطأ لا تبالي مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فيه الدية كدية المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي؛ جعلوا الديات كلها سواء، المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي، وهو قول عطاء والزهري وسعيد بن المسيب. وحجتهم قوله تعالى: "فدية "وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المسلم. وعضدوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة بني قريظة والنضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ديتهم سواء دية كاملة. قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة. وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم؛ وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عمر وعثمان، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار وأبو ثور وإسحاق.
قوله تعالى: "فمن لم يجد" أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها. "فصيام شهرين" أي فعليه صيام شهرين. "متتابعين "حتى لو أفطر يوما استأنف؛ هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي: إن صيام الشهرين يجزئ عن الدية والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وهم؛ لأن الدية إنما هي على العاقلة وليست على القاتل. والطبري حكى هذا القول عن مسروق.
والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف، وإنها إذا طهرت ولم تؤخر وصلت باقي صيامها بما سلف منه، لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة من العلماء؛ قاله أبو عمر. واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين؛ فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر إلا من عذر أو مرض أو حيض، وليس له أن يسافر فيفطر. وممن قال يبني في المرض سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عيينة وعطاء الخراساني: يستأنف في المرض؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي؛ وأحد قولي الشافعي؛ وله قول آخر: أنه يبني كما قال مالك. وقال ابن شبرمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب، كصوم رمضان. قال أبو عمر: حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمد، وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحجة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط لعذر، وإنما يسقط المأثم؛ قياسا على الصلاة؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبن.
قوله تعالى: "توبة من الله" نصب على المصدر، ومعناه رجوعا. وإنما مست حاجة المخطئ إلى التوبة لأنه لم يتحرز وكان من حقه أن يتحفظ. وقيل: أي فليأت بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الرقبة؛ ومنه قوله تعالى: "علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم "[البقرة: 187] أي خفف، وقوله تعالى: "علم أن لن تحصوه فتاب عليكم" [المزمل: 20].
قوله تعالى: "وكان الله" أي في أزله وأبده. "عليما" بجميع المعلومات "حكيما "فيما حكم وأبرم.
الآية: 93 {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم}
قوله تعالى: "ومن يقتل ""من "شرط، وجوابه "فجزاؤه "وسيأتي. واختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل؛ فقال عطاء والنخعي وغيرهما: هو من قتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد للقطع أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمد كل من قتل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك؛ وهذا قول الجمهور.
ذكر الله عز وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد وقد اختلف العلماء في القول به؛ فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك، وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وذكره الخطابي أيضا عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قتل عندهما بما لا يقتل مثله غالبا كالعضة واللطمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد. وقد ذكر عن مالك وقال ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل به عندنا. وممن أثبت شبه العمد الشعبي والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثري وأهل العراق والشافعي، وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها في أهبها، فلا تستباح إلا بأمرين لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان مترددا بين العمد والخطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود، وإنما وقع بغير القصد فيسقط القود وتغلظ الدية. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ). وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل ). وروي أيضا من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه ). وهذا نص. وقال طاوس في الرجل يصاب في ماء الرميا في القتال بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة يودي ولا يقتل به من أجل أنه لا يدرك، من قاتله. وقال أحمد بن حنبل: العميا هو الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهه. وقال إسحاق: هذا في تحارج القوم وقتل. بعضهم بعضا. فكأن أصله من التعمية وهو التلبيس؛ ذكره الدارقطني.
مسألة: واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلظة، فقال عطاء والشافعي: هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. وقد روي هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري؛ وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد، ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المدلجي بابنه حيث ضربه بالسيف. وقيل: هي مربعة ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض. هذا قول النعمان ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. وقيل: هي مخمسة: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة؛ هذا قول أبي ثور. وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. وروي عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصري وطاوس والزهري. وقيل: أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبي والنخعي، وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي.
واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وقتادة وأبو ثور: هو عليه في ماله. وقال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن المنذر: قول الشعبي أصح؛ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.
أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني؛ وقد تقدم ذكرها في "البقرة". وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ. قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى. وقال: إذا شرع السجود في السهو فلأن يشرع في العمد أولى، وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل، فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. وقيل تجب. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل. وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت.
واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: على كل واحد منهم الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة؛ هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وفرق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة، وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين.
روى النسائي: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي - ثقة قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ). وروي عن عبدالله قال: قال رسول الله: (أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء). وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبدالله بن عباس أنه سأل سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة ؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول ! مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس: ويحك ! أنى له توبة ! سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: (يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يوقفا فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى رب هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تعست ويذهب به إلى النار ). وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قتل المؤمن فلم يجبني ).
واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة ؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى النسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر "[الفرقان: 68] قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه". وروي عن زيد بن ثابت نحوه، وإن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر، وفي رواية بثمانية أشهر؛ ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت. وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا: هذا مخصص عموم قوله تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[النساء: 48] ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا. وذهب جماعة من العلماء منهم. عبدالله بن عمر - وهو أيضا مروي عن زيد وابن عباس - إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة ؟ قال: لا، إلا النار؛ قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا ؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؛ قال: إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وإن هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن ضبابة؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة؛ فوجد هشاما قتيلا في بني النجار فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر؛ فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي الدية؛ فأعطوه مائة من الإبل؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتدا؛ وجعل ينشد:
قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع
حللت به وتري وأدركت ثورتي وكنت إلى الأوثان أول راجع
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أؤمنه في حل ولا حرم ). وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة. وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين، ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله: "إن الحسنات يذهبن السيئات "[هود: 114] وقوله تعالى: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده "[الشورى: 25] وقوله: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[النساء: 48]. والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص. ثم إن الجمع بين آية "الفرقان "وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض، وذلك أن يحمل مطلق آية "النساء "على مقيد آية "الفرقان "فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو التواعد بالعقاب. وأما الأخبار فكثيرة كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه: (تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ). رواه الأئمة أخرجه الصحيحان. وكحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل مائة نفس. أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل، ويقر بأنه قتل عمدا، ويأتي السلطان الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا، فهذا غير متبع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة؛ فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "ودخله التخصيص بما ذكرنا، وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بينا، أو تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس أنه قال: متعمدا معناه مستحلا لقتله؛ فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماعا. وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب؛ قال أبو حنيفة وأصحابه. فإن قيل: إن قوله تعالى: "فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه "دليل على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. قلنا: هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم؛ كما قال:
وإني متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
وقد تقدم. جواب ثان: إن جازاه بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه. نص على هذا أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو منجزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ). وفي هذين التأويلين دخل؛ أما الأول - فقال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن كلام الرب لا يقبل الخلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ فهو إذا جائز في الكلام. وأما الثاني: وإن روي أنه مرفوع فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بين، وقد قال الله عز وجل: "ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا "[الكهف: 106] ولم يقل أحد: إن جازاهم؛ وهو خطأ في العربية لأن بعده "وغضب الله عليه "وهو محمول على معنى جازاه. وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشؤم المعاصي. وذكر هبة الله في كتاب "الناسخ والمنسوخ "أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[النساء: 48]، وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا هي محكمة. وفي هذا الذي قال نظر؛ لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع نسخ؛ قال ابن عطية. قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. وقال النحاس في "معاني القرآن "له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم وأنه يجازيه إذا لم يتب، فإن تاب فقد بين أمره بقوله: "وإني لغفار لمن تاب "[طه: 82] فهذا لا يخرج عنه، والخلود لا يقتضي الدوام، قال الله تعالى: "وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد "[الأنبياء: 34] الآية. وقال تعالى: "يحسب أن ماله أخلده "[الهمزة: 3]. وقال زهير:
ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا
وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلانا في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خلد الله ملكه وأبد أيامه. وقد تقدم هذا كله لفظا ومعنى. والحمد لله.
الآية: 94 {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير}
قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله" هذا متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السير في الأرض؛ تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره؛ مقترنة بفي. وتقول: ضربت الأرض دون "في" إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فرجيهما فإن الله يمقت على ذلك ). وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعها فسلم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ونزلت الآية. وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: "عرض الحياة الدنيا "تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس "السلام". في غير البخاري: وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله ورد عليه غنيماته.
واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة، فالذي عليه الأكثر وهو في سير ابن إسحاق ومصنف أبي داود والاستيعاب لابن عبدالبر أن القاتل محلم بن جثامة، والمقتول عامر بن الأضبط فدعا عليه السلام على محلم فما عاش بعد ذلك إلا سبعا ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله؛ فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك الشعاب؛ وقال عليه السلام: (إن الأرض لتقبل من هو شر منه ). قال الحسن: أما إنها تحبس من هو شر منه ولكنه وعظ القوم ألا يعودوا. وفي سنن ابن ماجة عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا، فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ إني مسلم؛ فطعنه فقتله؛ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت ! قال: (وما الذي صنعت ) ؟ مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه ) فقال: يا رسول الله لو شققت بطنه أكنت أعلم ما في قلبه ؟ قال: (لا فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه ). فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه، فأصبح على وجه الأرض. فقلنا: لعل عدوا نبشه، فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا: لعل الغلمان نعسوا، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب. وقيل: إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك الغطفاني ثم الفزاري من بني مرة من أهل فدك. وقال ابن القاسم عن مالك. وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله؛ ولما عظم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله. وقد تقدم القول فيه. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض حين مات هو محرم الذي ذكرناه. ولعل هذه الأحوال جرت في زمان متقارب فنزلت الآية في الجميع. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل المسلم الغنم والجمل وحمل ديته على طريق الائتلاف والله أعلم. وذكر الثعلبي أن أمير تلك السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي. وقيل: المقداد حكاه السهيلي.
قوله تعالى: "فتبينوا" أي تأملوا. و"تبينوا "قراءة الجماعة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وقالا: من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبيت؛ يقال: تبينت الأمر وتبين الأمر بنفسه، فهو متعد ولازم. وقرأ حمزة "فتثبتوا "من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحدة "وتبينوا "في هذا أوكد؛ لأن الإنسان قد يتثبت ولا يبين. وفي "إذا "معنى الشرط، فلذلك دخلت الفاء في قوله "فتبينوا". وقد يجازى بها كما قال:
وإذا تصبك خصاصة فتجمل
والجيد ألا يجازى بها كما قال الشاعر:
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع
والتبين التثبت في القتل واجب حضرا وسفرا ولا خلاف فيه، وإنما خص السفر بالذكر لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر.
قوله تعالى: "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا" السلم والسلم، والسلام واحد، قال البخاري. وقرئ بها كلها. واختار أبو عبيد القاسم بن سلام "السلام". وخالفه أهل النظر فقالوا: "السلم "ههنا أشبه؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسليم، كما قال عز وجل: "فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء "[النحل: 28] فالسلم الاستسلام والانقياد. أي لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست مؤمنا. وقيل: السلام قول السلام عليكم، وهو راجع إلى الأول؛ لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده، ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. قال الأخفش: يقال فلان سلام إذا كان لا يخالط أحدا. والسلم (بشد السين وكسرها وسكون اللام) الصلح.
وروي عن أبي جعفر أنه قرأ "لست مؤمَنا "بفتح الميم الثانية، من آمنته إذا أجرته فهو مؤمن.
والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله؛ فإن قال: لا إله إلا الله لم يجز قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله: فإن قتله بعد ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح، وأن العاصم قولها مطمئنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاصم كيفما قالها؛ ولذلك قال لأسامة: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ) أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب ؟ وذلك لا يمكن فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر.
فإن قال: سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضا حتى يعلم ما وراء هذا؛ لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئت مستأمنا أطلب الأمان: هذه أمور مشكلة، وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد ثبت له فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله، ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ).
فإن صلى أو فعل فعلا من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا؛ فقال ابن العربي: نرى أنه لا يكون بذلك مسلما، أما أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة ؟ فإن قال: صلاة مسلم، قيل له: قل لا إله إلا الله؛ فإن قالها تبين صدقه، وإن أبى علمنا أن ذلك تلاعب، وكانت عند من يرى إسلامه ردة؛ والصحيح أنه كفر أصلي ليس بردة. وكذلك هذا الذي قال: سلام عليكم، يكلف الكلمة؛ فإن قالها تحقق رشاده، وإن أبى تبين عناده وقتل. وهذا معنى قوله: "فتبينوا "أي الأمر المشكل، أو "تثبتوا "ولا تعجلوا المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه. فإن قيل: فتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على محلم، ونبذه من قبره كيف مخرجه ؟ قلنا: لأنه علم من نيته أنه لم يبال بإسلامه فقتله متعمدا لأجل الحنة التي كانت بينهما في الجاهلية.
قوله تعالى: "تبتغون عرض الحياة الدنيا" أي تبتغون أخذ ماله: ويسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الحياة الدنيا عرض بفتح الراء؛ ومنه: (الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ). والعرض (بسكون الراء ) ما سوى الدنانير والدراهم؛ فكل عرض عرض، وليس كل عرض عرضا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس ). وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه:
تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي
فليس الغنى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس
وهذا يصحح قول أبي عبيدة: فإن المال يشمل كل ما يتمول. وفي كتاب العين: العرض ما نيل من الدنيا؛ ومنه قوله تعالى: "تريدون عرض الدنيا "[الأنفال: 67] وجمعه عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض الإنسان من مرض أو نحوه وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كثر. والعرض من الأثاث ما كان غير نقد. وأعرض الشيء إذا ظهر وأمكن. والعرض خلاف الطول.
قوله تعالى: "فعند الله مغانم كثيرة" عدة من الله تعالى بما يأتي به على وجهه ومن حله دون ارتكاب محظور، أي فلا تتهافتوا. "كذلك كنتم من قبل "أي كذلك كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا منكم على أنفسكم حتى من الله عليكم بإعزاز الدين وغلبة المشركين، فهم الآن كذلك كل واحد منهم في قومه متربص أن يصل إليكم، فلا يصلح إذ وصل إليكم أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى كذلك كنتم كفرة "فمن الله عليكم "بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك ثم يسلم لحينه حين لقيكم فيجب أن تتثبتوا في أمره.
استدل بهذه الآية من قال: إن الإيمان هو القول، لقوله تعالى: "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا". قالوا: ولما منع أن يقال لمن قال لا إله إلا الله لست مؤمنا منع من قتلهم بمجرد القول. ولولا الإيمان الذي هو هذا القول لم يعب قولهم. قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعوذا فقتلوه، والله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) وليس في ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط؛ ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين حسب ما تقدم بيانه في "البقرة "وقد كشف البيان في هذا قوله عليه السلام: (أفلا شققت عن قلبه ) ؟ فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره، وأن حقيقته التصديق بالقلب، ولكن ليس للعبد طريق إليه إلا ما سمع منه فقط. واستدل بهذا أيضا من قال: إن الزنديق تقبل توبته إذا أظهر الإسلام؛ قال: لأن الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام. وقد مضى القول في هذا في أول البقرة. وفيها رد على القدرية، فإن الله تعالى أخبر أنه من على المؤمنين من بين جميع الخلق بأن خصهم بالتوفيق، والقدرية تقول: خلقهم كلهم للإيمان. ولو كان كما زعموا لما كان لاختصاص المؤمنين بالمنة من بين الخلق معنى.
قوله تعالى: "فتبينوا" أعاد الأمر بالتبيين للتأكيد. "إن الله كان بما تعملون خبيرا "تحذير عن مخالفة أمر الله؛ أي احفظوا أنفسكم وجنبوها الزلل الموبق لكم.










الصفحة رقم 93 من المصحف تحميل و استماع mp3