سورة النساء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
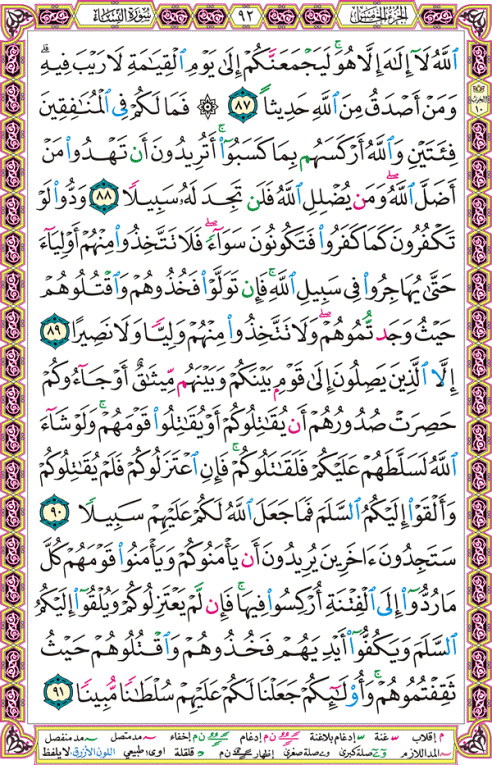
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 92 من المصحف
الآية: 87 {الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديث}
قوله تعالى: "الله لا إله إلا هو" ابتداء وخبر. واللام في قول "ليجمعنكم "لام القسم؛ نزلت في الذين شكوا في البعث فأقسم الله تعالى بنفسه. وكل لام بعدها نون مشددة فهو لام القسم. ومعناه في الموت وتحت الأرض "إلى يوم القيامة لا ريب فيه" وقال بعضهم: "إلى" صلة في الكلام، معناه ليجمعنكم يوم القيامة. وسميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين جل وعز؛ قال الله تعالى: "ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين" [المطففين: 4 - 6]. وقيل: سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: "يوم يخرجون من الأجداث سراعا "[المعارج: 43] وأصل القيامة الواو. "ومن أصدق من الله حديثا" نصب على البيان، والمعنى لا أحد أصدق من الله. وقرأ حمزة والكسائي "ومن أزدق" بالزاي. الباقون: بالصاد، وأصله الصاد إلا أن لقرب مخرجها جعل مكانها زاي.
الآية: 88 {فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل}
قوله تعالى: "فما لكم في المنافقين فئتين" "فئتين "أي فرقتين مختلفتين. روى مسلم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين؛ فقال بعضهم: نقتلهم. وقال بعضهم: لا؛ فنزلت "فما لكم في المنافقين فئتين". وأخرجه الترمذي فزاد: وقال: (إنها طيبة ) وقال: (إنها تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد ) قال: حديث حسن صحيح. وقال البخاري: (إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة ). والمعني بالمنافقين هنا عبدالله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا؛ كما تقدم في "آل عمران". وقال ابن عباس: هم فوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة، قال الضحاك: وقالوا إن ظهر محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد عرفنا، وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. فصار المسلمون فيهم فئتين قوم يتولونهم وقوم يتبرؤون منهم؛ فقال الله عز وجل: "فما لكم في المنافقين فئتين". وذكر أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه أنها نزلت في قوم جاؤوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام؛ فأصابهم وباء المدينة وحماها؛ فأركسوا فخرجوا من المدينة، فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما لكم رجعتم ؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فاجتويناها؛ فقالوا: ما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: لم ينافقوا، هم مسلمون؛ فأنزل الله عز وجل: "فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا "الآية. حتى جاؤوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون؛ فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم.
قلت: وهذان القولان يعضدهما سياق آخر الآية من قوله تعالى: "حتى يهاجروا" [النساء: 89]، والأول أصح نقلا، وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي. و"فئتين "نصب على الحال؛ كما يقال: مالك قائما ؟ عن الأخفش. وقال الكوفيون: هو خبر "ما لكم "كخبر كان وظننت، وأجازوا إدخال الألف واللام فيه وحكى الفراء: "أركسهم، وركسهم "أي ردهم إلى الكفر ونكسهم؛ وقال النضر بن شميل والكسائي: والركس والنكس قلب الشيء على رأسه، أو رد أوله على آخره، والمركوس المنكوس. وفي قراءة عبدالله وأبي رضي الله عنهما "والله ركسهم". وقال ابن رواحة:
أركسوا في فتنة مظلمة كسواد الليل يتلوها فتن
أي نكسوا. وارتكس فلان في أمر كان نجا منه. والركوسية قوم بين النصارى والصابئين. والراكس الثور وسط البدر والثيران حواليه حين الدياس. "أتريدون أن تهدوا من أضل الله" أي ترشدوه إلى الثواب بأن يحكم لهم بحكم المؤمنين. "فلن تجد له سبيلا" أي طريقا إلى الهدى والرشد وطلب الحجة. وفي هذا رد على القدرية وغيرهم القائلين بخلق هداهم وقد تقدم.
الآيتان: 89 - 90 {ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيل}
قوله تعالى: "ودوا لو تكفرون" أي تمنوا أن تكونوا كهم في الكفر والنفاق شرع سواء؛ فأمر الله تعالى بالبراءة منهم فقال: "فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا "؛ كما قال تعالى: "ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا "[الأنفال: 72] والهجرة أنواع: منها الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه واجبة أول الإسلام حتى قال: (لا هجرة بعد الفتح ). وكذلك هجرة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وهجره من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. وهجرة المسلم ما حرم الله عليه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه ). وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا لهم فلا يكلمون ولا يخالطون حتى يتوبوا؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه. "فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم "يقول: إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم. "حيث وجدتموهم" عام في الأماكن من حل وحرم. والله أعلم.
ثم استثنى فقال تعالى: "إلا الذين يصلون" استثناء أي يتصلون بهم ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف؛ المعنى: فلا تقتلوا قوما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد فإنهم على عهدهم ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا. هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم، وهو أصح ما قيل في معنى الآية. قال أبو عبيد: يصلون ينتسبون؛ ومنه قول الأعشى:
إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل وبكر سبتها والأنوف رواغم
يريد إذا انتسبت. قال المهدوي: وأنكره العلماء؛ لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار وقتلهم. وقال النحاس: وهذا غلط عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب، والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب، وأشد من هذا الجهل بأنه كان ثم نسخ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له "براءة "وإنما نزلت "براءة" بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب. وقال معناه الطبري.
قلت: حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي إن المنتسب إلى أهل الأمان آمن إذا أمن الكل منهم، لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق؛ فقيل: بنو مدلج. عن الحسن: كان بينهم وبين قريش عقد، وكان بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عويمر وسراقة بن جعشم وخزيمة بن عامر بن عبد مناف كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. وقيل: خزاعة. وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناة، كانوا في الصلح والهدنة.
في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين، على ما يأتي بيانه في "الأنفال وبراءة "إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: "أو جاؤوكم حصرت صدورهم" أي ضاقت. وقال لبيد:
أسهلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونها جرامها
أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلة؛ ومنه الحصر في القول وهو ضيق الكلام على المتكلم. والحصر الكتوم للسر؛ قال جرير:
ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا حصرا بسرك يا أميم ضنينا
ومعنى "حصرت "قد حصرت فأضمرت قد؛ قال الفراء: وهو حال من المضمر المرفوع في "جاؤوكم "كما تقول: جاء فلان ذهب عقله، أي قد ذهب عقله. وقيل: هو خبر بعد خبر قاله الزجاج. أي جاؤوكم ثم أخبر فقال: "حصرت صدورهم "فعلى هذا يكون "حصرت "بدلا من "جاؤوكم "كما قيل: "حصرت "في موضع خفض على النعت لقوم. وفي حرف أبي "إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم "ليس فيه "أو جاؤوكم". وقيل: تقديره أو جاؤوكم رجالا أو قوما حصرت صدورهم؛ فهي صفة موصوف منصوب على الحال. وقرأ الحسن "أو جاؤوكم حصرة صدورهم "نصب على الحال، ويجوز رفعه على الابتداء والخبر. وحكى "أو جاؤوكم حصرت صدورهم"، ويجوز الرفع. وقال محمد بن يزيد: "حصرت صدورهم "هو دعاء عليهم؛ كما تقول: لعن الله الكافر؛ وقال المبرد. وضعفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي ألا يقاتلوا قومهم؛ وذلك فاسد؛ لأنهم كفار وقومهم كفار. وأجيب بأن معناه صحيح، فيكون عدم القتال في حق المسلمين تعجيزا لهم، وفي حق قومهم تحقيرا لهم. وقيل: "أو "بمعنى الواو؛ كأنه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاؤوكم ضيقة صدورهم عن قتالكم والقتال معكم فكرهوا قتال الفريقين. ويحتمل أن يكونوا معاهدين على ذلك فهو نوع من العهد، أو قالوا نسلم ولا نقاتل؛ فيحتمل أن يقبل ذلك منهم في أول الإسلام حتى يفتح الله قلوبهم للتقوى ويشرحها للإسلام. والأول أظهر. والله أعلم. "أو يقاتلوا "في موضع نصب؛ أي عن أن يقاتلوكم.
قوله تعالى: "ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم" تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يقدرهم على ذلك ويقويهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبارا كما قال تعالى: "ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم" [محمد:31]، وإما تمحيصا للذنوب كما قال تعالى: "وليمحص الله الذين آمنوا "[آل عمران: 141] ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء. ووجه النظم والاتصال بما قبل أي اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجروا، وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون فيما دخلوا فيه فلهم حكمهم، وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم فلا تقتلوهم.
الآية: 91 {ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين}
قوله تعالى: "ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم" معناها معنى الآية الأولى. قال قتادة: نزلت في قوم من تهامة طلبوا الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مكة. وقال السدي: نزلت في نعيم بن مسعود كان يأمن المسلمين والمشركين. وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين. وقيل: نزلت في أسد وغطفان قدموا المدينة فأسلموا ثم رجعوا إلى ديارهم فأظهروا الكفر.
قوله تعالى: "كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها" قرأ يحيى بن وثاب والأعمش "ردوا "بكسر الراء؛ لأن الأصل "رددوا "فأدغم وقلبت الكسرة على الراء. "إلى الفتنة "أي الكفر "أركسوا فيها". وقيل: أي ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنوكم، وإذا سنحت لهم فتنة كان مع أهلها عليكم. ومعنى "أركسوا فيها "أي انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا. وقيل: أي إذا دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 92
92- تفسير الصفحة رقم92 من المصحفالآية: 87 {الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديث}
قوله تعالى: "الله لا إله إلا هو" ابتداء وخبر. واللام في قول "ليجمعنكم "لام القسم؛ نزلت في الذين شكوا في البعث فأقسم الله تعالى بنفسه. وكل لام بعدها نون مشددة فهو لام القسم. ومعناه في الموت وتحت الأرض "إلى يوم القيامة لا ريب فيه" وقال بعضهم: "إلى" صلة في الكلام، معناه ليجمعنكم يوم القيامة. وسميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين جل وعز؛ قال الله تعالى: "ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين" [المطففين: 4 - 6]. وقيل: سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: "يوم يخرجون من الأجداث سراعا "[المعارج: 43] وأصل القيامة الواو. "ومن أصدق من الله حديثا" نصب على البيان، والمعنى لا أحد أصدق من الله. وقرأ حمزة والكسائي "ومن أزدق" بالزاي. الباقون: بالصاد، وأصله الصاد إلا أن لقرب مخرجها جعل مكانها زاي.
الآية: 88 {فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل}
قوله تعالى: "فما لكم في المنافقين فئتين" "فئتين "أي فرقتين مختلفتين. روى مسلم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين؛ فقال بعضهم: نقتلهم. وقال بعضهم: لا؛ فنزلت "فما لكم في المنافقين فئتين". وأخرجه الترمذي فزاد: وقال: (إنها طيبة ) وقال: (إنها تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد ) قال: حديث حسن صحيح. وقال البخاري: (إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة ). والمعني بالمنافقين هنا عبدالله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا؛ كما تقدم في "آل عمران". وقال ابن عباس: هم فوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة، قال الضحاك: وقالوا إن ظهر محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد عرفنا، وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. فصار المسلمون فيهم فئتين قوم يتولونهم وقوم يتبرؤون منهم؛ فقال الله عز وجل: "فما لكم في المنافقين فئتين". وذكر أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه أنها نزلت في قوم جاؤوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام؛ فأصابهم وباء المدينة وحماها؛ فأركسوا فخرجوا من المدينة، فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما لكم رجعتم ؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فاجتويناها؛ فقالوا: ما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: لم ينافقوا، هم مسلمون؛ فأنزل الله عز وجل: "فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا "الآية. حتى جاؤوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون؛ فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم.
قلت: وهذان القولان يعضدهما سياق آخر الآية من قوله تعالى: "حتى يهاجروا" [النساء: 89]، والأول أصح نقلا، وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي. و"فئتين "نصب على الحال؛ كما يقال: مالك قائما ؟ عن الأخفش. وقال الكوفيون: هو خبر "ما لكم "كخبر كان وظننت، وأجازوا إدخال الألف واللام فيه وحكى الفراء: "أركسهم، وركسهم "أي ردهم إلى الكفر ونكسهم؛ وقال النضر بن شميل والكسائي: والركس والنكس قلب الشيء على رأسه، أو رد أوله على آخره، والمركوس المنكوس. وفي قراءة عبدالله وأبي رضي الله عنهما "والله ركسهم". وقال ابن رواحة:
أركسوا في فتنة مظلمة كسواد الليل يتلوها فتن
أي نكسوا. وارتكس فلان في أمر كان نجا منه. والركوسية قوم بين النصارى والصابئين. والراكس الثور وسط البدر والثيران حواليه حين الدياس. "أتريدون أن تهدوا من أضل الله" أي ترشدوه إلى الثواب بأن يحكم لهم بحكم المؤمنين. "فلن تجد له سبيلا" أي طريقا إلى الهدى والرشد وطلب الحجة. وفي هذا رد على القدرية وغيرهم القائلين بخلق هداهم وقد تقدم.
الآيتان: 89 - 90 {ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيل}
قوله تعالى: "ودوا لو تكفرون" أي تمنوا أن تكونوا كهم في الكفر والنفاق شرع سواء؛ فأمر الله تعالى بالبراءة منهم فقال: "فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا "؛ كما قال تعالى: "ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا "[الأنفال: 72] والهجرة أنواع: منها الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه واجبة أول الإسلام حتى قال: (لا هجرة بعد الفتح ). وكذلك هجرة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وهجره من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. وهجرة المسلم ما حرم الله عليه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه ). وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا لهم فلا يكلمون ولا يخالطون حتى يتوبوا؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه. "فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم "يقول: إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم. "حيث وجدتموهم" عام في الأماكن من حل وحرم. والله أعلم.
ثم استثنى فقال تعالى: "إلا الذين يصلون" استثناء أي يتصلون بهم ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف؛ المعنى: فلا تقتلوا قوما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد فإنهم على عهدهم ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا. هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم، وهو أصح ما قيل في معنى الآية. قال أبو عبيد: يصلون ينتسبون؛ ومنه قول الأعشى:
إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل وبكر سبتها والأنوف رواغم
يريد إذا انتسبت. قال المهدوي: وأنكره العلماء؛ لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار وقتلهم. وقال النحاس: وهذا غلط عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب، والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب، وأشد من هذا الجهل بأنه كان ثم نسخ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له "براءة "وإنما نزلت "براءة" بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب. وقال معناه الطبري.
قلت: حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي إن المنتسب إلى أهل الأمان آمن إذا أمن الكل منهم، لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق؛ فقيل: بنو مدلج. عن الحسن: كان بينهم وبين قريش عقد، وكان بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عويمر وسراقة بن جعشم وخزيمة بن عامر بن عبد مناف كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. وقيل: خزاعة. وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناة، كانوا في الصلح والهدنة.
في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين، على ما يأتي بيانه في "الأنفال وبراءة "إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: "أو جاؤوكم حصرت صدورهم" أي ضاقت. وقال لبيد:
أسهلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونها جرامها
أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلة؛ ومنه الحصر في القول وهو ضيق الكلام على المتكلم. والحصر الكتوم للسر؛ قال جرير:
ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا حصرا بسرك يا أميم ضنينا
ومعنى "حصرت "قد حصرت فأضمرت قد؛ قال الفراء: وهو حال من المضمر المرفوع في "جاؤوكم "كما تقول: جاء فلان ذهب عقله، أي قد ذهب عقله. وقيل: هو خبر بعد خبر قاله الزجاج. أي جاؤوكم ثم أخبر فقال: "حصرت صدورهم "فعلى هذا يكون "حصرت "بدلا من "جاؤوكم "كما قيل: "حصرت "في موضع خفض على النعت لقوم. وفي حرف أبي "إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم "ليس فيه "أو جاؤوكم". وقيل: تقديره أو جاؤوكم رجالا أو قوما حصرت صدورهم؛ فهي صفة موصوف منصوب على الحال. وقرأ الحسن "أو جاؤوكم حصرة صدورهم "نصب على الحال، ويجوز رفعه على الابتداء والخبر. وحكى "أو جاؤوكم حصرت صدورهم"، ويجوز الرفع. وقال محمد بن يزيد: "حصرت صدورهم "هو دعاء عليهم؛ كما تقول: لعن الله الكافر؛ وقال المبرد. وضعفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي ألا يقاتلوا قومهم؛ وذلك فاسد؛ لأنهم كفار وقومهم كفار. وأجيب بأن معناه صحيح، فيكون عدم القتال في حق المسلمين تعجيزا لهم، وفي حق قومهم تحقيرا لهم. وقيل: "أو "بمعنى الواو؛ كأنه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاؤوكم ضيقة صدورهم عن قتالكم والقتال معكم فكرهوا قتال الفريقين. ويحتمل أن يكونوا معاهدين على ذلك فهو نوع من العهد، أو قالوا نسلم ولا نقاتل؛ فيحتمل أن يقبل ذلك منهم في أول الإسلام حتى يفتح الله قلوبهم للتقوى ويشرحها للإسلام. والأول أظهر. والله أعلم. "أو يقاتلوا "في موضع نصب؛ أي عن أن يقاتلوكم.
قوله تعالى: "ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم" تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يقدرهم على ذلك ويقويهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبارا كما قال تعالى: "ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم" [محمد:31]، وإما تمحيصا للذنوب كما قال تعالى: "وليمحص الله الذين آمنوا "[آل عمران: 141] ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء. ووجه النظم والاتصال بما قبل أي اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجروا، وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون فيما دخلوا فيه فلهم حكمهم، وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم فلا تقتلوهم.
الآية: 91 {ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين}
قوله تعالى: "ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم" معناها معنى الآية الأولى. قال قتادة: نزلت في قوم من تهامة طلبوا الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مكة. وقال السدي: نزلت في نعيم بن مسعود كان يأمن المسلمين والمشركين. وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين. وقيل: نزلت في أسد وغطفان قدموا المدينة فأسلموا ثم رجعوا إلى ديارهم فأظهروا الكفر.
قوله تعالى: "كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها" قرأ يحيى بن وثاب والأعمش "ردوا "بكسر الراء؛ لأن الأصل "رددوا "فأدغم وقلبت الكسرة على الراء. "إلى الفتنة "أي الكفر "أركسوا فيها". وقيل: أي ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنوكم، وإذا سنحت لهم فتنة كان مع أهلها عليكم. ومعنى "أركسوا فيها "أي انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا. وقيل: أي إذا دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه.










الصفحة رقم 92 من المصحف تحميل و استماع mp3