سورة النساء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
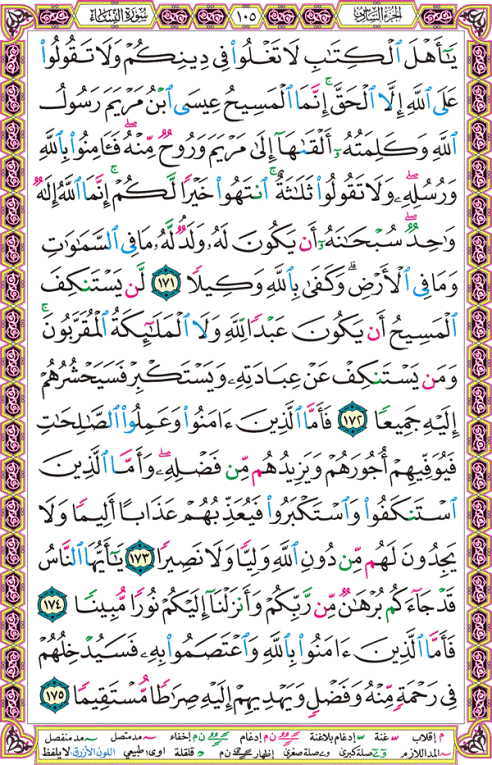
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 105 من المصحف
الآية: 171 {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل}
قوله تعالى: "يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم" نهى عن الغلو. والغلو التجاوز في الحد؛ ومنه غلا السعر يغلو غلاء؛ وغلا الرجل في الأمر غلوا، وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها؛ ويعني بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم، وغلو النصارى فيه حتى جعلوه ربا؛ فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفر؛ ولذلك قال مطرف بن عبدالله: الحسنة بين سيئتين؛ وقال الشاعر:
وأوف ولا تستوف حقك كله وصافح فلم يستوف قط كريم
ولا تغل في شيء من الأمر وأقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم
وقال آخر:
عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا
وفي صحيح البخاري عنه عليه السلام: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبدالله ورسوله).
قوله تعالى: "ولا تقولوا على الله إلا الحق" أي لا تقولوا إن له شريكا أو ابنا. ثم بين تعالى حال عيسى عليه السلام وصفته فقال: "إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته"
وفيه ثلاث مسائل:
الأولى: قوله تعالى: "إنما المسيح" المسيح رفع بالابتداء؛ و"عيسى" بدل منه وكذا "ابن مريم". ويجوز أن يكون خبر الابتداء ويكون المعنى: إنما المسيح ابن مريم. ودل بقوله: "عيسى ابن مريم" على أن من كان منسوبا بوالدته كيف يكون إلها، وحق الإله أن يكون قديما لا محدثا. ويكون "رسول الله" خبرا بعد خبر.
الثانية: لم يذكر الله عز وجل امرأة وسماها باسمها في كتابه إلا مريم ابنة عمران؛ فإنه ذكر اسمها في نحو من ثلاثين موضعا لحكمة ذكرها بعض الأشياخ؛ فإن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ، ولا يبتذلون أسماءهن؛ بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك؛ فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر والتصريح بها؛ فلما قالت النصارى في مريم ما قالت، وفي ابنها صرح الله باسمها، ولم يكن عنها بالأموة والعبودية التي هي صفة لها؛ وأجرى الكلام على عادة العرب في ذكر إمائها.
الثالثة: اعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجب، فإذا تكرر اسمه منسوبا للام استشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفي الأب عنه، وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم الله. والله أعلم.
قوله تعالى: "وكلمته ألقاها إلى مريم" أي هو مكون بكلمة "كن" فكان بشرا من غير أب؛ والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه. وقيل: "كلمته" بشارة الله تعالى مريم عليها السلام، ورسالته إليها على لسان جبريل عليه السلام؛ وذلك قوله: "إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه" [آل عمران: 45]. وقيل: "الكلمة" ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى: "وصدقت بكلمات ربها" [التحريم: 12] و"ما نفدت كلمات الله" [لقمان: 27]. وكان لعيسى أربعة أسماء؛ المسيح وعيسى وكلمة وروح، وقيل غير هذا مما ليس في القرآن. ومعنى "ألقاها إلى مريم" أمر بها مريم.
قوله تعالى: "وروح منه" هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال؛ فقالوا: عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا؛ وعنه أجوبة ثمانية: الأول: قال أبي بن كعب: خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق؛ ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى عليه السلام؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم، فكان منه عيسى عليه السلام؛ فلهذا قال: "وروح منه". وقيل: هذه الإضافة للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: "وطهر بيتي للطائفين" [الحج: 26] ، وقيل: قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا، وتضاف إلى الله تعالى فيقال: هذا روح من الله أي من خلقه؛ كما يقال في النعمة إنها من الله. وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى فاستحق هذا الاسم. وقيل: يسمى روحا بسبب نفخة جبريل عليه السلام، ويسمى النفخ روحا؛ لأنه ريح يخرج من الروح. قال الشاعر - هو ذو الرمة:
فقلت له أرفعها إليك وأحيها بروحك وأقتته لها قيتة قدرا
وقد ورد أن جبريل نفخ في درع مريم فحملت منه بإذن الله؛ وعلى هذا يكون "وروح منه" معطوفا على المضمر الذي هو اسم الله في "ألقاها" التقدير: ألقى الله وجبريل الكلمة إلى مريم. وقيل: "روح منه" أي من خلقه؛ كما قال: "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه" [الجاثية: 13] أي من خلقه. وقيل: "روح منه" أي رحمة منه؛ فكان عيسى رحمة من الله لمن اتبعه؛ ومنه قوله تعالى: "وأيدهم بروح منه" [المجادلة: 22] أي برحمة، وقرئ: "فروح وريحان". وقيل: "وروح منه" وبرهان منه؛ وكان عيسى برهانا وحجة على قومه صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى: "فآمنوا بالله ورسله" أي آمنوا بأن الله إله واحد خالق المسيح ومرسله، وآمنوا برسله ومنهم عيسى فلا تجعلوه إلها. "ولا تقولوا" آلهتنا "ثلاثة" عن الزجاج. قال ابن عباس: يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وابنه. وقال الفراء وأبو عبيد: أي لا تقولوا هم ثلاثة؛ كقوله تعالى: "سيقولون ثلاثة" [الكهف: 22]. قال أبو علي: التقدير ولا تقولوا هو ثالث ثلاثة؛ فحذف المبتدأ والمضاف. والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث ويقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم؛ فيجعلون كل أقنوم إلها ويعنون بالأقانيم الوجود والحياة والعلم، وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس؛ فيعنون بالأب الوجود، وبالروح الحياة، وبالابن المسيح، في كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدين. ومحصول كلامهم يؤول إلى التمسك بأن عيسى إله بما كان يجريه الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات على حسب دواعيه وإرادته؛ وقالوا: قد علمنا خروج هذه الأمور عن مقدور البشر، فينبغي أن يكون المقتدر عليها موصوفا بالإلهية؛ فيقال لهم: لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقلا به كان تخليص نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته، وليس كذلك؛ فإن اعترفت النصارى بذلك فقد سقط قولهم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلا به؛ وإن لم يسلموا ذلك فلا حجة لهم أيضا؛ لأنهم معارضون بموسى عليه السلام، وما كان يجري على يديه من الأمور العظام، مثل قلب العصا ثعبانا، وفلق البحر واليد البيضاء والمن والسلوى، وغير ذلك؛ وكذلك ما جرى على يد الأنبياء؛ فإن أنكروا ذلك فننكر ما يدعونه هم أيضا من ظهوره على يد عيسى عليه السلام، فلا يمكنهم إثبات شيء من ذلك لعيسى؛ فإن طريق إثباته عندنا نصوص القرآن وهم ينكرون القرآن، ويكذبون من أتى به، فلا يمكنهم إثبات ذلك بأخبار التواتر. وقد قيل: إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سنة بعدما رفع عيسى؛ يصلون إلى القبلة؛ ويصومون شهر رمضان، حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود حرب، وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس، قتل جماعة من أصحاب عيسى فقال: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا وإلى النار مصيرنا، ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار؛ وإني أحتال فيهم فأضلهم فيدخلون النار؛ وكان له فرس يقال لها العقاب، فأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب وقال للنصارى: أنا بولس عدوكم قد نوديت من السماء أن ليست لك توبة إلا أن تتنصر، فأدخلوه في الكنيسة بيتا فأقام فيه سنة لا يخرج ليلا ولا نهارا حتى تعلم الإنجيل؛ فخرج وقال: نوديت من السماء أن الله قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه، ثم مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم نسطورا وأعلمه أن عيسى ابن مريم إله، ثم توجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنس ولا بجسم فتجسم ولكنه ابن الله. وعلم رجلا يقال له يعقوب ذلك؛ ثم دعا رجلا يقال له الملك فقال له؛ إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى؛ فلما استمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحدا واحدا وقال له: أنت خالصتي ولقد رأيت المسيح في النوم ورضي عني، وقال لكل واحد منهم: إني غدا أذبح نفسي وأتقرب بها، فأدع الناس إلى نحلتك، ثم دخل المذبح فذبح نفسه؛ فلما كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم الناس إلى نحلته، فتبع كل واحد منهم طائفة، فاقتتلوا واختلفوا إلى يومنا هذا، فجميع النصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فيما يقال؛ والله أعلم. وقد رويت هذه القصة في معنى قوله تعالى: "فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة" [المائدة: 14] وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: "انتهوا خيرا لكم" "خيرا" منصوب عند سيبويه بإضمار فعل؛ كأنه قال: ائتوا خيرا لكم، لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خير لهم؛ قال سيبويه: ومما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره "انتهوا خيرا لكم" لأنك إذا قلت: انته فأنت تخرجه من أمر وتدخله في أخر؛ وأنشد:
فواعديه سرحتي مالك أو الربا بينهما أسهلا
ومذهب أبي عبيدة: انتهوا يكن خيرا لكم؛ قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنه يضمر الشرط وجوابه، وهذا لا يوجد في كلام العرب. ومذهب الفراء أنه نعت لمصدر محذوف؛ قال علي بن سليمان: هذا خطأ فاحش؛ لأنه يكون المعنى: انتهوا الانتهاء الذي هو خير لكم.
قوله تعالى: "إنما الله إله واحد" هذا ابتداء وخبر؛ و"واحد" نعت له. ويجوز أن يكون "إله" بدلا من اسم الله عز وجل و"واحد" خبره؛ التقدير إنما المعبود واحد. "سبحانه أن يكون له ولد" أي تنزيها عن أن يكون له ولد؛ فلما سقط "عن" كان "أن" في محل النصب بنزع الخافض؛ أي كيف يكون له ولد ؟ وولد الرجل مشبه له، ولا شبيه لله عز وجل. "له ما في السماوات وما في الأرض" فلا شريك له، وعيسى ومريم من جملة ما في السموات وما في الأرض، وما فيهما مخلوق، فكيف يكون عيسى إلها وهو مخلوق ! وإن جاز ولد فليجز أولاد حتى يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولدا له. "وكفى بالله وكيلا" أي لأوليائه؛ وقد تقدم.
الآية: 172 - 173 {لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير}
قوله تعالى: "لن يستنكف المسيح" أي لن يأنف ولن يحتشم. "أن يكون عبدا لله" أي من أن يكون؛ فهو في موضع نصب. وقرأ الحسن: "إن يكون" بكسر الهمزة على أنها نفي هو بمعنى "ما" والمعنى ما يكون له ولد؛ وينبغي رفع يكون ولم يذكره الرواة. "ولا الملائكة المقربون" أي من رحمة الله ورضاه؛ فدل بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وكذا "ولا أقول إني ملك" [هود: 31] وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في "البقرة". "ومن يستنكف" أي يأنف "عن عبادته ويستكبر" فلا يفعلها. "فسيحشرهم إليه" أي إلى المحشر. "جميعا" فيجازي كلا بما يستحق، كما بينه في الآية بعد هذا "فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله" إلى قوله: "نصيرا". وأصل "يستنكف" نكف، فالياء والسين والتاء زوائد؛ يقال: نكفت من الشيء واستنكفت منه وأنكفته أي نزهته عما يستنكف منه؛ ومنه الحديث سئل عن "سبحان الله" فقال: (إنكاف الله من كل سوء) يعني تنزيهه وتقديسه عن الأنداد والأولاد. وقال الزجاج: استنكف أي أنف مأخوذ من نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك عن خدك، ومنه الحديث (ما ينكف العرق عن جبينه) أي ما ينقطع؛ ومنه الحديث (جاء بجيش لا ينكف آخره) أي لا ينقطع آخره. وقيل: هو من النكف وهو العيب؛ يقال: ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف أي عيب: أي لن يمتنع المسيح ولن يتنزه من العبودية ولن ينقطع عنها ولن يعيبها.
الآية: 174 {يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين}
قوله تعالى: "يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم" يعني محمدا صلى الله عليه وسلم؛ عن الثوري؛ وسماه برهانا لأن معه البرهان وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان ههنا الحجة؛ والمعنى متقارب؛ فإن المعجزات حجته صلى الله عليه وسلم. والنور المنزل هو القرآن؛ عن الحسن؛ وسماه نورا لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة، فهو نور مبين، أي واضح بين.
الآية: 175 {فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيم}
قوله تعالى: "فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به" أي بالقرآن عن معاصيه، وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به وبنبيه. وقيل: "اعتصموا به" أي بالله. والعصمة الامتناع، وقد تقدم.
قوله تعالى: "ويهديهم" أي وهو يهديهم؛ فأضمر هو ليدل على أن الكلام مقطوع مما قبله. "إليه" أي إلى ثوابه. وقيل: إلى الحق ليعرفوه. "صراطا مستقيما" أي دينا مستقيما. و"صراطا" منصوب بإضمار فعل دل عليه "ويهديهم" التقدير؛ ويعرفهم صراطا مستقيما. وقيل: هو مفعول ثان على تقدير؛ ويهديهم إلى ثوابه صراطا مستقيما. وقيل: هو حال. والهاء في "إليه" قيل: هي للقرآن، وقيل: للفضل، وقيل للفضل والرحمة؛ لأنهما بمعنى الثواب. وقيل: هي لله عز وجل على حذف المضاف كما تقدم من أن المعنى ويهديهم إلى ثوابه. أبو علي: الهاء راجعة إلى ما تقدم من اسم الله عز وجل، والمعنى ويهديهم إلى صراطه؛ فإذا جعلنا "صراطا مستقيما" نصبا على الحال كانت الحال من هذا المحذوف. وفي قوله: "وفضل" دليل على أنه تعالى يتفضل على عباده بثوابه؛ إذ لو كان في مقابلة العمل لما كان فضلا. والله أعلم.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 105
105- تفسير الصفحة رقم105 من المصحفالآية: 171 {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل}
قوله تعالى: "يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم" نهى عن الغلو. والغلو التجاوز في الحد؛ ومنه غلا السعر يغلو غلاء؛ وغلا الرجل في الأمر غلوا، وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها؛ ويعني بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم، وغلو النصارى فيه حتى جعلوه ربا؛ فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفر؛ ولذلك قال مطرف بن عبدالله: الحسنة بين سيئتين؛ وقال الشاعر:
وأوف ولا تستوف حقك كله وصافح فلم يستوف قط كريم
ولا تغل في شيء من الأمر وأقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم
وقال آخر:
عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا
وفي صحيح البخاري عنه عليه السلام: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبدالله ورسوله).
قوله تعالى: "ولا تقولوا على الله إلا الحق" أي لا تقولوا إن له شريكا أو ابنا. ثم بين تعالى حال عيسى عليه السلام وصفته فقال: "إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته"
وفيه ثلاث مسائل:
الأولى: قوله تعالى: "إنما المسيح" المسيح رفع بالابتداء؛ و"عيسى" بدل منه وكذا "ابن مريم". ويجوز أن يكون خبر الابتداء ويكون المعنى: إنما المسيح ابن مريم. ودل بقوله: "عيسى ابن مريم" على أن من كان منسوبا بوالدته كيف يكون إلها، وحق الإله أن يكون قديما لا محدثا. ويكون "رسول الله" خبرا بعد خبر.
الثانية: لم يذكر الله عز وجل امرأة وسماها باسمها في كتابه إلا مريم ابنة عمران؛ فإنه ذكر اسمها في نحو من ثلاثين موضعا لحكمة ذكرها بعض الأشياخ؛ فإن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ، ولا يبتذلون أسماءهن؛ بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك؛ فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر والتصريح بها؛ فلما قالت النصارى في مريم ما قالت، وفي ابنها صرح الله باسمها، ولم يكن عنها بالأموة والعبودية التي هي صفة لها؛ وأجرى الكلام على عادة العرب في ذكر إمائها.
الثالثة: اعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجب، فإذا تكرر اسمه منسوبا للام استشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفي الأب عنه، وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم الله. والله أعلم.
قوله تعالى: "وكلمته ألقاها إلى مريم" أي هو مكون بكلمة "كن" فكان بشرا من غير أب؛ والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه. وقيل: "كلمته" بشارة الله تعالى مريم عليها السلام، ورسالته إليها على لسان جبريل عليه السلام؛ وذلك قوله: "إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه" [آل عمران: 45]. وقيل: "الكلمة" ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى: "وصدقت بكلمات ربها" [التحريم: 12] و"ما نفدت كلمات الله" [لقمان: 27]. وكان لعيسى أربعة أسماء؛ المسيح وعيسى وكلمة وروح، وقيل غير هذا مما ليس في القرآن. ومعنى "ألقاها إلى مريم" أمر بها مريم.
قوله تعالى: "وروح منه" هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال؛ فقالوا: عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا؛ وعنه أجوبة ثمانية: الأول: قال أبي بن كعب: خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق؛ ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى عليه السلام؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم، فكان منه عيسى عليه السلام؛ فلهذا قال: "وروح منه". وقيل: هذه الإضافة للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: "وطهر بيتي للطائفين" [الحج: 26] ، وقيل: قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا، وتضاف إلى الله تعالى فيقال: هذا روح من الله أي من خلقه؛ كما يقال في النعمة إنها من الله. وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى فاستحق هذا الاسم. وقيل: يسمى روحا بسبب نفخة جبريل عليه السلام، ويسمى النفخ روحا؛ لأنه ريح يخرج من الروح. قال الشاعر - هو ذو الرمة:
فقلت له أرفعها إليك وأحيها بروحك وأقتته لها قيتة قدرا
وقد ورد أن جبريل نفخ في درع مريم فحملت منه بإذن الله؛ وعلى هذا يكون "وروح منه" معطوفا على المضمر الذي هو اسم الله في "ألقاها" التقدير: ألقى الله وجبريل الكلمة إلى مريم. وقيل: "روح منه" أي من خلقه؛ كما قال: "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه" [الجاثية: 13] أي من خلقه. وقيل: "روح منه" أي رحمة منه؛ فكان عيسى رحمة من الله لمن اتبعه؛ ومنه قوله تعالى: "وأيدهم بروح منه" [المجادلة: 22] أي برحمة، وقرئ: "فروح وريحان". وقيل: "وروح منه" وبرهان منه؛ وكان عيسى برهانا وحجة على قومه صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى: "فآمنوا بالله ورسله" أي آمنوا بأن الله إله واحد خالق المسيح ومرسله، وآمنوا برسله ومنهم عيسى فلا تجعلوه إلها. "ولا تقولوا" آلهتنا "ثلاثة" عن الزجاج. قال ابن عباس: يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وابنه. وقال الفراء وأبو عبيد: أي لا تقولوا هم ثلاثة؛ كقوله تعالى: "سيقولون ثلاثة" [الكهف: 22]. قال أبو علي: التقدير ولا تقولوا هو ثالث ثلاثة؛ فحذف المبتدأ والمضاف. والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث ويقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم؛ فيجعلون كل أقنوم إلها ويعنون بالأقانيم الوجود والحياة والعلم، وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس؛ فيعنون بالأب الوجود، وبالروح الحياة، وبالابن المسيح، في كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدين. ومحصول كلامهم يؤول إلى التمسك بأن عيسى إله بما كان يجريه الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات على حسب دواعيه وإرادته؛ وقالوا: قد علمنا خروج هذه الأمور عن مقدور البشر، فينبغي أن يكون المقتدر عليها موصوفا بالإلهية؛ فيقال لهم: لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقلا به كان تخليص نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته، وليس كذلك؛ فإن اعترفت النصارى بذلك فقد سقط قولهم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلا به؛ وإن لم يسلموا ذلك فلا حجة لهم أيضا؛ لأنهم معارضون بموسى عليه السلام، وما كان يجري على يديه من الأمور العظام، مثل قلب العصا ثعبانا، وفلق البحر واليد البيضاء والمن والسلوى، وغير ذلك؛ وكذلك ما جرى على يد الأنبياء؛ فإن أنكروا ذلك فننكر ما يدعونه هم أيضا من ظهوره على يد عيسى عليه السلام، فلا يمكنهم إثبات شيء من ذلك لعيسى؛ فإن طريق إثباته عندنا نصوص القرآن وهم ينكرون القرآن، ويكذبون من أتى به، فلا يمكنهم إثبات ذلك بأخبار التواتر. وقد قيل: إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سنة بعدما رفع عيسى؛ يصلون إلى القبلة؛ ويصومون شهر رمضان، حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود حرب، وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس، قتل جماعة من أصحاب عيسى فقال: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا وإلى النار مصيرنا، ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار؛ وإني أحتال فيهم فأضلهم فيدخلون النار؛ وكان له فرس يقال لها العقاب، فأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب وقال للنصارى: أنا بولس عدوكم قد نوديت من السماء أن ليست لك توبة إلا أن تتنصر، فأدخلوه في الكنيسة بيتا فأقام فيه سنة لا يخرج ليلا ولا نهارا حتى تعلم الإنجيل؛ فخرج وقال: نوديت من السماء أن الله قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه، ثم مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم نسطورا وأعلمه أن عيسى ابن مريم إله، ثم توجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنس ولا بجسم فتجسم ولكنه ابن الله. وعلم رجلا يقال له يعقوب ذلك؛ ثم دعا رجلا يقال له الملك فقال له؛ إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى؛ فلما استمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحدا واحدا وقال له: أنت خالصتي ولقد رأيت المسيح في النوم ورضي عني، وقال لكل واحد منهم: إني غدا أذبح نفسي وأتقرب بها، فأدع الناس إلى نحلتك، ثم دخل المذبح فذبح نفسه؛ فلما كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم الناس إلى نحلته، فتبع كل واحد منهم طائفة، فاقتتلوا واختلفوا إلى يومنا هذا، فجميع النصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فيما يقال؛ والله أعلم. وقد رويت هذه القصة في معنى قوله تعالى: "فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة" [المائدة: 14] وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: "انتهوا خيرا لكم" "خيرا" منصوب عند سيبويه بإضمار فعل؛ كأنه قال: ائتوا خيرا لكم، لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خير لهم؛ قال سيبويه: ومما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره "انتهوا خيرا لكم" لأنك إذا قلت: انته فأنت تخرجه من أمر وتدخله في أخر؛ وأنشد:
فواعديه سرحتي مالك أو الربا بينهما أسهلا
ومذهب أبي عبيدة: انتهوا يكن خيرا لكم؛ قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنه يضمر الشرط وجوابه، وهذا لا يوجد في كلام العرب. ومذهب الفراء أنه نعت لمصدر محذوف؛ قال علي بن سليمان: هذا خطأ فاحش؛ لأنه يكون المعنى: انتهوا الانتهاء الذي هو خير لكم.
قوله تعالى: "إنما الله إله واحد" هذا ابتداء وخبر؛ و"واحد" نعت له. ويجوز أن يكون "إله" بدلا من اسم الله عز وجل و"واحد" خبره؛ التقدير إنما المعبود واحد. "سبحانه أن يكون له ولد" أي تنزيها عن أن يكون له ولد؛ فلما سقط "عن" كان "أن" في محل النصب بنزع الخافض؛ أي كيف يكون له ولد ؟ وولد الرجل مشبه له، ولا شبيه لله عز وجل. "له ما في السماوات وما في الأرض" فلا شريك له، وعيسى ومريم من جملة ما في السموات وما في الأرض، وما فيهما مخلوق، فكيف يكون عيسى إلها وهو مخلوق ! وإن جاز ولد فليجز أولاد حتى يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولدا له. "وكفى بالله وكيلا" أي لأوليائه؛ وقد تقدم.
الآية: 172 - 173 {لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير}
قوله تعالى: "لن يستنكف المسيح" أي لن يأنف ولن يحتشم. "أن يكون عبدا لله" أي من أن يكون؛ فهو في موضع نصب. وقرأ الحسن: "إن يكون" بكسر الهمزة على أنها نفي هو بمعنى "ما" والمعنى ما يكون له ولد؛ وينبغي رفع يكون ولم يذكره الرواة. "ولا الملائكة المقربون" أي من رحمة الله ورضاه؛ فدل بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وكذا "ولا أقول إني ملك" [هود: 31] وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في "البقرة". "ومن يستنكف" أي يأنف "عن عبادته ويستكبر" فلا يفعلها. "فسيحشرهم إليه" أي إلى المحشر. "جميعا" فيجازي كلا بما يستحق، كما بينه في الآية بعد هذا "فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله" إلى قوله: "نصيرا". وأصل "يستنكف" نكف، فالياء والسين والتاء زوائد؛ يقال: نكفت من الشيء واستنكفت منه وأنكفته أي نزهته عما يستنكف منه؛ ومنه الحديث سئل عن "سبحان الله" فقال: (إنكاف الله من كل سوء) يعني تنزيهه وتقديسه عن الأنداد والأولاد. وقال الزجاج: استنكف أي أنف مأخوذ من نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك عن خدك، ومنه الحديث (ما ينكف العرق عن جبينه) أي ما ينقطع؛ ومنه الحديث (جاء بجيش لا ينكف آخره) أي لا ينقطع آخره. وقيل: هو من النكف وهو العيب؛ يقال: ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف أي عيب: أي لن يمتنع المسيح ولن يتنزه من العبودية ولن ينقطع عنها ولن يعيبها.
الآية: 174 {يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين}
قوله تعالى: "يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم" يعني محمدا صلى الله عليه وسلم؛ عن الثوري؛ وسماه برهانا لأن معه البرهان وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان ههنا الحجة؛ والمعنى متقارب؛ فإن المعجزات حجته صلى الله عليه وسلم. والنور المنزل هو القرآن؛ عن الحسن؛ وسماه نورا لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة، فهو نور مبين، أي واضح بين.
الآية: 175 {فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيم}
قوله تعالى: "فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به" أي بالقرآن عن معاصيه، وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به وبنبيه. وقيل: "اعتصموا به" أي بالله. والعصمة الامتناع، وقد تقدم.
قوله تعالى: "ويهديهم" أي وهو يهديهم؛ فأضمر هو ليدل على أن الكلام مقطوع مما قبله. "إليه" أي إلى ثوابه. وقيل: إلى الحق ليعرفوه. "صراطا مستقيما" أي دينا مستقيما. و"صراطا" منصوب بإضمار فعل دل عليه "ويهديهم" التقدير؛ ويعرفهم صراطا مستقيما. وقيل: هو مفعول ثان على تقدير؛ ويهديهم إلى ثوابه صراطا مستقيما. وقيل: هو حال. والهاء في "إليه" قيل: هي للقرآن، وقيل: للفضل، وقيل للفضل والرحمة؛ لأنهما بمعنى الثواب. وقيل: هي لله عز وجل على حذف المضاف كما تقدم من أن المعنى ويهديهم إلى ثوابه. أبو علي: الهاء راجعة إلى ما تقدم من اسم الله عز وجل، والمعنى ويهديهم إلى صراطه؛ فإذا جعلنا "صراطا مستقيما" نصبا على الحال كانت الحال من هذا المحذوف. وفي قوله: "وفضل" دليل على أنه تعالى يتفضل على عباده بثوابه؛ إذ لو كان في مقابلة العمل لما كان فضلا. والله أعلم.










الصفحة رقم 105 من المصحف تحميل و استماع mp3