سورة البقرة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
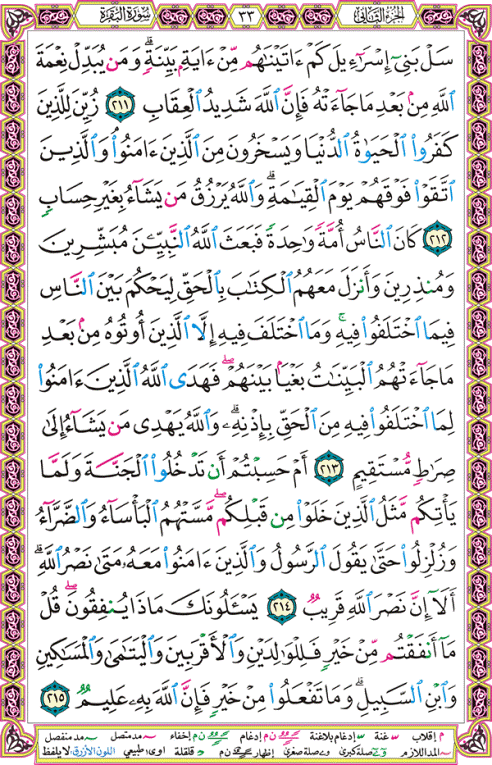
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 33 من المصحف
الآية: 211 {سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب}
قوله تعالى: "سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة" "سل" من السؤال: بتخفيف الهمزة، فلما تحركت السين لم يحتج إلى ألف الوصل. وقيل: إن للعرب في سقوط ألف الوصل في، "سل" وثبوتها في "واسأل" وجهين:
أحدهما - حذفها في إحداهما وثبوتها في الأخرى، وجاء القرآن بهما، فاتبع خط المصحف في إثباته للهمزة وإسقاطها.
والوجه الثاني - أنه يختلف إثباتها وإسقاطها باختلاف الكلام المستعمل فيه، فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأ، مثل قوله: "سل بني إسرائيل"، وقوله: "سلهم أيهم بذلك زعيم" [ن : 40]. وثبت في العطف، مثل قوله: "واسأل القرية" [يوسف: 82]، "واسألوا الله من فضله" [النساء: 32] قاله علي بن عيسى. وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس عنه "اسأل" على الأصل. وقرأ قوم "اسل" على نقل الحركة إلى السين وإبقاء ألف الوصل، على لغة من قال: الاحمر. و"كم" في موضع نصب، لأنها مفعول ثان لآتيناهم. وقيل: بفعل مضمر، تقديره كم آتينا آتيناهم. ولا يجوز أن يتقدمها الفعل لأن لها صدر الكلام. "من آية" في موضع نصب على التمييز على التقدير الأول، وعلى الثاني مفعول ثان لآتيناهم، ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء، والخبر في آتيناهم، ويصير فيه عائد على كم، تقديره: كم آتيناهموه، ولم يعرب وهي اسم لأنها بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى الاستفهام، وإذا فرقت بين كم وبين الاسم كان الاختيار أن تأتي بمن كما في هذه الآية، فإن حذفتها نصبت في الاستفهام والخبر، ويجوز الخفض في الخبر كما قال الشاعر:
كم بجود مقرف نال العلا وكريم بخله قد وضعه
والمراد بالآية كم جاءهم في أمر محمد عليه السلام من آية معرفة به دالة عليه. قال مجاهد والحسن وغيرهما: يعني الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام من فلق البحر والظلل من الغمام والعصا واليد وغير ذلك. وأمر الله تعالى نبيه بسؤالهم على جهة التقريع لهم والتوبيخ.
قوله تعالى: "ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته" لفظ عام لجميع العامة، وإن كان المشار إليه بني إسرائيل، لكونهم بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاللفظ منسحب على كل مبدل نعمة الله تعالى. وقال الطبري: النعمة هنا الإسلام، وهذا قريب من الأول. ويدخل في اللفظ أيضا كفار قريش، فإن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم نعمة عليهم، فبدلوا قبولها والشكر عليها كفرا.
قوله تعالى: "فإن الله شديد العقاب" خبر يتضمن الوعيد. والعقاب مأخوذ من العقب، كأن المعاقب يمشي بالمجازاة له في آثار عقبه، ومنه عقبة الراكب وعقبة القدر. فالعقاب والعقوبة يكونان بعقب الذنب، وقد عاقبه بذنبه.
الآية: 212 {زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب}
قوله تعالى: "زين للذين كفروا الحياة الدنيا" على ما لم يسم فاعله. والمراد رؤساء قريش. وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل. قال النحاس: وهي قراءة شاذة، لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر. وقرأ ابن أبي عبلة: "زينت" بإظهار العلامة، وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقي، والمزين هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر، ويزينها أيضا الشيطان بوسوسته وإغوائه. وخص الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيين جملة، وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة بسببها. وقد جعل الله ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا، فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع لم تفتنهم الزينة، والكفار تملكتهم لأنهم لا يعتقدون غيرها. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قدم عليه بالمال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا.
قوله تعالى: "ويسخرون من الذين آمنوا" إشارة إلى كفار قريش، فإنهم كانوا يعظمون حالهم من الدنيا ويغتبطون بها، ويسخرون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: في طلبهم الآخرة. وقيل: لفقرهم وإقلالهم، كبلال وصهيب وابن مسعود وغيرهم، رضي الله عنهم، فنبه سبحانه على خفض منزلتهم لقبيح فعلهم بقوله: "والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة". وروى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من استذل مؤمنا أو مؤمنة أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم فضحه ومن بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة حتى يخرج مما قال فيه وإن عظم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة وإن الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله وولده). ثم قيل: معنى "والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة" أي في الدرجة، لأنهم في الجنة والكفار في النار. ويحتمل أن يراد بالفوق المكان، من حيث إن الجنة في السماء، والنار في أسفل السافلين. ويحتمل أن يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفار، فإنهم يقولون: وإن كان معاد فلنا فيه الحظ أكثر مما لكم، ومنه حديث خباب مع العاص بن وائل، قال خباب: كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له: إني لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد، الحديث. وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى. ويقال: سخرت منه وسخرت به، وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وبه، كل ذلك يقال، حكاه الأخفش. والاسم السخرية والسخري والسخري، وقرئ بهما قوله تعالى: "ليتخذ بعضهم بعضا سخريا" [الزخرف: 32] وقوله: "فاتخذتموهم سخريا" [المؤمنون: 110]. ورجل سخرة. يسخر منه، وسخرة - بفتح الخاء - يسخر من الناس. وفلان سخرة يتسخر في العمل، يقال: خادمه سخرة، وسخره تسخيرا كلفه عملا بلا أجرة.
قوله تعالى: "والله يرزق من يشاء بغير حساب" قال الضحاك: يعني من غير تبعة في الآخرة. وقيل: هو إشارة إلى هؤلاء المستضعفين، أي يرزقهم علو المنزلة، فالآية تنبيه على عظيم النعمة عليهم. وجعل رزقهم بغير حساب من حيث هو دائم لا يتناهى، فهو لا ينعد. وقيل: إن قوله: "بغير حساب" صفة لرزق الله تعالى كيف يصرف، إذ هو جلت قدرته لا ينفق بعد، ففضله كله بغير حساب، والذي بحساب ما كان على عمل قدمه العبد، قال الله تعالى: "جزاء من ربك عطاء حسابا" [النبأ: 36]. والله أعلم. ويحتمل أن يكون المعنى بغير احتساب من المرزوقين، كما قال: "ويرزقه من حيث لا يحتسب" [الطلاق: 3].
الآية: 213 {كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم}
قوله تعالى: "كان الناس أمة واحدة" أي على دين واحد. قال أبي بن كعب، وابن زيد: المراد بالناس بنو آدم حين أخرجهم الله نسما من ظهر آدم فأقروا له بالوحدانية. وقال مجاهد: الناس آدم وحده، وسمي الواحد بلفظ الجمع لأنه أصل النسل. وقيل: آدم وحواء. وقال ابن عباس وقتادة: (المراد بالناس القرون التي كانت بين آدم ونوح، وهي عشرة كانوا على الحق حتى اختلفوا فبعث الله نوحا فمن بعده). وقال ابن أبي خيثمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنة. وقيل: أكثر من ذلك، وكان بينه وبين نوح ألف سنة ومائتا سنة. وعاش آدم تسعمائة وستين سنة، وكان الناس في زمانه أهل ملة واحدة، متمسكين بالدين، تصافحهم الملائكة، وداموا على ذلك إلى أن رفع إدريس عليه السلام فاختلفوا. وهذا فيه نظر، لأن إدريس بعد نوح على الصحيح. وقال قوم منهم الكلبي الواقدي: المراد نوح ومن في السفينة، وكانوا مسلمين ثم بعد وفاة نوح اختلفوا. وقال ابن عباس أيضا: (كانوا أمة واحدة على الكفر، يريد في مدة نوح حين بعثه الله). وعنه أيضا: كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة، كلهم كفار، وولد إبراهيم في جاهلية، فبعث الله تعالى إبراهيم وغيره من النبيين. فـ "كان" على هذه الأقوال على بابها من المضي المنقضي. وكل من قدر الناس في الآية مؤمنين قدر في الكلام فاختلفوا فبعث، ودل على هذا الحذف: "وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه" أي كان الناس على دين الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين، مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى. وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة النبيين إليهم. ويحتمل أن تكون "كان" للثبوت، والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع، وجهلهم بالحقائق، لولا من الله عليهم، وتفضله بالرسل إليهم. فلا يختص "كان" على هذا التأويل بالمضي فقط، بل معناه معنى قوله: "وكان الله غفورا رحيما" [النساء: 96، 100، 152]. و"أمة" مأخوذة من قولهم: أممت كذا، أي قصدته، فمعنى "أمة" مقصدهم واحد، ويقال للواحد: أمة، أي مقصده غير مقصد الناس، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قس بن ساعدة: (يحشر يوم القيامة أمة وحده). وكذلك قال في زيد بن عمرو بن نفيل. والأمة القامة، كأنها مقصد سائر البدن. والأمة (بالكسر): النعمة، لأن الناس يقصدون قصدها. وقيل: إمام، لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل، عن النحاس. وقرأ أبي بن كعب: "كان البشر أمة واحدة" وقرأ ابن مسعود "كان الناس أمة واحدة فاختلفوا".
قوله تعالى: "فبعث الله النبيين" وجملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفا، والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، والمذكورون في القرآن بالاسم العلم ثمانية عشر، وأول الرسل آدم، على ما جاء في حديث أبي ذر، أخرجه الآجري وأبو حاتم البستي. وقيل: نوح، لحديث الشفاعة، فإن الناس يقولون له: أنت أول الرسل. وقيل: إدريس، وسيأتي بيان هذا في "الأعراف" إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: "مبشرين ومنذرين" نصب على الحال. "وأنزل معهم الكتاب" اسم جنس بمعنى الكتب. وقال الطبري: الألف واللام في الكتاب للعهد، والمراد التوراة. و"ليحكم" مسند إلى الكتاب في قول الجمهور، وهو نصب بإضمار أن، أي لأن يحكم وهو مجاز مثل "هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق" [الجاثية: 29]. وقيل: أي ليحكم كل نبي بكتابه، وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتاب. وقراءة عاصم الجحدري "ليحكم بين الناس" على ما لم يسم فاعله، وهي قراءة شاذة، لأنه قد تقدم ذكر الكتاب. وقيل: المعنى ليحكم الله، والضمير في "فيه" عائد على "ما" من قوله: "فيما" والضمير في "فيه" الثانية يحتمل أن يعود على الكتاب، أي وما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه. موضع "الذين" رفع بفعلهم. و"أتوه" بمعنى أعطوه. وقيل: يعود على المنزل عليه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قاله الزجاج. أي وما اختلف في النبي عليه السلام إلا الذين أعطوا علمه. "بغيا بينهم" نصب على المفعول له، أي لم يختلفوا إلا للبغي، وقد تقدم معناه. وفي هذا تنبيه على السفه في فعلهم، والقبح الذي واقعوه. و"هدى" معناه أرشد، أي فهدى الله أمة محمد إلى الحق بأن بين لهم ما اختلف فيه من كان قبلهم. وقالت طائفة: معنى الآية أن الأمم كذب بعضهم كتاب بعض، فهدى الله تعالى أمة محمد للتصديق بجميعها. وقالت طائفة: إن الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه أهل الكتابين، من قولهم: إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. وقال ابن زيد وزيد بن أسلم: من قبلتهم، فإن اليهود إلى بيت المقدس، والنصارى إلى المشرق، ومن يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليهود غد وللنصارى بعد غد) ومن صيامهم، ومن جميع ما اختلفوا فيه.
وقال ابن زيد: واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود لفرية، وجعلته النصارى ربا، فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه عبدا لله. وقال الفراء: هو من المقلوب - واختاره الطبري - قال: وتقديره فهدى الله الذين آمنوا للحق لما اختلفوا فيه. قال ابن عطية: ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه، وعساه غير الحق في نفسه، نحا إلى هذا الطبري في حكايته عن الفراء، وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر، وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ووصفه، لأن قوله: "فهدى" يقتضي أنهم أصابوا الحق وتم المعنى في قوله: "فيه" وتبين بقوله: "من الحق" جنس ما وقع الخلاف فيه، قال المهدوي: وقدم لفظ الاختلاف على لفظ الحق اهتماما، إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية: وليس هذا عندي بقوي. وفي قراءة عبدالله بن مسعود "لما اختلفوا عنه من الحق" أي عن الإسلام. و"بإذنه" قال الزجاج: معناه بعلمه. قال النحاس: وهذا غلط، والمعنى بأمره، وإذا أذنت في الشيء فقد أمرت به، أي فهدى الله الذين آمنوا بأن أمرهم بما يجب أن يستعملوه. وفي قوله: "والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم" رد على المعتزلة في قولهم: إن العبد يستبد بهداية نفسه.
الآية: 214 {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب}
قوله تعالى: "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة" "حسبتم" معناه ظننتم. قال قتادة والسدي وأكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة، والحر والبرد، وسوء العيش، وأنواع الشدائد، وكان كما قال الله تعالى: "وبلغت القلوب الحناجر" [الأحزاب: 10]. وقيل: نزلت في حرب أحد، نظيرها - في آل عمران - "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم" [آل عمران: 142]. وقالت فرقة: نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم من الأغنياء النفاق، فأنزل الله تعالى تطييبا لقلوبهم "أم حسبتم". و"أم" هنا منقطعة، بمعنى بل، وحكى بعض اللغويين أنها قد تجيء بمثابة ألف الاستفهام ليبتدأ بها، و"حسبتم" تطلب مفعولين، فقال النحاة: "أن تدخلوا" تسد مسد المفعولين. وقيل: المفعول الثاني محذوف: أحسبتم دخولكم الجنة واقعا. و"لما" بمعنى لم. و"مثل" معناه شبه، أي ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلكم فتصبروا كما صبروا. وحكى النضر بن شميل أن "مثل" يكون بمعنى صفة، ويجوز أن يكون المعنى: ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين من قبلكم، أي من البلاء. قال وهب: وجد فيما بين مكة والطائف سبعون نبيا موتى، كان سبب موتهم الجوع والقمل، ونظير هذه الآية "الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم" [العنكبوت: 1 - 2 - 3] على ما يأتي، فاستدعاهم تعالى إلى الصبر، ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: "ألا إن نصر الله قريب". والزلزلة: شدة التحريك، تكون في الأشخاص وفي الأحوال، يقال: زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا - بالكسر - فتزلزلت إذا تحركت واضطربت، فمعنى "زلزلوا" خوفوا وحركوا. والزلزال - بالفتح - الاسم. والزلازل: الشدائد. وقال الزجاج: أصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه، فإذا قلت: زلزلته فمعناه كررت زلله من مكانه. ومذهب سيبويه أن زلزل رباعي كدحرج. وقرأ نافع "حتى يقول" بالرفع، والباقون بالنصب. ومذهب سيبويه في "حتى" أن النصب فيما بعدها من جهتين والرفع من جهتين، تقول: سرت حتى أدخل المدينة - بالنصب - على أن السير والدخول جميعا قد مضيا، أي سرت إلى أن أدخلها، وهذه غاية، وعليه قراءة من قرأ بالنصب. والوجه الآخر في النصب في غير الآية سرت حتى أدخلها، أي كي أدخلها. والوجهان في الرفع سرت حتى أدخلها، أي سرت فأدخلها، وقد مضيا جميعا، أي كنت سرت فدخلت. ولا تعمل حتى ههنا بإضمار أن، لأن بعدها جملة، كما قال الفرزدق:
فيا عجبا حتى كليب تسبني
قال النحاس: فعلى هذا القراءة بالرفع أبين وأصح معنى، أي وزلزلوا حتى الرسول يقول، أي حتى هذه حاله، لأن القول إنما كان عن الزلزلة غير منقطع منها، والنصب على الغاية ليس فيه هذا المعنى. والرسول هنا شعيا في قول مقاتل، وهو اليسع. وقال الكلبي: هذا في كل رسول بعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى نصر الله؟. وروي عن الضحاك قال: يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وعليه يدل نزول الآية، والله أعلم. والوجه الآخر في غير الآية سرت حتى أدخلها، على أن يكون السير قد مضى والدخول الآن. وحكى سيبويه: مرض حتى لا يرجونه، أي هو الآن لا يرجى، ومثله سرت حتى أدخلها لا أمنع. وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابن محيصن وشيبة. وبالنصب قرأ الحسن وأبو جعفر وابن أبي إسحاق وشبل وغيرهم. قال مكي: وهو الاختيار، لأن جماعة القراء عليه. وقرأ الأعمش: "وزلزلوا ويقول الرسول" بالواو بدل حتى. وفي مصحف ابن مسعود: "وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول". وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين، أي بلغ الجهد بهم حتى استبطؤوا النصر، فقال الله تعالى: "ألا إن نصر الله قريب". ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شك وارتياب. والرسول اسم جنس. وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله، فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب، فقدم الرسول في الرتبة لمكانته، ثم قدم قول المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان. قال ابن عطية: وهذا تحكم، وحمل الكلام على وجهه غير متعذر. ويحتمل أن يكون "ألا إن نصر الله قريب" إخبارا من الله تعالى مؤتنفا بعد تمام ذكر القول.
قوله تعالى: "متى نصر الله" رفع بالابتداء على قول سيبويه، وعلى قول أبي العباس رفع بفعل، أي متى يقع نصر الله. و"قريب" خبر "إن". قال النحاس: ويجوز في غير القرآن "قريبا" أي مكانا قريبا. و"قريب" لا تثنيه العرب ولا تجمعه ولا تؤنثه في هذا المعنى، قال الله عز وجل: "إن رحمة الله قريب من المحسنين" [الأعراف: 56]. وقال الشاعر:
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا بسباسة بنة يشكرا
فإن قلت: فلان قريب لي ثنيت وجمعت، فقلت: قريبون وأقرباء وقرباء.
الآية: 215 {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم}
قوله تعالى: "يسألونك" إن خففت الهمزة ألقيت حركتها على السين ففتحها وحذفت الهمزة فقلت: يسلونك. ونزلت الآية في عمرو بن الجموح، وكان شيخا كبيرا فقال: يا رسول الله، إن مالي كثير، فبماذا أتصدق، وعلى من أنفق؟ فنزلت "يسألونك ماذا ينفقون".
قوله تعالى: "ماذا ينفقون" "ما" في موضع رفع بالابتداء، و"ذا" الخبر، وهو بمعنى الذي، وحذفت الهاء لطول الاسم، أي ما الذي ينفقونه، وإن شئت كانت "ما" في موضع نصب بـ "ينفقون" و"ذا" مع "ما" بمنزلة شيء واحد ولا يحتاج إلى ضمير، ومتى كانت اسما مركبا فهي في موضع نصب، إلا ما جاء في قول الشاعر:
وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق
فإن "عسى" لا تعمل فيه، فـ "ماذا" في موضع رفع وهو مركب، إذ لا صلة لـ "ذا".
قيل: إن السائلين هم المؤمنون، والمعنى يسألونك ما هي الوجوه التي ينفقون فيها، وأين يضعون ما لزم إنفاقه. قال السدي: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة. قال ابن عطية: ووهم المهدوي على السدي في هذا، فنسب إليه أنه قال: إن الآية في الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان. وقال ابن جريج وغيره: هي ندب، والزكاة غير هذا الإنفاق، فعلى هذا لا نسخ فيها، وهي مبينة لمصارف صدقة التطوع، فواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله، من طعام وكسوة وغير ذلك. قال مالك، ليس عليه أن يزوج أباه، وعليه أن ينفق على امرأة أبيه، كانت أمه أو أجنبية، وإنما قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباه لأنه رآه يستغني عن التزويج غالبا، ولو احتاج حاجة ماسة لوجب أن يزوجه، ولولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليهما. فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه ما يحج به أو يغزو، وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر، لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام.
قوله تعالى: "قل ما أنفقتم" "ما" في موضع نصب بـ "أنفقتم" وكذا "وما تنفقوا" وهو شرط والجواب "فللوالدين"، وكذا "وما تفعلوا من خير" شرط، وجوابه "فإن الله به عليم" وقد مضى القول في اليتيم والمسكين وابن السبيل. ونظير هذه الآية قوله تعالى "فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل" [الروم: 38]. وقرأ علي بن أبي طالب "يفعلوا" بالياء على ذكر الغائب، وظاهر الآية الخبر، وهي تتضمن الوعد بالمجازاة.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 33
33- تفسير الصفحة رقم33 من المصحفالآية: 211 {سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب}
قوله تعالى: "سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة" "سل" من السؤال: بتخفيف الهمزة، فلما تحركت السين لم يحتج إلى ألف الوصل. وقيل: إن للعرب في سقوط ألف الوصل في، "سل" وثبوتها في "واسأل" وجهين:
أحدهما - حذفها في إحداهما وثبوتها في الأخرى، وجاء القرآن بهما، فاتبع خط المصحف في إثباته للهمزة وإسقاطها.
والوجه الثاني - أنه يختلف إثباتها وإسقاطها باختلاف الكلام المستعمل فيه، فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأ، مثل قوله: "سل بني إسرائيل"، وقوله: "سلهم أيهم بذلك زعيم" [ن : 40]. وثبت في العطف، مثل قوله: "واسأل القرية" [يوسف: 82]، "واسألوا الله من فضله" [النساء: 32] قاله علي بن عيسى. وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس عنه "اسأل" على الأصل. وقرأ قوم "اسل" على نقل الحركة إلى السين وإبقاء ألف الوصل، على لغة من قال: الاحمر. و"كم" في موضع نصب، لأنها مفعول ثان لآتيناهم. وقيل: بفعل مضمر، تقديره كم آتينا آتيناهم. ولا يجوز أن يتقدمها الفعل لأن لها صدر الكلام. "من آية" في موضع نصب على التمييز على التقدير الأول، وعلى الثاني مفعول ثان لآتيناهم، ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء، والخبر في آتيناهم، ويصير فيه عائد على كم، تقديره: كم آتيناهموه، ولم يعرب وهي اسم لأنها بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى الاستفهام، وإذا فرقت بين كم وبين الاسم كان الاختيار أن تأتي بمن كما في هذه الآية، فإن حذفتها نصبت في الاستفهام والخبر، ويجوز الخفض في الخبر كما قال الشاعر:
كم بجود مقرف نال العلا وكريم بخله قد وضعه
والمراد بالآية كم جاءهم في أمر محمد عليه السلام من آية معرفة به دالة عليه. قال مجاهد والحسن وغيرهما: يعني الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام من فلق البحر والظلل من الغمام والعصا واليد وغير ذلك. وأمر الله تعالى نبيه بسؤالهم على جهة التقريع لهم والتوبيخ.
قوله تعالى: "ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته" لفظ عام لجميع العامة، وإن كان المشار إليه بني إسرائيل، لكونهم بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاللفظ منسحب على كل مبدل نعمة الله تعالى. وقال الطبري: النعمة هنا الإسلام، وهذا قريب من الأول. ويدخل في اللفظ أيضا كفار قريش، فإن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم نعمة عليهم، فبدلوا قبولها والشكر عليها كفرا.
قوله تعالى: "فإن الله شديد العقاب" خبر يتضمن الوعيد. والعقاب مأخوذ من العقب، كأن المعاقب يمشي بالمجازاة له في آثار عقبه، ومنه عقبة الراكب وعقبة القدر. فالعقاب والعقوبة يكونان بعقب الذنب، وقد عاقبه بذنبه.
الآية: 212 {زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب}
قوله تعالى: "زين للذين كفروا الحياة الدنيا" على ما لم يسم فاعله. والمراد رؤساء قريش. وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل. قال النحاس: وهي قراءة شاذة، لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر. وقرأ ابن أبي عبلة: "زينت" بإظهار العلامة، وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقي، والمزين هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر، ويزينها أيضا الشيطان بوسوسته وإغوائه. وخص الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيين جملة، وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة بسببها. وقد جعل الله ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا، فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع لم تفتنهم الزينة، والكفار تملكتهم لأنهم لا يعتقدون غيرها. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قدم عليه بالمال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا.
قوله تعالى: "ويسخرون من الذين آمنوا" إشارة إلى كفار قريش، فإنهم كانوا يعظمون حالهم من الدنيا ويغتبطون بها، ويسخرون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: في طلبهم الآخرة. وقيل: لفقرهم وإقلالهم، كبلال وصهيب وابن مسعود وغيرهم، رضي الله عنهم، فنبه سبحانه على خفض منزلتهم لقبيح فعلهم بقوله: "والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة". وروى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من استذل مؤمنا أو مؤمنة أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم فضحه ومن بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة حتى يخرج مما قال فيه وإن عظم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة وإن الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله وولده). ثم قيل: معنى "والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة" أي في الدرجة، لأنهم في الجنة والكفار في النار. ويحتمل أن يراد بالفوق المكان، من حيث إن الجنة في السماء، والنار في أسفل السافلين. ويحتمل أن يكون التفضيل على ما يتضمنه زعم الكفار، فإنهم يقولون: وإن كان معاد فلنا فيه الحظ أكثر مما لكم، ومنه حديث خباب مع العاص بن وائل، قال خباب: كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له: إني لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد، الحديث. وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى. ويقال: سخرت منه وسخرت به، وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وبه، كل ذلك يقال، حكاه الأخفش. والاسم السخرية والسخري والسخري، وقرئ بهما قوله تعالى: "ليتخذ بعضهم بعضا سخريا" [الزخرف: 32] وقوله: "فاتخذتموهم سخريا" [المؤمنون: 110]. ورجل سخرة. يسخر منه، وسخرة - بفتح الخاء - يسخر من الناس. وفلان سخرة يتسخر في العمل، يقال: خادمه سخرة، وسخره تسخيرا كلفه عملا بلا أجرة.
قوله تعالى: "والله يرزق من يشاء بغير حساب" قال الضحاك: يعني من غير تبعة في الآخرة. وقيل: هو إشارة إلى هؤلاء المستضعفين، أي يرزقهم علو المنزلة، فالآية تنبيه على عظيم النعمة عليهم. وجعل رزقهم بغير حساب من حيث هو دائم لا يتناهى، فهو لا ينعد. وقيل: إن قوله: "بغير حساب" صفة لرزق الله تعالى كيف يصرف، إذ هو جلت قدرته لا ينفق بعد، ففضله كله بغير حساب، والذي بحساب ما كان على عمل قدمه العبد، قال الله تعالى: "جزاء من ربك عطاء حسابا" [النبأ: 36]. والله أعلم. ويحتمل أن يكون المعنى بغير احتساب من المرزوقين، كما قال: "ويرزقه من حيث لا يحتسب" [الطلاق: 3].
الآية: 213 {كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم}
قوله تعالى: "كان الناس أمة واحدة" أي على دين واحد. قال أبي بن كعب، وابن زيد: المراد بالناس بنو آدم حين أخرجهم الله نسما من ظهر آدم فأقروا له بالوحدانية. وقال مجاهد: الناس آدم وحده، وسمي الواحد بلفظ الجمع لأنه أصل النسل. وقيل: آدم وحواء. وقال ابن عباس وقتادة: (المراد بالناس القرون التي كانت بين آدم ونوح، وهي عشرة كانوا على الحق حتى اختلفوا فبعث الله نوحا فمن بعده). وقال ابن أبي خيثمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنة. وقيل: أكثر من ذلك، وكان بينه وبين نوح ألف سنة ومائتا سنة. وعاش آدم تسعمائة وستين سنة، وكان الناس في زمانه أهل ملة واحدة، متمسكين بالدين، تصافحهم الملائكة، وداموا على ذلك إلى أن رفع إدريس عليه السلام فاختلفوا. وهذا فيه نظر، لأن إدريس بعد نوح على الصحيح. وقال قوم منهم الكلبي الواقدي: المراد نوح ومن في السفينة، وكانوا مسلمين ثم بعد وفاة نوح اختلفوا. وقال ابن عباس أيضا: (كانوا أمة واحدة على الكفر، يريد في مدة نوح حين بعثه الله). وعنه أيضا: كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة، كلهم كفار، وولد إبراهيم في جاهلية، فبعث الله تعالى إبراهيم وغيره من النبيين. فـ "كان" على هذه الأقوال على بابها من المضي المنقضي. وكل من قدر الناس في الآية مؤمنين قدر في الكلام فاختلفوا فبعث، ودل على هذا الحذف: "وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه" أي كان الناس على دين الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين، مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى. وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة النبيين إليهم. ويحتمل أن تكون "كان" للثبوت، والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع، وجهلهم بالحقائق، لولا من الله عليهم، وتفضله بالرسل إليهم. فلا يختص "كان" على هذا التأويل بالمضي فقط، بل معناه معنى قوله: "وكان الله غفورا رحيما" [النساء: 96، 100، 152]. و"أمة" مأخوذة من قولهم: أممت كذا، أي قصدته، فمعنى "أمة" مقصدهم واحد، ويقال للواحد: أمة، أي مقصده غير مقصد الناس، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قس بن ساعدة: (يحشر يوم القيامة أمة وحده). وكذلك قال في زيد بن عمرو بن نفيل. والأمة القامة، كأنها مقصد سائر البدن. والأمة (بالكسر): النعمة، لأن الناس يقصدون قصدها. وقيل: إمام، لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل، عن النحاس. وقرأ أبي بن كعب: "كان البشر أمة واحدة" وقرأ ابن مسعود "كان الناس أمة واحدة فاختلفوا".
قوله تعالى: "فبعث الله النبيين" وجملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفا، والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، والمذكورون في القرآن بالاسم العلم ثمانية عشر، وأول الرسل آدم، على ما جاء في حديث أبي ذر، أخرجه الآجري وأبو حاتم البستي. وقيل: نوح، لحديث الشفاعة، فإن الناس يقولون له: أنت أول الرسل. وقيل: إدريس، وسيأتي بيان هذا في "الأعراف" إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: "مبشرين ومنذرين" نصب على الحال. "وأنزل معهم الكتاب" اسم جنس بمعنى الكتب. وقال الطبري: الألف واللام في الكتاب للعهد، والمراد التوراة. و"ليحكم" مسند إلى الكتاب في قول الجمهور، وهو نصب بإضمار أن، أي لأن يحكم وهو مجاز مثل "هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق" [الجاثية: 29]. وقيل: أي ليحكم كل نبي بكتابه، وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتاب. وقراءة عاصم الجحدري "ليحكم بين الناس" على ما لم يسم فاعله، وهي قراءة شاذة، لأنه قد تقدم ذكر الكتاب. وقيل: المعنى ليحكم الله، والضمير في "فيه" عائد على "ما" من قوله: "فيما" والضمير في "فيه" الثانية يحتمل أن يعود على الكتاب، أي وما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه. موضع "الذين" رفع بفعلهم. و"أتوه" بمعنى أعطوه. وقيل: يعود على المنزل عليه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قاله الزجاج. أي وما اختلف في النبي عليه السلام إلا الذين أعطوا علمه. "بغيا بينهم" نصب على المفعول له، أي لم يختلفوا إلا للبغي، وقد تقدم معناه. وفي هذا تنبيه على السفه في فعلهم، والقبح الذي واقعوه. و"هدى" معناه أرشد، أي فهدى الله أمة محمد إلى الحق بأن بين لهم ما اختلف فيه من كان قبلهم. وقالت طائفة: معنى الآية أن الأمم كذب بعضهم كتاب بعض، فهدى الله تعالى أمة محمد للتصديق بجميعها. وقالت طائفة: إن الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه أهل الكتابين، من قولهم: إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. وقال ابن زيد وزيد بن أسلم: من قبلتهم، فإن اليهود إلى بيت المقدس، والنصارى إلى المشرق، ومن يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليهود غد وللنصارى بعد غد) ومن صيامهم، ومن جميع ما اختلفوا فيه.
وقال ابن زيد: واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود لفرية، وجعلته النصارى ربا، فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه عبدا لله. وقال الفراء: هو من المقلوب - واختاره الطبري - قال: وتقديره فهدى الله الذين آمنوا للحق لما اختلفوا فيه. قال ابن عطية: ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه، وعساه غير الحق في نفسه، نحا إلى هذا الطبري في حكايته عن الفراء، وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر، وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ووصفه، لأن قوله: "فهدى" يقتضي أنهم أصابوا الحق وتم المعنى في قوله: "فيه" وتبين بقوله: "من الحق" جنس ما وقع الخلاف فيه، قال المهدوي: وقدم لفظ الاختلاف على لفظ الحق اهتماما، إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية: وليس هذا عندي بقوي. وفي قراءة عبدالله بن مسعود "لما اختلفوا عنه من الحق" أي عن الإسلام. و"بإذنه" قال الزجاج: معناه بعلمه. قال النحاس: وهذا غلط، والمعنى بأمره، وإذا أذنت في الشيء فقد أمرت به، أي فهدى الله الذين آمنوا بأن أمرهم بما يجب أن يستعملوه. وفي قوله: "والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم" رد على المعتزلة في قولهم: إن العبد يستبد بهداية نفسه.
الآية: 214 {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب}
قوله تعالى: "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة" "حسبتم" معناه ظننتم. قال قتادة والسدي وأكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة، والحر والبرد، وسوء العيش، وأنواع الشدائد، وكان كما قال الله تعالى: "وبلغت القلوب الحناجر" [الأحزاب: 10]. وقيل: نزلت في حرب أحد، نظيرها - في آل عمران - "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم" [آل عمران: 142]. وقالت فرقة: نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم من الأغنياء النفاق، فأنزل الله تعالى تطييبا لقلوبهم "أم حسبتم". و"أم" هنا منقطعة، بمعنى بل، وحكى بعض اللغويين أنها قد تجيء بمثابة ألف الاستفهام ليبتدأ بها، و"حسبتم" تطلب مفعولين، فقال النحاة: "أن تدخلوا" تسد مسد المفعولين. وقيل: المفعول الثاني محذوف: أحسبتم دخولكم الجنة واقعا. و"لما" بمعنى لم. و"مثل" معناه شبه، أي ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلكم فتصبروا كما صبروا. وحكى النضر بن شميل أن "مثل" يكون بمعنى صفة، ويجوز أن يكون المعنى: ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين من قبلكم، أي من البلاء. قال وهب: وجد فيما بين مكة والطائف سبعون نبيا موتى، كان سبب موتهم الجوع والقمل، ونظير هذه الآية "الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم" [العنكبوت: 1 - 2 - 3] على ما يأتي، فاستدعاهم تعالى إلى الصبر، ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: "ألا إن نصر الله قريب". والزلزلة: شدة التحريك، تكون في الأشخاص وفي الأحوال، يقال: زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا - بالكسر - فتزلزلت إذا تحركت واضطربت، فمعنى "زلزلوا" خوفوا وحركوا. والزلزال - بالفتح - الاسم. والزلازل: الشدائد. وقال الزجاج: أصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه، فإذا قلت: زلزلته فمعناه كررت زلله من مكانه. ومذهب سيبويه أن زلزل رباعي كدحرج. وقرأ نافع "حتى يقول" بالرفع، والباقون بالنصب. ومذهب سيبويه في "حتى" أن النصب فيما بعدها من جهتين والرفع من جهتين، تقول: سرت حتى أدخل المدينة - بالنصب - على أن السير والدخول جميعا قد مضيا، أي سرت إلى أن أدخلها، وهذه غاية، وعليه قراءة من قرأ بالنصب. والوجه الآخر في النصب في غير الآية سرت حتى أدخلها، أي كي أدخلها. والوجهان في الرفع سرت حتى أدخلها، أي سرت فأدخلها، وقد مضيا جميعا، أي كنت سرت فدخلت. ولا تعمل حتى ههنا بإضمار أن، لأن بعدها جملة، كما قال الفرزدق:
فيا عجبا حتى كليب تسبني
قال النحاس: فعلى هذا القراءة بالرفع أبين وأصح معنى، أي وزلزلوا حتى الرسول يقول، أي حتى هذه حاله، لأن القول إنما كان عن الزلزلة غير منقطع منها، والنصب على الغاية ليس فيه هذا المعنى. والرسول هنا شعيا في قول مقاتل، وهو اليسع. وقال الكلبي: هذا في كل رسول بعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى نصر الله؟. وروي عن الضحاك قال: يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وعليه يدل نزول الآية، والله أعلم. والوجه الآخر في غير الآية سرت حتى أدخلها، على أن يكون السير قد مضى والدخول الآن. وحكى سيبويه: مرض حتى لا يرجونه، أي هو الآن لا يرجى، ومثله سرت حتى أدخلها لا أمنع. وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابن محيصن وشيبة. وبالنصب قرأ الحسن وأبو جعفر وابن أبي إسحاق وشبل وغيرهم. قال مكي: وهو الاختيار، لأن جماعة القراء عليه. وقرأ الأعمش: "وزلزلوا ويقول الرسول" بالواو بدل حتى. وفي مصحف ابن مسعود: "وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول". وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين، أي بلغ الجهد بهم حتى استبطؤوا النصر، فقال الله تعالى: "ألا إن نصر الله قريب". ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شك وارتياب. والرسول اسم جنس. وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله، فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب، فقدم الرسول في الرتبة لمكانته، ثم قدم قول المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان. قال ابن عطية: وهذا تحكم، وحمل الكلام على وجهه غير متعذر. ويحتمل أن يكون "ألا إن نصر الله قريب" إخبارا من الله تعالى مؤتنفا بعد تمام ذكر القول.
قوله تعالى: "متى نصر الله" رفع بالابتداء على قول سيبويه، وعلى قول أبي العباس رفع بفعل، أي متى يقع نصر الله. و"قريب" خبر "إن". قال النحاس: ويجوز في غير القرآن "قريبا" أي مكانا قريبا. و"قريب" لا تثنيه العرب ولا تجمعه ولا تؤنثه في هذا المعنى، قال الله عز وجل: "إن رحمة الله قريب من المحسنين" [الأعراف: 56]. وقال الشاعر:
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا بسباسة بنة يشكرا
فإن قلت: فلان قريب لي ثنيت وجمعت، فقلت: قريبون وأقرباء وقرباء.
الآية: 215 {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم}
قوله تعالى: "يسألونك" إن خففت الهمزة ألقيت حركتها على السين ففتحها وحذفت الهمزة فقلت: يسلونك. ونزلت الآية في عمرو بن الجموح، وكان شيخا كبيرا فقال: يا رسول الله، إن مالي كثير، فبماذا أتصدق، وعلى من أنفق؟ فنزلت "يسألونك ماذا ينفقون".
قوله تعالى: "ماذا ينفقون" "ما" في موضع رفع بالابتداء، و"ذا" الخبر، وهو بمعنى الذي، وحذفت الهاء لطول الاسم، أي ما الذي ينفقونه، وإن شئت كانت "ما" في موضع نصب بـ "ينفقون" و"ذا" مع "ما" بمنزلة شيء واحد ولا يحتاج إلى ضمير، ومتى كانت اسما مركبا فهي في موضع نصب، إلا ما جاء في قول الشاعر:
وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق
فإن "عسى" لا تعمل فيه، فـ "ماذا" في موضع رفع وهو مركب، إذ لا صلة لـ "ذا".
قيل: إن السائلين هم المؤمنون، والمعنى يسألونك ما هي الوجوه التي ينفقون فيها، وأين يضعون ما لزم إنفاقه. قال السدي: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة. قال ابن عطية: ووهم المهدوي على السدي في هذا، فنسب إليه أنه قال: إن الآية في الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان. وقال ابن جريج وغيره: هي ندب، والزكاة غير هذا الإنفاق، فعلى هذا لا نسخ فيها، وهي مبينة لمصارف صدقة التطوع، فواجب على الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله، من طعام وكسوة وغير ذلك. قال مالك، ليس عليه أن يزوج أباه، وعليه أن ينفق على امرأة أبيه، كانت أمه أو أجنبية، وإنما قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباه لأنه رآه يستغني عن التزويج غالبا، ولو احتاج حاجة ماسة لوجب أن يزوجه، ولولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليهما. فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه ما يحج به أو يغزو، وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر، لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام.
قوله تعالى: "قل ما أنفقتم" "ما" في موضع نصب بـ "أنفقتم" وكذا "وما تنفقوا" وهو شرط والجواب "فللوالدين"، وكذا "وما تفعلوا من خير" شرط، وجوابه "فإن الله به عليم" وقد مضى القول في اليتيم والمسكين وابن السبيل. ونظير هذه الآية قوله تعالى "فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل" [الروم: 38]. وقرأ علي بن أبي طالب "يفعلوا" بالياء على ذكر الغائب، وظاهر الآية الخبر، وهي تتضمن الوعد بالمجازاة.










الصفحة رقم 33 من المصحف تحميل و استماع mp3