سورة البقرة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
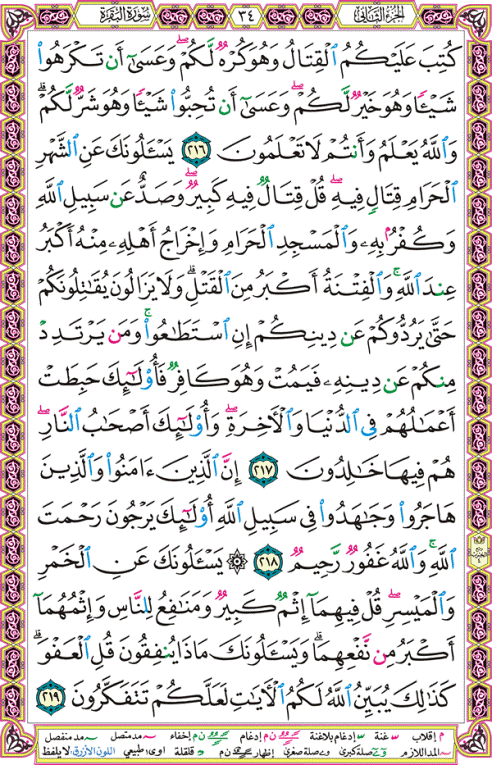
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 34 من المصحف
الآية: 216 {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون}
قوله تعالى: "كتب" معناه فرض، وقد تقدم مثله. وقرأ قوم "كتب عليكم القتل"، وقال الشاعر:
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول
هذا هو فرض الجهاد، بين سبحانه أن هذا مما امتحنوا به وجعل وصلة إلى الجنة. والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار، وهذا كان معلوما لهم بقرائن الأحوال، ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة، فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين فقال تعالى: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا" [الحج: 39] ثم أذن له في قتال المشركين عامة. واختلفوا من المراد بهذه الآية، فقيل: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين عليهم، فلما استقر الشرع صار على الكفاية، قال عطاء والأوزاعي. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب الغزو على الناس في هذه الآية؟ فقال: لا، إنما كتب على أولئك. وقال الجمهور من الأمة: أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير لوجوب طاعته. وقال سعيد بن المسيب: إن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبدا، حكاه الماوردي. قال ابن عطية: والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين، وسيأتي هذا مبينا في سورة "براءة" إن شاء الله تعالى. وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنه قال: الجهاد تطوع. قال ابن عطية: وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد، فقيل له: ذلك تطوع.
قوله تعالى: "وهو كره لكم" ابتداء وخبر، وهو كره في الطباع. قال ابن عرفة: الكره، المشقة والكره - بالفتح - ما أكرهت عليه، هذا هو الاختيار، ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين، يقال: كرهت الشيء كرها وكرها وكراهة وكراهية، وأكرهته عليه إكراها. وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل، والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس، فكانت كراهيتهم لذلك، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال عكرمة في هذه الآية: إنهم كرهوه ثم أحبوه وقالوا: سمعنا وأطعنا، وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن مشقة، لكن إذا عرف الثواب هان في جنبه مقاساة المشقات.
قلت: ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه كقطع عضو وقلع ضرس، وفصد وحجامة ابتغاء العافية ودوام الصحة، ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدق.
قوله تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئا" قيل: "عسى": بمعنى قد، قاله الأصم. وقيل: هي واجبة. و"عسى" من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى: "عسى ربه إن طلقكن أن يبدله" [التحريم: 5]. وقال أبو عبيدة: "عسى" من الله إيجاب، والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا، وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم.
قلت: وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في بلاد الأندلس، تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد؟! وأسر وقتل وسبى واسترق، فإنا لله وإنا إليه راجعون! ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته! وقال الحسن في معنى الآية: لا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أم تحبه فيه عطبك، وأنشد أبو سعيد الضرير:
رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه
خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه
الآية: 217 {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}
قوله تعالى: "يسألونك" تقدم القول فيه. وروى جرير بن عبدالحميد ومحمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:(ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة كلهن في القرآن: "يسألونك عن المحيض"، "يسألونك عن الشهر الحرام"، "يسألونك عن اليتامى"، ما كانوا يسألونك إلا عما ينفعهم). قال ابن عبدالبر: ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث. وروى أبو اليسار عن جندب بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارث أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث عبدالله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: ولا تكرهن أصحابك على المسير، فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله، قال: فرجع رجلان ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب، فقال المشركون: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى: "يسألونك عن الشهر الحرام" الآية. وروى أن سبب نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في أول يوم من رجب فقتلهما، فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام، فنزلت الآية. والقول بأن نزولها في قصة عبدالله بن جحش أكثر وأشهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع تسعة رهط ، وقيل ثمانية، في جمادى الآخرة قبل بدر بشهرين، وقيل في رجب. قال أبو عمر - في كتاب الدرر له - : ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب كرز بن جابر - وتعرف تلك الخرجة ببدر الأولى - أقام بالمدينة بقية جمادى الآخرة ورجب، وبعث في رجب عبدالله بن جحش بن رئاب الأسدي ومعه ثمانية رجال من المهاجرين، وهم أبو حذيفة بن عتبة، وعكاشة بن محصن، وعتبة بن غزوان، وسهيل بن بيضاء الفهري، وسعد بن أبي وقاص، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبدالله التميمي، وخالد بن بكير الليثي. وكتب لعبدالله بن جحش كتابا، وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره أحدا من أصحابه، وكان أميرهم، ففعل عبدالله بن جحش ما أمره به، فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: (إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا، وتعلم لنا من أخبارهم). فلما قرأ الكتاب قال: سمعا وطاعة، ثم أخبر أصحابه بذلك، وبأنه لا يستكره أحدا منهم، وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه، وأنه إن لم يطعه أحد مضى وحده، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. فقالوا: كلنا نرغب فيما ترغب فيه، وما منا أحد إلا وهو سامع مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهضوا معه، فسلك على الحجاز، وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان جمل كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه، ونفذ عبدالله بن جحش مع سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة، فمرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي - واسم الحضرمي عبدالله بن عباد من الصدف، والصدف بطن من حضرموت - وعثمان بن عبدالله بن المغيرة، وأخوه نوفل بن عبدالله بن المغيرة المخزوميان، والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام: وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، ثم اتفقوا على لقائهم، فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبدالله، ثم قدموا بالعير والأسيرين، وقال لهم عبدالله بن جحش: اعزلوا مما غنمنا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا، فكان أول خمس في الإسلام، ثم نزل القرآن: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه" [الأنفال: 41] فأقر الله ورسوله فعل عبدالله بن جحش ورضيه وسنه للأمة إلى يوم القيامة، وهي أول غنيمة غنمت في الإسلام، وأول أمير، وعمرو بن الحضرمي أول قتيل. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فسقط في أيدي القوم، فأنزل الله عز وجل: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه" إلى قوله: "هم فيها خالدون". وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء في الأسيرين، فأما عثمان بن عبدالله فمات بمكة كافرا، وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد ببئر معونة، ورجع سعد وعتبة إلى المدينة سالمين.
وقيل: إن انطلاق سعد بن أبي وقاص وعتبة في طلب بعيرهما كان عن إذن من عبدالله بن جحش، وإن عمرو بن الحضرمي وأصحابه لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هابوهم، فقال عبدالله بن جحش: إن القوم قد فزعوا منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض لهم، فإذا رأوه محلوقا أمنوا وقالوا: قوم عمار لا بأس عليكم، وتشاوروا في قتالهم، الحديث. وتفاءلت اليهود وقالوا: واقد وقدت الحرب، وعمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب. وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم، فقال: لا نفديهما حتى يقدم سعد وعتبة، وإن لم يقدما قتلناهما بهما، فلما قدما فاداهما فأما الحكم فأسلم وأقام بالمدينة حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا، وأما عثمان فرجع إلى مكة فمات بها كافرا، وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعا فقتله الله تعالى، وطلب المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية) فهذا سبب نزول قوله تعالى: "يسألونك عن الشهر الحرام". وذكر ابن إسحاق أن قتل عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب، على ما تقدم. وذكر الطبري عن السدي وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من جمادى الآخرة، والأول أشهر، على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان في أول ليلة من رجب، والمسلمون يظنونها من جمادى. قال ابن عطية: وذكر الصاحب بن عباد في رسالته المعروفة بالأسدية أن عبدالله بن جحش سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمرا على جماعة من المؤمنين.
واختلف العلماء في نسخ هذه الآية، فالجمهور على نسخها، وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح. واختلفوا في ناسخها، فقال الزهري: نسخها "وقاتلوا المشركين كافة" [التوبة: 36]. وقيل نسخها غزو النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في الشهر الحرام، وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام. وقيل: نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة، وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتل عثمان بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم لا على الابتداء بقتالهم. وذكر البيهقي عن عروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في أثر قصة الحضرمي: فأنزل عز وجل: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه" الآية، قال: فحدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان، وأن الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدهم عن سبيل الله حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه، وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين، وفتنتهم إياهم عن الدين، فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه، حتى أنزل الله عز وجل: "براءة من الله ورسوله" [التوبة: 1]. وكان عطاء يقول: الآية محكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم، ويحلف على ذلك، لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة، وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق. وروى أبو الزبير عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى.
قوله تعالى: "قتال فيه" "قتال" بدل عند سيبويه بدل اشتمال، لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال، أي يسألك الكفار تعجبا من هتك حرمة الشهر، فسؤالهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. قال الزجاج: المعنى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. وقال القتبي: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالا من الشهر، وأنشد سيبويه:
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما
وقرأ عكرمة: "يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه قل قتل" بغير ألف فيهما. وقيل: المعنى يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه، وهكذا قرأ ابن مسعود، فيكون مخفوضا بعن على التكرير، قاله الكسائي. وقال الفراء: هو مخفوض على نية عن. وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار. قال النحاس: لا يجوز أن يعرب الشيء على الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط، وإنما وقع في شيء شاذ، وهو قولهم: هذا جحر ضب خرب، والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية: هذان: جحرا ضب خربان، وإنما هذا بمنزلة الإقواء، ولا يجوز أن يحمل شيء من كتاب الله على هذا، ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها. قال ابن عطية: وقال أبو عبيدة: هو خفض على الجوار، وقوله هذا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز إضمار عن، والقول فيه أنه بدل. وقرأ الأعرج: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه" بالرفع. قال النحاس: وهو غامض في العربية، والمعنى فيه يسألونك عن الشهر الحرام أجائز قتال فيه؟ فقوله: "يسألونك" يدل على الاستفهام، كما قال امرؤ القيس:
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل
والمعنى: أترى برقا، فحذف ألف الاستفهام، لأن الألف التي في "أصاح" تدل عليها وإن كانت حرف نداء، كما قال الشاعر:
تروح من الحي أم تبتكر
والمعنى: أتروح، فحذف الألف لأن "أم" تدل عليها.
قوله تعالى: "قل قتال فيه كبير" ابتداء وخبر، أي مستنكر، لأن تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذ إذ كان الابتداء من المسلمين. والشهر في الآية اسم جنس، وكانت العرب قد جعل الله لها الشهر الحرام قواما تعتدل عنده، فكانت لا تسفك دما، ولا تغير في الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد. وسيأتي لهذا مزيد بيان في "المائدة" إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: "وصد عن سبيل الله" ابتداء "وكفر به" عطف على "صد" "والمسجد الحرام" عطف على "سبيل الله" "وإخراج أهله منه" عطف على "صد"، وخبر الابتداء "أكبر عند الله" أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام، قاله المبرد وغيره. وهو الصحيح، لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها. "وكفر به" أي بالله، وقيل: "وكفر به" أي بالحج والمسجد الحرام. "وإخراج أهله منه أكبر" أي أعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر الحرام. وقال الفراء: "صد" عطف على "كبير". "والمسجد" عطف على الهاء في "به"، فيكون الكلام نسقا متصلا غير منقطع. قال ابن عطية: وذلك خطأ، لأن المعنى يسوق إلى أن قوله: "وكفر به" أي بالله عطف أيضا على "كبير"، ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله، وهذا بين فساده. ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه، كما فعلتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر جرما عند الله. وقال عبدالله بن جحش رضي الله عنه:
تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد
صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد
وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد
فإنا وإن غيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد
دما وابن عبدالله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند
وقال الزهري ومجاهد وغيرهما: قوله تعالى: "قل قتال فيه كبير" منسوخ بقوله: "وقاتلوا المشركين كافة" وبقوله: "فاقتلوا المشركين" [التوبة: 5]. وقال عطاء: لم ينسخ، ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم، وقد تقدم.
قوله تعالى: "والفتنة أكبر من القتل" قال مجاهد وغيره: الفتنة هنا الكفر، أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا، أي أن ذلك أشد اجتراما من قتلكم في الشهر الحرام.
قوله تعالى: "ولا يزالون" ابتداء خبر من الله تعالى، وتحذير منه للمؤمنين من شر الكفرة. قال مجاهد: يعني كفار قريش. و"يردوكم" نصب بحتى، لأنها غاية مجردة.
قوله تعالى: "ومن يرتدد" أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر "فأولئك حبطت" أي بطلت وفسدت، ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلأ فتنتفخ أجوافها، وربما تموت من ذلك، فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام.
واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا، إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يورث أم لا؟ قالت طائفة: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم: ساعة واحدة. وقال آخرون: يستتاب شهرا. وقال آخرون: يستتاب ثلاثا، على ما روي عن عمر وعثمان، وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم. وقال الحسن: يستتاب مائة مرة، وقد روي عنه أنه يقتل دون استتابة، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وهو أحد قولي طاوس وعبيد بن عمير. وذكر سحنون أن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون كان يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب، واحتج بحديث معاذ وأبي موسى، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى إليه وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فقال: اجلس. قال: نعم لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات - فأمر به فقتل، خرجه مسلم وغيره. وذكر أبو يوسف عن أبى حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل، فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام، والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب. والزنديق عندهم والمرتد سواء. وقال مالك: وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. وقد مضى هذا أول "البقرة". واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر، فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا يتعرض له، لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقر عليه. وحكى ابن عبدالحكم عن الشافعي أنه يقتل، لقوله عليه السلام: (من بدل دينه فاقتلوه) ولم يخص مسلما من كافر. وقال مالك: معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث، وهو قول جماعة من الفقهاء. والمشهور عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب ويخرجه من بلده ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار، لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد. واختلفوا في المرتدة، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد: تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث: (من بدل دينه فاقتلوه). و"من" يصلح للذكر والأنثى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدة، وهو قول ابن شبرمة، وإليه ذهب ابن علية، وهو قول عطاء والحسن. واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه) ثم إن ابن عباس لم يقتل المرتدة، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله، وروي عن علي مثله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. واحتج الأولون بقوله عليه السلام: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان...) فعم كل من كفر بعد إيمانه، وهو أصح.
قال الشافعي: إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله. وقال مالك: تحبط بنفس الردة، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك: يلزمه الحج، لأن الأول قد حبط بالردة. وقال الشافعي: لا إعادة عليه، لأن عمله باق. واستظهر علماؤنا بقوله تعالى: "لئن أشركت ليحبطن عملك" [الزمر: 65]. قالوا: وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، لأنه عليه السلام يستحيل منه الردة شرعا. وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الأمة، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم! لكنه لا يشرك لفضل مرتبته، كما قال: "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين" [الأحزاب: 30] وذلك لشرف منزلتهن، وإلا فلا يتصور إتيان منهن صيانة لزوجهن المكرم المعظم، ابن العربي. وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاة شرطا ههنا لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء، فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين، وحكمين متغايرين. وما خوطب به عليه السلام فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه، وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان هتكان أحدهما لحرمة الدين، والثاني لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل هتك حرمة عقاب، وينزل ذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام أو في البلد الحرام أو في المسجد الحرام، يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات. والله أعلم.
اختلاف العلماء في ميراث المرتد: فقال علي بن أبي طالب والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور: ميراثه في بيت المال. وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين: ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين. وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيء، وما كان مكتسبا في حالة الإسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون، وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفصلون بين الأمرين، ومطلق قوله عليه السلام: (لا وراثة بين أهل ملتين) يدل على بطلان قولهم. وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه، سوى عمر بن عبدالعزيز فإنه قال: يرثونه.
الآية: 218 {إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم}
قوله تعالى: "إن الذين آمنوا والذين هاجروا" الآية. قال جندب بن عبدالله وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قتل واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ خمسه الذي وفق في فرضه له عبدالله بن جحش وفي الأسيرين، فعنف المسلمون عبدالله بن جحش وأصحابه حتى شق ذلك عليهم، فتلافاهم الله عز وجل بهذه الآية في الشهر الحرام وفرج عنهم، وأخبر أن لهم ثواب من هاجر وغزا، فالإشارة إليهم في قوله: "إن الذين آمنوا" ثم هي باقية في كل من فعل ما ذكره الله عز وجل. وقيل: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله: "إن الذين آمنوا والذين هاجروا" إلى آخر الآية.
والهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع، وقصد ترك الأول إيثارا للثاني. والهجر ضد الوصل. وقد هجره هجرا وهجرانا، والاسم الهجرة. والمهاجرة من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية. والتهاجر التقاطع. ومن قال: المهاجرة الانتقال من البادية إلى الحاضرة فقد أوهم، بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب، وليس أهل مكة مهاجرين على قوله. "وجاهد" مفاعلة من جهد إذا استخرج الجهد، مجاهدة وجهادا. والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. والجهاد (بالفتح): الأرض الصلبة. "ويرجون" معناه يطمعون ويستقربون. وإنما قال "يرجون" وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، لأمرين: أحدهما لا يدري بما يختم له. والثاني - لئلا يتكل على عمله، والرجاء ينعم، والرجاء أبدا معه خوف ولا بد، كما أن الخوف معه رجاء. والرجاء من الأمل ممدود، يقال: رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة، يقال: ما أتيتك إلا رجاوة الخير. وترجيته وارتجيته ورجيته وكله بمعنى رجوته، قال بشر يخاطب بنته:
فرجي الخير وانتظري إيابي إذا ما القارظ العنزي آبا
وما لي في فلان رجية، أي ما أرجو. وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف، قال الله تعالى: "ما لكم لا ترجون لله وقارا" [نوح: 13] أي لا تخافون عظمة الله، قال أبو ذؤيب:
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل
أي لم يخف ولم يبال. والرجا - مقصور - : ناحية البئر وحافتاها، وكل ناحية رجا. والعوام من الناس يخطئون في قولهم: يا عظيم الرجا، فيقصرون ولا يمدون.
الآية: 219 {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون}
قوله تعالى: "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" فيه تسع مسائل:
قوله تعالى: "يسألونك" السائلون هم المؤمنون، كما تقدم. والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة. وكل شيء غطى شيئا فقد خمره، ومنه "خمروا آنيتكم" فالخمر تخمر العقل، أي تغطيه وتستره، ومن ذلك الشجر الملتف يقال له: الخمر (بفتح الميم لأنه يغطي ما تحته ويستره، يقال منه: أخمرت الأرض كثر خمرها، قال الشاعر:
ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق
أي سيرا مدلين فقد جاوزتما الوهدة التي يستتر بها الذئب وغيره. وقال العجاج يصف جيشا يمشي برايات وجيوش غير مستخف:
في لامع العقبان لا يمشي الخمر يوجه الأرض ويستاق الشجر
ومنه قولهم: دخل في غمار الناس وخمارهم، أي هو في مكان خاف. فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطيه سميت بذلك وقيل: إنما سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال: قد اختمر العجين، أي بلغ إدراكه. وخمر الرأي، أي ترك حتى يتبين فيه الوجه. وقيل: إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل، من المخامرة وهي المخالطة، ومنه قولهم: دخلت في خمار الناس، أي اختلطت بهم. فالمعاني الثلاثة متقاربة، فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت، ثم خالطت العقل، ثم خمرته، والأصل الستر.
والخمر: ماء العنب الذي غلى أو طبخ، وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه، لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام. وإنما ذكر الميسر من بينه فجعل كله قياسا على الميسر، والميسر إنما كان قمارا في الجزر خاصة، فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها.
والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره، والحد في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال، وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه، وهذا ضعيف يرده النظر والخبر، على ما يأتي بيانه في "المائدة والنحل" إن شاء الله تعالى.
قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر. وهذه الآية أول ما نزل في أمر الخمر، ثم بعده: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" [النساء: 43] ثم قوله: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون" [المائدة: 91] ثم قوله: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" [المائدة: 90] على ما يأتي بيانه في "المائدة".
قوله تعالى: "والميسر" الميسر: قمار العرب بالأزلام. قال ابن عباس: (كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله) فنزلت الآية. وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاوس وعلي بن أبى طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضا: (كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق)، على ما يأتي. وقال مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه. قال علي بن أبي طالب: الشطرنج ميسر العجم. وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء. وسيأتي في "يونس" زيادة بيان لهذا الباب إن شاء الله تعالى.
والميسر مأخوذ من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال: يسر لي كذا إذا وجب فهو ييسر يسرا وميسرا. والياسر: اللاعب بالقداح، وقد يسر ييسر، قال الشاعر:
فأعنهم وايسر بما يسروا به وإذا هم نزلوا بضنك فانزل
وقال الأزهري: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته. والياسر: الجازر، لأنه يجزئ لحم الجزور. قال: وهذا الأصل في الياسر، ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور: ياسرون، لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك. وفي الصحاح: ويسر القوم الجزور أي اجتزروها واقتسموا أعضاءها. قال سحيم بن وثيل اليربوعي:
أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم
كان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام. ويقال: يسر القوم إذا قامروا. ورجل يسر وياسر بمعنى. والجمع أيسار، قال النابغة:
أنى أتمم أيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدما
وقال طرفة:
وهم أيسار لقمان إذا أغلت الشتوة أبداء الجزر
وكان من تطوع بنحرها ممدوحا عندهم، قال الشاعر:
وناجية نحرت لقوم صدق وما ناديت أيسار الجزر
روى مالك في الموطأ عن داود بن حصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، وهذا محمول عند مالك وجمهور أصحابه في الجنس الواحد، حيوانه بلحمه، وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار، لأنه لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر، وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا، فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده إذا كانا من جنس واحد، والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظباء والوعول وسائر الوحوش، وذوات الأربع المأكولات كلها عنده جنس واحد، لا يجوز بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشيء واحد من لحمه بوجه من الوجوه، لأنه عنده من باب المزابنة، كبيع الزبيب بالعنب والزيتون بالزيت والشيرج بالسمسم، ونحو ذلك. والطير عنده كله جنس واحد، وكذلك الحيتان من سمك وغيره. وروي عنه أن الجراد وحده صنف. وقال الشافعي وأصحابه والليث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على حال من الأحوال من جنس واحد كان أم من جنسين مختلفين، على عموم الحديث. وروي عن ابن عباس (أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فقسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءا منها بشاة، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا). قال الشافعي: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفا من الصحابة. قال أبو عمر: قد روي عن ابن عباس (أنه أجاز بيع الشاة باللحم، وليس بالقوي). وذكر عبدالرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يباع حي بميت، يعني الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان: ونحن لا نرى به بأسا. قال المزني: إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز، وإن صح بطل القياس واتبع الأثر. قال أبو عمر: وللكوفيين في أنه جائز بيع اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس والاعتبار، إلا أنه إذا صح الأثر بطل القياس والنظر. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو عمر: ولا أعلمه يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب على ما ذكره مالك في موطئه، وإليه ذهب الشافعي، وأصله أنه لا يقبل المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل سعيد فوجدها أو أكثرها صحاحا. فكره بيع أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه، لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن يخص النص بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البر والماء وإن اختلفت أجناسه، كالطعام الذي هو اسم لكل مأكول أو مشروب، فاعلم.
قوله تعالى: "قل فيهما" يعني الخمر والميسر "إثم كبير" إثم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور، وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه، وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله، إلى غير ذلك. روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، أو تشرب من هذه الخمر كأسا، أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسا، فسقته كأسا. قال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر، إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، وذكره أبو عمر في الاستيعاب. وروي أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تصل إليه، فإنه يأمرك بالصلاة، فقال: إن خدمة الرب واجبة. فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء. فقال: اصطناع المعروف واجب. فقيل له: إنه ينهى عن الزنى. فقال: هو فحش وقبيح في العقل، وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه. فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر. فقال: أما هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع، وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه، فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات. وكان قيس بن عاصم المنقري شرابا لها في الجاهلية ثم حرمها على نفسه، وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، وسب أبويه، ورأى القمر فتكلم بشيء، وأعطى الخمار كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه، وفيها يقول:
رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما
فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما
ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما
فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما
قال أبو عمر: وروى ابن الأعرابي عن المفضل الضبي أن هذه الأبيات لأبي محجن الثقفي قالها في تركه الخمر، وهو القائل رضي الله عنه:
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها
ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها
وجلده عمر الحد عليها مرارا، ونفاه إلى جزيرة في البحر، فلحق بسعد فكتب إليه عمر أن يحبسه فحبسه، وكان أحد الشجعان البهم، فلما كان من أمره في حرب القادسية ما هو معروف حل قيوده وقال لا نجلدك على الخمر أبدا. قال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها أبدا، فلم يشربها بعد ذلك. وفي رواية: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، وأما إذ بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. وذكر الهيثم بن عدي أنه أخبره من رأى قبر أبي محجن بأذربيجان، أو قال: في نواحي جرجان، وقد نبتت عليه ثلاث أصول كرم وقد طالت وأثمرت، وهي معروشة على قبره، ومكتوب على القبر "هذا قبر أبي محجن" قال: فجعلت أتعجب وأذكر قوله:
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة
ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء، فيلعب ببوله وعذرته، وربما يمسح وجهه، حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: أكرمك الله.
وأما القمار فيورث العداوة والبغضاء، لأنه أكل مال الغير بالباطل.
قوله تعالى: "ومنافع للناس" أما في الخمر فربح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماسكة فيها، فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منفعتها، وقد قيل في منافعها: إنها تهضم الطعام، وتقوي الضعف، وتعين على الباه، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي اللون، إلى غير ذلك من اللذة بها. وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:
ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء
إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر:
فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير
وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير
ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب، فكانوا يشترون الجزور ويضربون بسهامهم، فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم ولا يكون عليه من الثمن شيء، ومن بقي سهمه آخر كان عليه ثمن الجزور كله ولا يكون له من اللحم شيء. وقيل: منفعته التوسعة على المحاويج، فإن من قمر منهم كان لا يأكل من الجزور وكان يفرقه في المحتاجين.
وسهام الميسر أحد عشر سهما، منها سبعة لها حظوظ وفيها فروض على عدد الحظوظ، وهي: "الفذ" وفيه علامة واحدة له نصيب وعليه نصيب إن خاب. الثاني: "التوأم" وفيه علامتان وله وعليه نصيبان. الثالث: "الرقيب" وفيه ثلاث علامات على ما ذكرنا. الرابع: "حلس" وله أربع. الخامس: "النافز" والنافس أيضا وله خمس. السادس: "المسبل" وله ست. السابع: "المعلى" وله سبع. فذلك ثمانية وعشرون فرضا، وأنصباء الجزور كذلك في قول الأصمعي. وبقي من السهام أربعة، وهي الأغفال لا فروض لها ولا أنصباء، وهي: "المصدر" و"المضعف" و"المنيح" و"السفيح". وقيل: الباقية الأغفال الثلاثة: "السفيح" و"المنيح" و"الوغد" تزاد هذه الثلاثة لتكثر السهام على الذي يجيلها فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلا. ويسمى المجيل المفيض والضارب والضريب والجمع الضرباء. وقيل: يجعل خلفه رقيب لئلا يحابي أحدا، ثم يجثو الضريب على ركبتيه، ويلتحف بثوب ويخرج رأسه ويدخل يده في الربابة فيخرج. وكانت عادة العرب أن تضرب الجزور بهذه السهام في الشتوة وضيق الوقت وكلب البرد على الفقراء، يشترى الجزور ويضمن الأيسار ثمنها ويرضي صاحبها من حقه، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك منهم، ويسمونه "البرم" قال متمم بن نويرة:
ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا
ثم تنحر وتقسم على عشرة أقسام. قال ابن عطية: وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور، فذكر أنها على قدر حظوظ السهام ثمانية وعشرون قسما، وليس كذلك، ثم يضرب على العشرة فمن فاز سهمه بأن يخرج من الربابة متقدما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء. والربابة (بكسر الراء): شبيهة بالكنانة تجمع فيها سهام الميسر، وربما سموا جميع السهام ربابة، قال أبو ذؤيب يصف الحمار وأتنه:
وكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع
والربابة أيضا: العهد والميثاق، قال الشاعر:
وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب
وفي أحيان ربما تقامروا لأنفسهم ثم يغرم الثمن من لم يفز سهمه، كما تقدم. ويعيش بهذه السيرة فقراء الحي، ومنه قول الأعشى:
المطعمو الضيف إذا ما شتوا والجاعلو القوت على الياسر
ومنه قول الآخر:
بأيديهم مقرومة ومغالق يعود بأرزاق العفاة منيحها
و"المنيح" في هذا البيت المستمنح، لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي قد امَّلس وكثر فوزه، فذلك المنيح الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحد الأغفال فذلك إنما يوصف بالكر، وإياه أراد الأخطل بقوله:
ولقد عطفن على فزارة عطفة كر المنيح وجلن ثم مجالا
وفي الصحاح: "والمنيح سهم من سهام الميسر مما لا نصيب له إلا أن يمنح صاحبه شيئا". ومن الميسر قول لبيد:
إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم فواحش ينعى ذكرها بالمصايف
فهذا كله نفع الميسر، إلا أنه أكل المال بالباطل.
قوله تعالى: "وإثمهما أكبر من نفعهما" أعلم الله جل وعز أن الإثم أكبر من النفع، وأعود بالضرر في الآخرة، فالإثم الكبير بعد التحريم، والمنافع قبل التحريم. وقرأ حمزة والكسائي "كثير" بالثاء المثلثة، وحجتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها. وأيضا فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام. و"كثير" بالثاء المثلثة يعطي ذلك. وقرأ باقي القراء وجمهور الناس "كبير" بالباء الموحدة، وحجتهم أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر، فوصفه بالكبير أليق. وأيضا فاتفاقهم على "أكبر" حجة لـ "كبير" بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض "أكثر" بالثاء المثلثة، إلا في مصحف عبدالله بن مسعود فإن فيه "قل فيهما إثم كثير" "وإثمهما أكثر" بالثاء مثلثة في الحرفين.
قال قوم من أهل النظر: حرمت الخمر بهذه الآية، لأن الله تعالى قد قال: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم" [الأعراف: 33] فأخبر في هذه الآية أن فيها إثما فهو حرام. قال ابن عطية: ليس هذا النظر بجيد، لأن الإثم الذي فيها هو الحرام، لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر.
قلت: وقال بعضهم: في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر لأنه سماه إثما، وقد حرم الإثم في آية أخرى، وهو قوله عز وجل: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم" وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمر، بدليل قول الشاعر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول
قلت: وهذا أيضا ليس بجيد، لأن الله تعالى لم يسم الخمر إثما في هذه الآية، وإنما قال: "قل فيهما إثم كبير" ولم يقل: قل هما إثم كبير. وأما آية "الأعراف" وبيت الشعر فيأتي الكلام فيهما هناك مبينا، إن شاء الله تعالى. وقد قال قتادة: إنما في هذه الآية ذم الخمر، فأما التحريم فيعلم بآية أخرى وهي آية "المائدة" وعلى هذا أكثر المفسرين.
قوله تعالى: "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون" "قل العفو" قراءة الجمهور بالنصب. وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع. واختلف فيه عن ابن كثير. وبالرفع قراءة الحسن وقتادة وابن أبي إسحاق. قال النحاس وغيره: إن جعلت "ذا" بمعنى الذي كان الاختيار الرفع، على معنى: الذي ينفقون هو العفو، وجاز النصب. وإن جعلت "ما" و"ذا" شيئا واحدا كان الاختيار النصب، على معنى: قل ينفقون العفو، وجاز الرفع. وحكى النحويون: ماذا تعلمت: أنحوا أم شعرا؟ بالنصب والرفع، على أنهما جيدان حسنان، إلا أن التفسير في الآية على النصب.
قال العلماء: لما كان السؤال في الآية المتقدمة في قوله تعالى: "ويسألونك ماذا ينفقون" سؤالا عن النفقة إلى من تصرف، كما بيناه ودل عليه الجواب، والجواب خرج على وفق السؤال، كان السؤال الثاني في هذه الآية عن قدر الإنفاق، وهو في شأن عمرو بن الجموح - كما تقدم - فإنه لما نزل "قل ما أنفقتم من خير فللوالدين" [البقرة: 215] قال: كم أنفق؟ فنزل: "قل العفو" والعفو: ما سهل وتيسر وفضل، ولم يشق على القلب إخراجه، ومنه قول الشاعر:
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
فالمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة، هذا أولى ما قيل في تأويل الآية، وهو معنى قول الحسن وقتادة وعطاء والسدي والقرظي محمد بن كعب وابن أبي ليلى وغيرهم، قالوا: (العفو ما فضل عن العيال)، ونحوه عن ابن عباس وقال مجاهد: صدقة عن ظهر غنى وكذا قال عليه السلام: (خير الصدقة ما أنفقت عن غنى) وفي حديث آخر: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى). وقال قيس بن سعد: هذه الزكاة المفروضة. وقال جمهور العلماء: بل هي نفقات التطوع. وقيل: هي منسوخة. وقال الكلبي: كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله يوما وتصدق بالباقي، حتى نزلت آيه الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية وكل صدقة أمروا بها. وقال قوم: هي محكمة، وفي المال حق سوى الزكاة. والظاهر يدل على القول الأول.
قوله تعالى: "كذلك يبين الله لكم الآيات" قال المفضل بن سلمة: أي في أمر النفقة. "لعلكم تتفكرون" فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبى. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، أي كذلك يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائها فتزهدون فيها، وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيها.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 34
34- تفسير الصفحة رقم34 من المصحفالآية: 216 {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون}
قوله تعالى: "كتب" معناه فرض، وقد تقدم مثله. وقرأ قوم "كتب عليكم القتل"، وقال الشاعر:
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول
هذا هو فرض الجهاد، بين سبحانه أن هذا مما امتحنوا به وجعل وصلة إلى الجنة. والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار، وهذا كان معلوما لهم بقرائن الأحوال، ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة، فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين فقال تعالى: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا" [الحج: 39] ثم أذن له في قتال المشركين عامة. واختلفوا من المراد بهذه الآية، فقيل: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين عليهم، فلما استقر الشرع صار على الكفاية، قال عطاء والأوزاعي. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب الغزو على الناس في هذه الآية؟ فقال: لا، إنما كتب على أولئك. وقال الجمهور من الأمة: أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير لوجوب طاعته. وقال سعيد بن المسيب: إن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبدا، حكاه الماوردي. قال ابن عطية: والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين، وسيأتي هذا مبينا في سورة "براءة" إن شاء الله تعالى. وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنه قال: الجهاد تطوع. قال ابن عطية: وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد، فقيل له: ذلك تطوع.
قوله تعالى: "وهو كره لكم" ابتداء وخبر، وهو كره في الطباع. قال ابن عرفة: الكره، المشقة والكره - بالفتح - ما أكرهت عليه، هذا هو الاختيار، ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين، يقال: كرهت الشيء كرها وكرها وكراهة وكراهية، وأكرهته عليه إكراها. وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل، والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس، فكانت كراهيتهم لذلك، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال عكرمة في هذه الآية: إنهم كرهوه ثم أحبوه وقالوا: سمعنا وأطعنا، وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن مشقة، لكن إذا عرف الثواب هان في جنبه مقاساة المشقات.
قلت: ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه كقطع عضو وقلع ضرس، وفصد وحجامة ابتغاء العافية ودوام الصحة، ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدق.
قوله تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئا" قيل: "عسى": بمعنى قد، قاله الأصم. وقيل: هي واجبة. و"عسى" من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى: "عسى ربه إن طلقكن أن يبدله" [التحريم: 5]. وقال أبو عبيدة: "عسى" من الله إيجاب، والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا، وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم.
قلت: وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في بلاد الأندلس، تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد؟! وأسر وقتل وسبى واسترق، فإنا لله وإنا إليه راجعون! ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته! وقال الحسن في معنى الآية: لا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أم تحبه فيه عطبك، وأنشد أبو سعيد الضرير:
رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه
خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه
الآية: 217 {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}
قوله تعالى: "يسألونك" تقدم القول فيه. وروى جرير بن عبدالحميد ومحمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:(ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة كلهن في القرآن: "يسألونك عن المحيض"، "يسألونك عن الشهر الحرام"، "يسألونك عن اليتامى"، ما كانوا يسألونك إلا عما ينفعهم). قال ابن عبدالبر: ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث. وروى أبو اليسار عن جندب بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارث أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث عبدالله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: ولا تكرهن أصحابك على المسير، فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله، قال: فرجع رجلان ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب، فقال المشركون: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى: "يسألونك عن الشهر الحرام" الآية. وروى أن سبب نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في أول يوم من رجب فقتلهما، فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام، فنزلت الآية. والقول بأن نزولها في قصة عبدالله بن جحش أكثر وأشهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع تسعة رهط ، وقيل ثمانية، في جمادى الآخرة قبل بدر بشهرين، وقيل في رجب. قال أبو عمر - في كتاب الدرر له - : ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب كرز بن جابر - وتعرف تلك الخرجة ببدر الأولى - أقام بالمدينة بقية جمادى الآخرة ورجب، وبعث في رجب عبدالله بن جحش بن رئاب الأسدي ومعه ثمانية رجال من المهاجرين، وهم أبو حذيفة بن عتبة، وعكاشة بن محصن، وعتبة بن غزوان، وسهيل بن بيضاء الفهري، وسعد بن أبي وقاص، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبدالله التميمي، وخالد بن بكير الليثي. وكتب لعبدالله بن جحش كتابا، وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره أحدا من أصحابه، وكان أميرهم، ففعل عبدالله بن جحش ما أمره به، فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: (إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا، وتعلم لنا من أخبارهم). فلما قرأ الكتاب قال: سمعا وطاعة، ثم أخبر أصحابه بذلك، وبأنه لا يستكره أحدا منهم، وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه، وأنه إن لم يطعه أحد مضى وحده، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. فقالوا: كلنا نرغب فيما ترغب فيه، وما منا أحد إلا وهو سامع مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهضوا معه، فسلك على الحجاز، وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان جمل كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه، ونفذ عبدالله بن جحش مع سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة، فمرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي - واسم الحضرمي عبدالله بن عباد من الصدف، والصدف بطن من حضرموت - وعثمان بن عبدالله بن المغيرة، وأخوه نوفل بن عبدالله بن المغيرة المخزوميان، والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام: وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، ثم اتفقوا على لقائهم، فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبدالله، ثم قدموا بالعير والأسيرين، وقال لهم عبدالله بن جحش: اعزلوا مما غنمنا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا، فكان أول خمس في الإسلام، ثم نزل القرآن: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه" [الأنفال: 41] فأقر الله ورسوله فعل عبدالله بن جحش ورضيه وسنه للأمة إلى يوم القيامة، وهي أول غنيمة غنمت في الإسلام، وأول أمير، وعمرو بن الحضرمي أول قتيل. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فسقط في أيدي القوم، فأنزل الله عز وجل: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه" إلى قوله: "هم فيها خالدون". وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء في الأسيرين، فأما عثمان بن عبدالله فمات بمكة كافرا، وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد ببئر معونة، ورجع سعد وعتبة إلى المدينة سالمين.
وقيل: إن انطلاق سعد بن أبي وقاص وعتبة في طلب بعيرهما كان عن إذن من عبدالله بن جحش، وإن عمرو بن الحضرمي وأصحابه لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هابوهم، فقال عبدالله بن جحش: إن القوم قد فزعوا منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض لهم، فإذا رأوه محلوقا أمنوا وقالوا: قوم عمار لا بأس عليكم، وتشاوروا في قتالهم، الحديث. وتفاءلت اليهود وقالوا: واقد وقدت الحرب، وعمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب. وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم، فقال: لا نفديهما حتى يقدم سعد وعتبة، وإن لم يقدما قتلناهما بهما، فلما قدما فاداهما فأما الحكم فأسلم وأقام بالمدينة حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا، وأما عثمان فرجع إلى مكة فمات بها كافرا، وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعا فقتله الله تعالى، وطلب المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية) فهذا سبب نزول قوله تعالى: "يسألونك عن الشهر الحرام". وذكر ابن إسحاق أن قتل عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب، على ما تقدم. وذكر الطبري عن السدي وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من جمادى الآخرة، والأول أشهر، على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان في أول ليلة من رجب، والمسلمون يظنونها من جمادى. قال ابن عطية: وذكر الصاحب بن عباد في رسالته المعروفة بالأسدية أن عبدالله بن جحش سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمرا على جماعة من المؤمنين.
واختلف العلماء في نسخ هذه الآية، فالجمهور على نسخها، وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح. واختلفوا في ناسخها، فقال الزهري: نسخها "وقاتلوا المشركين كافة" [التوبة: 36]. وقيل نسخها غزو النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في الشهر الحرام، وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام. وقيل: نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة، وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتل عثمان بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم لا على الابتداء بقتالهم. وذكر البيهقي عن عروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في أثر قصة الحضرمي: فأنزل عز وجل: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه" الآية، قال: فحدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان، وأن الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدهم عن سبيل الله حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه، وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين، وفتنتهم إياهم عن الدين، فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه، حتى أنزل الله عز وجل: "براءة من الله ورسوله" [التوبة: 1]. وكان عطاء يقول: الآية محكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم، ويحلف على ذلك، لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة، وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق. وروى أبو الزبير عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى.
قوله تعالى: "قتال فيه" "قتال" بدل عند سيبويه بدل اشتمال، لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال، أي يسألك الكفار تعجبا من هتك حرمة الشهر، فسؤالهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. قال الزجاج: المعنى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. وقال القتبي: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالا من الشهر، وأنشد سيبويه:
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما
وقرأ عكرمة: "يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه قل قتل" بغير ألف فيهما. وقيل: المعنى يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه، وهكذا قرأ ابن مسعود، فيكون مخفوضا بعن على التكرير، قاله الكسائي. وقال الفراء: هو مخفوض على نية عن. وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار. قال النحاس: لا يجوز أن يعرب الشيء على الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط، وإنما وقع في شيء شاذ، وهو قولهم: هذا جحر ضب خرب، والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية: هذان: جحرا ضب خربان، وإنما هذا بمنزلة الإقواء، ولا يجوز أن يحمل شيء من كتاب الله على هذا، ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها. قال ابن عطية: وقال أبو عبيدة: هو خفض على الجوار، وقوله هذا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز إضمار عن، والقول فيه أنه بدل. وقرأ الأعرج: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه" بالرفع. قال النحاس: وهو غامض في العربية، والمعنى فيه يسألونك عن الشهر الحرام أجائز قتال فيه؟ فقوله: "يسألونك" يدل على الاستفهام، كما قال امرؤ القيس:
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل
والمعنى: أترى برقا، فحذف ألف الاستفهام، لأن الألف التي في "أصاح" تدل عليها وإن كانت حرف نداء، كما قال الشاعر:
تروح من الحي أم تبتكر
والمعنى: أتروح، فحذف الألف لأن "أم" تدل عليها.
قوله تعالى: "قل قتال فيه كبير" ابتداء وخبر، أي مستنكر، لأن تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذ إذ كان الابتداء من المسلمين. والشهر في الآية اسم جنس، وكانت العرب قد جعل الله لها الشهر الحرام قواما تعتدل عنده، فكانت لا تسفك دما، ولا تغير في الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد. وسيأتي لهذا مزيد بيان في "المائدة" إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: "وصد عن سبيل الله" ابتداء "وكفر به" عطف على "صد" "والمسجد الحرام" عطف على "سبيل الله" "وإخراج أهله منه" عطف على "صد"، وخبر الابتداء "أكبر عند الله" أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام، قاله المبرد وغيره. وهو الصحيح، لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها. "وكفر به" أي بالله، وقيل: "وكفر به" أي بالحج والمسجد الحرام. "وإخراج أهله منه أكبر" أي أعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر الحرام. وقال الفراء: "صد" عطف على "كبير". "والمسجد" عطف على الهاء في "به"، فيكون الكلام نسقا متصلا غير منقطع. قال ابن عطية: وذلك خطأ، لأن المعنى يسوق إلى أن قوله: "وكفر به" أي بالله عطف أيضا على "كبير"، ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله، وهذا بين فساده. ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه، كما فعلتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر جرما عند الله. وقال عبدالله بن جحش رضي الله عنه:
تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد
صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد
وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد
فإنا وإن غيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد
دما وابن عبدالله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند
وقال الزهري ومجاهد وغيرهما: قوله تعالى: "قل قتال فيه كبير" منسوخ بقوله: "وقاتلوا المشركين كافة" وبقوله: "فاقتلوا المشركين" [التوبة: 5]. وقال عطاء: لم ينسخ، ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرم، وقد تقدم.
قوله تعالى: "والفتنة أكبر من القتل" قال مجاهد وغيره: الفتنة هنا الكفر، أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا، أي أن ذلك أشد اجتراما من قتلكم في الشهر الحرام.
قوله تعالى: "ولا يزالون" ابتداء خبر من الله تعالى، وتحذير منه للمؤمنين من شر الكفرة. قال مجاهد: يعني كفار قريش. و"يردوكم" نصب بحتى، لأنها غاية مجردة.
قوله تعالى: "ومن يرتدد" أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر "فأولئك حبطت" أي بطلت وفسدت، ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلأ فتنتفخ أجوافها، وربما تموت من ذلك، فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام.
واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا، إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يورث أم لا؟ قالت طائفة: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم: ساعة واحدة. وقال آخرون: يستتاب شهرا. وقال آخرون: يستتاب ثلاثا، على ما روي عن عمر وعثمان، وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم. وقال الحسن: يستتاب مائة مرة، وقد روي عنه أنه يقتل دون استتابة، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وهو أحد قولي طاوس وعبيد بن عمير. وذكر سحنون أن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون كان يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب، واحتج بحديث معاذ وأبي موسى، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى إليه وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فقال: اجلس. قال: نعم لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات - فأمر به فقتل، خرجه مسلم وغيره. وذكر أبو يوسف عن أبى حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل، فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام، والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب. والزنديق عندهم والمرتد سواء. وقال مالك: وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. وقد مضى هذا أول "البقرة". واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر، فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا يتعرض له، لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقر عليه. وحكى ابن عبدالحكم عن الشافعي أنه يقتل، لقوله عليه السلام: (من بدل دينه فاقتلوه) ولم يخص مسلما من كافر. وقال مالك: معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث، وهو قول جماعة من الفقهاء. والمشهور عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب ويخرجه من بلده ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار، لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد. واختلفوا في المرتدة، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد: تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث: (من بدل دينه فاقتلوه). و"من" يصلح للذكر والأنثى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدة، وهو قول ابن شبرمة، وإليه ذهب ابن علية، وهو قول عطاء والحسن. واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه) ثم إن ابن عباس لم يقتل المرتدة، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله، وروي عن علي مثله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. واحتج الأولون بقوله عليه السلام: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان...) فعم كل من كفر بعد إيمانه، وهو أصح.
قال الشافعي: إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله. وقال مالك: تحبط بنفس الردة، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك: يلزمه الحج، لأن الأول قد حبط بالردة. وقال الشافعي: لا إعادة عليه، لأن عمله باق. واستظهر علماؤنا بقوله تعالى: "لئن أشركت ليحبطن عملك" [الزمر: 65]. قالوا: وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، لأنه عليه السلام يستحيل منه الردة شرعا. وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الأمة، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم! لكنه لا يشرك لفضل مرتبته، كما قال: "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين" [الأحزاب: 30] وذلك لشرف منزلتهن، وإلا فلا يتصور إتيان منهن صيانة لزوجهن المكرم المعظم، ابن العربي. وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاة شرطا ههنا لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء، فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين، وحكمين متغايرين. وما خوطب به عليه السلام فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه، وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان هتكان أحدهما لحرمة الدين، والثاني لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل هتك حرمة عقاب، وينزل ذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام أو في البلد الحرام أو في المسجد الحرام، يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات. والله أعلم.
اختلاف العلماء في ميراث المرتد: فقال علي بن أبي طالب والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور: ميراثه في بيت المال. وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين: ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين. وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيء، وما كان مكتسبا في حالة الإسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون، وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفصلون بين الأمرين، ومطلق قوله عليه السلام: (لا وراثة بين أهل ملتين) يدل على بطلان قولهم. وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه، سوى عمر بن عبدالعزيز فإنه قال: يرثونه.
الآية: 218 {إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم}
قوله تعالى: "إن الذين آمنوا والذين هاجروا" الآية. قال جندب بن عبدالله وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قتل واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ خمسه الذي وفق في فرضه له عبدالله بن جحش وفي الأسيرين، فعنف المسلمون عبدالله بن جحش وأصحابه حتى شق ذلك عليهم، فتلافاهم الله عز وجل بهذه الآية في الشهر الحرام وفرج عنهم، وأخبر أن لهم ثواب من هاجر وغزا، فالإشارة إليهم في قوله: "إن الذين آمنوا" ثم هي باقية في كل من فعل ما ذكره الله عز وجل. وقيل: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله: "إن الذين آمنوا والذين هاجروا" إلى آخر الآية.
والهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع، وقصد ترك الأول إيثارا للثاني. والهجر ضد الوصل. وقد هجره هجرا وهجرانا، والاسم الهجرة. والمهاجرة من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية. والتهاجر التقاطع. ومن قال: المهاجرة الانتقال من البادية إلى الحاضرة فقد أوهم، بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب، وليس أهل مكة مهاجرين على قوله. "وجاهد" مفاعلة من جهد إذا استخرج الجهد، مجاهدة وجهادا. والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. والجهاد (بالفتح): الأرض الصلبة. "ويرجون" معناه يطمعون ويستقربون. وإنما قال "يرجون" وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، لأمرين: أحدهما لا يدري بما يختم له. والثاني - لئلا يتكل على عمله، والرجاء ينعم، والرجاء أبدا معه خوف ولا بد، كما أن الخوف معه رجاء. والرجاء من الأمل ممدود، يقال: رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة، يقال: ما أتيتك إلا رجاوة الخير. وترجيته وارتجيته ورجيته وكله بمعنى رجوته، قال بشر يخاطب بنته:
فرجي الخير وانتظري إيابي إذا ما القارظ العنزي آبا
وما لي في فلان رجية، أي ما أرجو. وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف، قال الله تعالى: "ما لكم لا ترجون لله وقارا" [نوح: 13] أي لا تخافون عظمة الله، قال أبو ذؤيب:
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل
أي لم يخف ولم يبال. والرجا - مقصور - : ناحية البئر وحافتاها، وكل ناحية رجا. والعوام من الناس يخطئون في قولهم: يا عظيم الرجا، فيقصرون ولا يمدون.
الآية: 219 {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون}
قوله تعالى: "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" فيه تسع مسائل:
قوله تعالى: "يسألونك" السائلون هم المؤمنون، كما تقدم. والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة. وكل شيء غطى شيئا فقد خمره، ومنه "خمروا آنيتكم" فالخمر تخمر العقل، أي تغطيه وتستره، ومن ذلك الشجر الملتف يقال له: الخمر (بفتح الميم لأنه يغطي ما تحته ويستره، يقال منه: أخمرت الأرض كثر خمرها، قال الشاعر:
ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق
أي سيرا مدلين فقد جاوزتما الوهدة التي يستتر بها الذئب وغيره. وقال العجاج يصف جيشا يمشي برايات وجيوش غير مستخف:
في لامع العقبان لا يمشي الخمر يوجه الأرض ويستاق الشجر
ومنه قولهم: دخل في غمار الناس وخمارهم، أي هو في مكان خاف. فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطيه سميت بذلك وقيل: إنما سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال: قد اختمر العجين، أي بلغ إدراكه. وخمر الرأي، أي ترك حتى يتبين فيه الوجه. وقيل: إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل، من المخامرة وهي المخالطة، ومنه قولهم: دخلت في خمار الناس، أي اختلطت بهم. فالمعاني الثلاثة متقاربة، فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت، ثم خالطت العقل، ثم خمرته، والأصل الستر.
والخمر: ماء العنب الذي غلى أو طبخ، وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه، لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام. وإنما ذكر الميسر من بينه فجعل كله قياسا على الميسر، والميسر إنما كان قمارا في الجزر خاصة، فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها.
والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره، والحد في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال، وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه، وهذا ضعيف يرده النظر والخبر، على ما يأتي بيانه في "المائدة والنحل" إن شاء الله تعالى.
قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر. وهذه الآية أول ما نزل في أمر الخمر، ثم بعده: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" [النساء: 43] ثم قوله: "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون" [المائدة: 91] ثم قوله: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" [المائدة: 90] على ما يأتي بيانه في "المائدة".
قوله تعالى: "والميسر" الميسر: قمار العرب بالأزلام. قال ابن عباس: (كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله) فنزلت الآية. وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاوس وعلي بن أبى طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضا: (كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق)، على ما يأتي. وقال مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه. قال علي بن أبي طالب: الشطرنج ميسر العجم. وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء. وسيأتي في "يونس" زيادة بيان لهذا الباب إن شاء الله تعالى.
والميسر مأخوذ من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال: يسر لي كذا إذا وجب فهو ييسر يسرا وميسرا. والياسر: اللاعب بالقداح، وقد يسر ييسر، قال الشاعر:
فأعنهم وايسر بما يسروا به وإذا هم نزلوا بضنك فانزل
وقال الأزهري: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته. والياسر: الجازر، لأنه يجزئ لحم الجزور. قال: وهذا الأصل في الياسر، ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور: ياسرون، لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك. وفي الصحاح: ويسر القوم الجزور أي اجتزروها واقتسموا أعضاءها. قال سحيم بن وثيل اليربوعي:
أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم
كان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام. ويقال: يسر القوم إذا قامروا. ورجل يسر وياسر بمعنى. والجمع أيسار، قال النابغة:
أنى أتمم أيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدما
وقال طرفة:
وهم أيسار لقمان إذا أغلت الشتوة أبداء الجزر
وكان من تطوع بنحرها ممدوحا عندهم، قال الشاعر:
وناجية نحرت لقوم صدق وما ناديت أيسار الجزر
روى مالك في الموطأ عن داود بن حصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، وهذا محمول عند مالك وجمهور أصحابه في الجنس الواحد، حيوانه بلحمه، وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار، لأنه لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر، وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا، فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده إذا كانا من جنس واحد، والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظباء والوعول وسائر الوحوش، وذوات الأربع المأكولات كلها عنده جنس واحد، لا يجوز بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشيء واحد من لحمه بوجه من الوجوه، لأنه عنده من باب المزابنة، كبيع الزبيب بالعنب والزيتون بالزيت والشيرج بالسمسم، ونحو ذلك. والطير عنده كله جنس واحد، وكذلك الحيتان من سمك وغيره. وروي عنه أن الجراد وحده صنف. وقال الشافعي وأصحابه والليث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على حال من الأحوال من جنس واحد كان أم من جنسين مختلفين، على عموم الحديث. وروي عن ابن عباس (أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فقسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءا منها بشاة، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا). قال الشافعي: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفا من الصحابة. قال أبو عمر: قد روي عن ابن عباس (أنه أجاز بيع الشاة باللحم، وليس بالقوي). وذكر عبدالرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يباع حي بميت، يعني الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان: ونحن لا نرى به بأسا. قال المزني: إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز، وإن صح بطل القياس واتبع الأثر. قال أبو عمر: وللكوفيين في أنه جائز بيع اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس والاعتبار، إلا أنه إذا صح الأثر بطل القياس والنظر. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو عمر: ولا أعلمه يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب على ما ذكره مالك في موطئه، وإليه ذهب الشافعي، وأصله أنه لا يقبل المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل سعيد فوجدها أو أكثرها صحاحا. فكره بيع أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه، لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن يخص النص بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البر والماء وإن اختلفت أجناسه، كالطعام الذي هو اسم لكل مأكول أو مشروب، فاعلم.
قوله تعالى: "قل فيهما" يعني الخمر والميسر "إثم كبير" إثم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور، وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه، وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله، إلى غير ذلك. روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، أو تشرب من هذه الخمر كأسا، أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسا، فسقته كأسا. قال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر، إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، وذكره أبو عمر في الاستيعاب. وروي أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تصل إليه، فإنه يأمرك بالصلاة، فقال: إن خدمة الرب واجبة. فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء. فقال: اصطناع المعروف واجب. فقيل له: إنه ينهى عن الزنى. فقال: هو فحش وقبيح في العقل، وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه. فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر. فقال: أما هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع، وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه، فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات. وكان قيس بن عاصم المنقري شرابا لها في الجاهلية ثم حرمها على نفسه، وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، وسب أبويه، ورأى القمر فتكلم بشيء، وأعطى الخمار كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه، وفيها يقول:
رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما
فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما
ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما
فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما
قال أبو عمر: وروى ابن الأعرابي عن المفضل الضبي أن هذه الأبيات لأبي محجن الثقفي قالها في تركه الخمر، وهو القائل رضي الله عنه:
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها
ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها
وجلده عمر الحد عليها مرارا، ونفاه إلى جزيرة في البحر، فلحق بسعد فكتب إليه عمر أن يحبسه فحبسه، وكان أحد الشجعان البهم، فلما كان من أمره في حرب القادسية ما هو معروف حل قيوده وقال لا نجلدك على الخمر أبدا. قال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها أبدا، فلم يشربها بعد ذلك. وفي رواية: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، وأما إذ بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. وذكر الهيثم بن عدي أنه أخبره من رأى قبر أبي محجن بأذربيجان، أو قال: في نواحي جرجان، وقد نبتت عليه ثلاث أصول كرم وقد طالت وأثمرت، وهي معروشة على قبره، ومكتوب على القبر "هذا قبر أبي محجن" قال: فجعلت أتعجب وأذكر قوله:
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة
ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء، فيلعب ببوله وعذرته، وربما يمسح وجهه، حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: أكرمك الله.
وأما القمار فيورث العداوة والبغضاء، لأنه أكل مال الغير بالباطل.
قوله تعالى: "ومنافع للناس" أما في الخمر فربح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماسكة فيها، فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منفعتها، وقد قيل في منافعها: إنها تهضم الطعام، وتقوي الضعف، وتعين على الباه، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي اللون، إلى غير ذلك من اللذة بها. وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:
ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء
إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر:
فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير
وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير
ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب، فكانوا يشترون الجزور ويضربون بسهامهم، فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم ولا يكون عليه من الثمن شيء، ومن بقي سهمه آخر كان عليه ثمن الجزور كله ولا يكون له من اللحم شيء. وقيل: منفعته التوسعة على المحاويج، فإن من قمر منهم كان لا يأكل من الجزور وكان يفرقه في المحتاجين.
وسهام الميسر أحد عشر سهما، منها سبعة لها حظوظ وفيها فروض على عدد الحظوظ، وهي: "الفذ" وفيه علامة واحدة له نصيب وعليه نصيب إن خاب. الثاني: "التوأم" وفيه علامتان وله وعليه نصيبان. الثالث: "الرقيب" وفيه ثلاث علامات على ما ذكرنا. الرابع: "حلس" وله أربع. الخامس: "النافز" والنافس أيضا وله خمس. السادس: "المسبل" وله ست. السابع: "المعلى" وله سبع. فذلك ثمانية وعشرون فرضا، وأنصباء الجزور كذلك في قول الأصمعي. وبقي من السهام أربعة، وهي الأغفال لا فروض لها ولا أنصباء، وهي: "المصدر" و"المضعف" و"المنيح" و"السفيح". وقيل: الباقية الأغفال الثلاثة: "السفيح" و"المنيح" و"الوغد" تزاد هذه الثلاثة لتكثر السهام على الذي يجيلها فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلا. ويسمى المجيل المفيض والضارب والضريب والجمع الضرباء. وقيل: يجعل خلفه رقيب لئلا يحابي أحدا، ثم يجثو الضريب على ركبتيه، ويلتحف بثوب ويخرج رأسه ويدخل يده في الربابة فيخرج. وكانت عادة العرب أن تضرب الجزور بهذه السهام في الشتوة وضيق الوقت وكلب البرد على الفقراء، يشترى الجزور ويضمن الأيسار ثمنها ويرضي صاحبها من حقه، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك منهم، ويسمونه "البرم" قال متمم بن نويرة:
ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا
ثم تنحر وتقسم على عشرة أقسام. قال ابن عطية: وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور، فذكر أنها على قدر حظوظ السهام ثمانية وعشرون قسما، وليس كذلك، ثم يضرب على العشرة فمن فاز سهمه بأن يخرج من الربابة متقدما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء. والربابة (بكسر الراء): شبيهة بالكنانة تجمع فيها سهام الميسر، وربما سموا جميع السهام ربابة، قال أبو ذؤيب يصف الحمار وأتنه:
وكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع
والربابة أيضا: العهد والميثاق، قال الشاعر:
وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب
وفي أحيان ربما تقامروا لأنفسهم ثم يغرم الثمن من لم يفز سهمه، كما تقدم. ويعيش بهذه السيرة فقراء الحي، ومنه قول الأعشى:
المطعمو الضيف إذا ما شتوا والجاعلو القوت على الياسر
ومنه قول الآخر:
بأيديهم مقرومة ومغالق يعود بأرزاق العفاة منيحها
و"المنيح" في هذا البيت المستمنح، لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي قد امَّلس وكثر فوزه، فذلك المنيح الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحد الأغفال فذلك إنما يوصف بالكر، وإياه أراد الأخطل بقوله:
ولقد عطفن على فزارة عطفة كر المنيح وجلن ثم مجالا
وفي الصحاح: "والمنيح سهم من سهام الميسر مما لا نصيب له إلا أن يمنح صاحبه شيئا". ومن الميسر قول لبيد:
إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم فواحش ينعى ذكرها بالمصايف
فهذا كله نفع الميسر، إلا أنه أكل المال بالباطل.
قوله تعالى: "وإثمهما أكبر من نفعهما" أعلم الله جل وعز أن الإثم أكبر من النفع، وأعود بالضرر في الآخرة، فالإثم الكبير بعد التحريم، والمنافع قبل التحريم. وقرأ حمزة والكسائي "كثير" بالثاء المثلثة، وحجتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها. وأيضا فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام. و"كثير" بالثاء المثلثة يعطي ذلك. وقرأ باقي القراء وجمهور الناس "كبير" بالباء الموحدة، وحجتهم أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر، فوصفه بالكبير أليق. وأيضا فاتفاقهم على "أكبر" حجة لـ "كبير" بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض "أكثر" بالثاء المثلثة، إلا في مصحف عبدالله بن مسعود فإن فيه "قل فيهما إثم كثير" "وإثمهما أكثر" بالثاء مثلثة في الحرفين.
قال قوم من أهل النظر: حرمت الخمر بهذه الآية، لأن الله تعالى قد قال: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم" [الأعراف: 33] فأخبر في هذه الآية أن فيها إثما فهو حرام. قال ابن عطية: ليس هذا النظر بجيد، لأن الإثم الذي فيها هو الحرام، لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر.
قلت: وقال بعضهم: في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر لأنه سماه إثما، وقد حرم الإثم في آية أخرى، وهو قوله عز وجل: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم" وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمر، بدليل قول الشاعر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول
قلت: وهذا أيضا ليس بجيد، لأن الله تعالى لم يسم الخمر إثما في هذه الآية، وإنما قال: "قل فيهما إثم كبير" ولم يقل: قل هما إثم كبير. وأما آية "الأعراف" وبيت الشعر فيأتي الكلام فيهما هناك مبينا، إن شاء الله تعالى. وقد قال قتادة: إنما في هذه الآية ذم الخمر، فأما التحريم فيعلم بآية أخرى وهي آية "المائدة" وعلى هذا أكثر المفسرين.
قوله تعالى: "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون" "قل العفو" قراءة الجمهور بالنصب. وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع. واختلف فيه عن ابن كثير. وبالرفع قراءة الحسن وقتادة وابن أبي إسحاق. قال النحاس وغيره: إن جعلت "ذا" بمعنى الذي كان الاختيار الرفع، على معنى: الذي ينفقون هو العفو، وجاز النصب. وإن جعلت "ما" و"ذا" شيئا واحدا كان الاختيار النصب، على معنى: قل ينفقون العفو، وجاز الرفع. وحكى النحويون: ماذا تعلمت: أنحوا أم شعرا؟ بالنصب والرفع، على أنهما جيدان حسنان، إلا أن التفسير في الآية على النصب.
قال العلماء: لما كان السؤال في الآية المتقدمة في قوله تعالى: "ويسألونك ماذا ينفقون" سؤالا عن النفقة إلى من تصرف، كما بيناه ودل عليه الجواب، والجواب خرج على وفق السؤال، كان السؤال الثاني في هذه الآية عن قدر الإنفاق، وهو في شأن عمرو بن الجموح - كما تقدم - فإنه لما نزل "قل ما أنفقتم من خير فللوالدين" [البقرة: 215] قال: كم أنفق؟ فنزل: "قل العفو" والعفو: ما سهل وتيسر وفضل، ولم يشق على القلب إخراجه، ومنه قول الشاعر:
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
فالمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة، هذا أولى ما قيل في تأويل الآية، وهو معنى قول الحسن وقتادة وعطاء والسدي والقرظي محمد بن كعب وابن أبي ليلى وغيرهم، قالوا: (العفو ما فضل عن العيال)، ونحوه عن ابن عباس وقال مجاهد: صدقة عن ظهر غنى وكذا قال عليه السلام: (خير الصدقة ما أنفقت عن غنى) وفي حديث آخر: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى). وقال قيس بن سعد: هذه الزكاة المفروضة. وقال جمهور العلماء: بل هي نفقات التطوع. وقيل: هي منسوخة. وقال الكلبي: كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله يوما وتصدق بالباقي، حتى نزلت آيه الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية وكل صدقة أمروا بها. وقال قوم: هي محكمة، وفي المال حق سوى الزكاة. والظاهر يدل على القول الأول.
قوله تعالى: "كذلك يبين الله لكم الآيات" قال المفضل بن سلمة: أي في أمر النفقة. "لعلكم تتفكرون" فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبى. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، أي كذلك يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائها فتزهدون فيها، وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيها.










الصفحة رقم 34 من المصحف تحميل و استماع mp3