سورة آل عمران | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
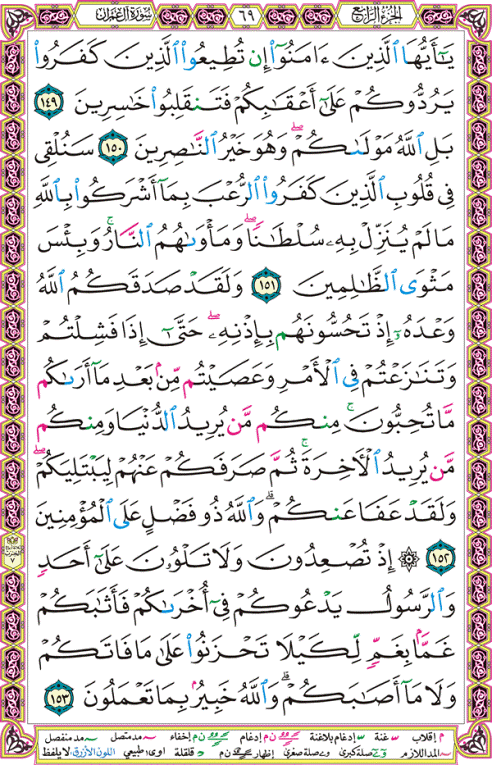
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 69 من المصحف
الآية: 149 - 150 {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين}
لما أمر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء حذر طاعة الكافرين؛ يعني مشركي العرب: أبا سفيان وأصحابه. وقيل: اليهود والنصارى. وقال علي رضي الله عنه: يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دين آبائكم. "يردوكم على أعقابكم"
أي إلى الكفر. "فتنقلبوا خاسرين" أي فترجعوا مغبونين. ثم قال: "بل الله مولاكم" أي متولي نصركم وحفظكم إن أطعتموه. وقرئ "بل الله" بالنصب، على تقدير بل وأطيعوا الله مولاكم.
الآية: 151 {سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين}
نظيره "وقذف في قلوبهم الرعب". وقرأ ابن عامر والكسائي "الرعب" بضم العين؛ وهما لغتان. والرعب: الخوف؛ يقال: رَعَبْته رُعْبا ورُعُبا، فهو مرعوب. ويجوز أن يكون الرعْب مصدرا، والرُّعُب الاسم. وأصله من الملء؛ يقال سيل راعب يملأ الوادي. ورعبت الحوض ملأته. والمعنى: سنملأ قلوب المشركين خوفا وفزعا. وقرأ السختياني "سَيُلْقي" بالياء، والباقون بنون العظمة. قال السدي وغيره: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة انطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا ! قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم؛ فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام؛ قال الله تعالى: "وألقى الألواح" [الأعراف: 150] "فألقوا حبالهم وعصيهم" [الشعراء: 44] "فألقى عصاه" [الأعراف: 107]. قال الشاعر:
فألقت عصاها واستقر بها النوى
ثم قد يستعمل مجازا كما في هذه الآية، وقوله: "وألقيت عليك محبة مني" [طه: 39]. وألقى عليك مسألة.
قوله تعالى: "بما أشركوا بالله" تعليل؛ أي كان سبب إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم؛ فما للمصدر. وبقال أشرك به أي عدل به غيره ليجعله شريكا. "ما لم ينزل به سلطانا" حجة وبيانا، وعذرا وبرهانا؛ ومن هذا قيل للوالي سلطان؛ لأنه حجة الله عز وجل في الأرض. ويقال: إنه مأخوذ من السليط وهو ما يضاء به السراج، وهو دهن السمسم؛ قال امرؤ القيس:
أمال السليط بالذُّبال المفتل
فالسلطان يستضاء به في إظهار الحق وقمع الباطل. وقيل السليط الحديد. والسلاطة الحدة. والسلاطة من التسليط وهو القهر؛ والسلطان من ذلك، فالنون زائدة. فأصل السلطان القوة، فإنه يقهر بها كما يقهر بالسلطان. والسليطة المرأة الصخابة. والسليط الرجل الفصيح اللسان. ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان في شيء من الِملل. ولم يدل عقل على جواز ذلك. ثم أخبر الله تعالى عن مصيرهم ومرجعهم فقال: "ومأواهم النار" ثم ذمه فقال: "وبئس مثوى الظالمين" والمثوى: المكان الذي يقام فيه؛ يقال: ثَوَى يَثْوي ثَواء. والمأوى: كل مكان يرجع إليه شيء ليلا أو نهارا.
الآية: 152 {ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين}
قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أحد وقد أصيبوا قال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر ! فنزلت هذه الآية. وذلك أنهم قتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء، وكان الظفر ابتداء للمسلمين غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة، وترك بعض الرماة أيضا مركزهم طلبا للغنيمة فكان ذلك سبب الهزيمة. روى البخاري عن البراء بن عازب قال: لما كان يوم أحد ولقينا المشركين أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من الرماة وأمَّر عليهم عبدالله بن جبير وقال لهم: (لا تبرحوا من مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تعينونا عليهم) قال: فلما التقى القوم وهزمهم المسلمون حتى نظرنا إلى النساء يشتددن في الجبل، وقد رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فجعلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم عبدالله: أمهلوا ! أما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فانطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقتل من المسلمين سبعون رجلا. ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو في نشز فقال: أفي القوم محمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجيبوه) حتى قالها ثلاثا. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجيبوه) ثم قال: أفي القوم عمر بن الخطاب ؟ ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجيبوه) ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه دون أن قال: كذبت يا عدو الله ! قد أبقى الله لك من يخزيك به. فقال: اعْلُ هُبَل؛ مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أجيبوه) فقالوا: ما نقول يا رسول الله ؟ قال: (قولوا الله أعلى وأجل). قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، (أجيبوه). قالوا: ما نقول يا رسول الله ؟ قال: قولوا (الله مولانا ولا مولى لكم). قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، أما إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني جبريل وميكائيل. وفي رواية أخرى: يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. وعن مجاهد قال: لم تقاتل الملائكة معهم يومئذ، ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. قال البيهقي: إنما أراد مجاهد أنهم لم يقاتلوا يوم أحد عن القوم حين عصوا الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم به. وعن عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين: وكان قد فعل؛ فلما عصوا أمر الرسول وتركوا مصافهم وتركوا الرماة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ألا يبرحوا من منازلهم، وأرادوا الدنيا، رفع عنهم مدد الملائكة، وأنزل الله تعالى: "ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه" [آل عمران: 152] فصدق الله وعده وأراهم الفتح، فلما عصوا أعقبهم البلاء. وعن عمير بن إسحاق قال: لما كان يوم أحد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد يرمي بين يديه، وفتى ينبل له، كلما ذهبت نبلة أتاه بها. قال ارم أبا إسحاق. فلما فرغوا نظروا من الشاب ؟ فلم يروه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما قتل صاحب لواء المشركين وسقط لواؤهم، رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية؛ وفي ذلك يقول حسان:
فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب
و "تحسونهم" معناه تقتلونهم وتستأصلونهم؛ قال الشاعر:
حسَسْناهم بالسيف حسا فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا
وقال جرير:
تحسهم السيوف كما تسامى حريق النار في الأجم الحصيد
قال أبو عبيد: الحَسُّ الاستئصال بالقتل؛ يقال: جراد محسوس إذا قتله البرد. والبرد محسة للنبت. أي محرقة له ذاهبة به. وسنة حسوس أي جدبة تأكل كل شيء؛ قال رؤبة:
إذا شكونا سنة حسوسا تأكل بعد الأخضر اليبيسا
وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة. فمعنى حسه أذهب حسه بالقتل. "بإذنه" بعلمه، أو بقضائه وأمره. "حتى إذا فشلتم" أي جبنتم وضعفتم. يقال فشل يفشل فهو فشِل وفشْل. وجواب "حتى" محذوف، أي حتى إذا فشلتم امتحنتم. ومثل هذا جائز كقوله: "فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء" [الأنعام: 35] فافعل. وقال الفراء: جواب "حتى"، "وتنازعتم" والواو مقحمة زائدة؛ كقوله "فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه" [الصافات: 103 - 104] أي ناديناه. وقال امرؤ القيس:
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى
أي انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحام الواو من "وعصيتم". أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم عصيتم. وعلى هذا فيه تقديم وتأخير، أي حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم. وقال أبو علي: يجوز أن يكون الجواب "صرفكم عنهم"، و"ثم" زائدة، والتقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنهم وقد أنشد بعض النحويين في زيادتها قول الشاعر:
أراني إذا ما بِتُّ بِتّ على هوى فثُمّ إذا أصبحت أصبحت عاديا
وجوز الأخفش أن تكون زائدة؛ كما في قوله تعالى: "حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم" [التوبة: 118]. وقيل: "حتى" بمعنى "إلى" وحينئذ لا جواب له، أي صدقكم الله وعده إلى أن فشلتم، أي كان ذلك الوعد بشرط الثبات. ومعنى "تنازعتم" اختلفتم؛ يعني الرماة حين قال بعضهم لبعض: نلحق الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبت في مكاننا الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالثبوت فيه. "وعصيتم" أي خالفتم أمر الرسول في الثبوت. "من بعد ما أراكم ما تحبون" يعني من الغلبة التي كانت للمسلمين يوم أحد أول أمرهم؛ وذلك حين صرع صاحب لواء المشركين على ما تقدم، وذلك أنه لما صرع انتشر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصاروا كتائب متفرقة فحاسوا العدو ضربا حتى أجهضوهم عن أثقالهم. وحملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مرات كل ذلك تنضح بالنبل فترجع مغلوبة، وحمل المسلمون فنهكوهم قتلا. فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم قالوا: والله ما نجلس ههنا لشيء، قد أهلك الله العدو وإخواننا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم: علام نقف وقد هزم الله العدو ؟ فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوها، وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول فأوجفت الخيل فيهم قتلا. وألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم، ووجه التوبيخ لهم أنهم رأوا مبادئ النصر، فكان الواجب أن يعلموا أن تمام النصر في الثبات لا في الانهزام. ثم بين سبب التنازع. فقال: "منكم من يريد الدنيا" يعني الغنيمة. قال ابن مسعود: ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. "ومنكم من يريد الآخرة" وهم الذين ثبتوا في مركزهم، ولم يخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم مع أميرهم عبدالله بن جبير؛ فحمل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل عليه، وكانا يومئذ كافرين فقتلوه مع من بقي، رحمهم الله. والعتاب مع من انهزم لا مع من ثبت، فإن من ثبت فاز بالثواب، وهذا كما أنه إذا حل بقوم عقوبة عامة فأهل الصلاح والصبيان يهلكون؛ ولكن لا يكون ما حل بهم عقوبة، بل هو سبب المثوبة. والله أعلم.
قوله تعالى: "ثم صرفكم عنهم ليبتليكم" أي بعد أن استوليتم عليهم ردكم عنهم بالانهزام. ودل هذا على أن المعصية مخلوقة لله تعالى. وقالت المعتزلة: المعنى ثم انصرفتم؛ فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرعب من قلوب الكافرين من المسلمين ابتلاء لهم. قال القشيري: وهذا لا يغنيهم؛ لأن إخراج الرعب من قلوب الكافرين حتى يستخفوا بالمسلمين قبيح ولا يجوز عندهم، أن يقع من الله قبيح، فلا يبقى لقوله: "ثم صرفكم عنهم" معنى. وقيل: معنى "صرفكم عنهم" أي لم يكلفكم طلبهم.
قوله تعالى: "ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين" أي لم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة. والخطاب قيل هو للجميع. وقيل: هو للرماة الذين خالفوا ما أمروا به، واختاره النحاس. وقال أكثر المفسرين: ونظير هذه الآية قوله: "ثم عفونا عنكم" [البقرة: 52]. "والله ذو فضل على المؤمنين" بالعفو والمغفرة. وعن ابن عباس قال: ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد، قال: وأنكرنا ذلك، فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: "ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه - يقول ابن عباس: والحَس القتل - حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين" وإنما عنى بهذا الرماة. وذلك أن النبّي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: (احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا). فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين انكفأت الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينتهبون، وقد التقت صفوف أصحاب النبّي صلى الله عليه وسلم، فهم هكذا - وشبك أصابع يديه - والتبسوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة، وجال المسلمون نحو الجبل، ولم يبلغوا حيث يقول الناس: الغار، إنما كانوا تحت المهراس وصاح الشيطان: قتل محمد. فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل حتى طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين، نعرفه بتكفئه إذا مشى. قال: ففرحنا حتى كأنا لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقي نحونا وهو يقول: (اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيهم). وقال كعب بن مالك: أنا كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين؛ عرفته بعينيه من تحت المغفر تزهران فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين! ابشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل. فأشار إليّ أن اسكت.
الآية: 153 {إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون}
قوله: "إذ" متعلق بقوله: "ولقد عفا عنكم". وقراءة العامة "تصعدون" بضم التاء وكسر العين. وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبو عبدالرحمن السلمي والحسن وقتادة بفتح التاء والعين، يعني تصعدون الجبل. وقرأ ابن محيصن وشبل "إذ يصعدون ولا يلوون" بالياء فيهما. وقرأ الحسن "تَلُون" بواو واحدة. وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم "ولا تلوون" بضم التاء؛ وهي لغة شاذة ذكرها النحاس. وقال أبو حاتم: أصعدت إذا مضيت حيال وجهك، وصعدت إذا ارتقيت في جبل أو غيره. فالإصعاد: السير في مستو من الأرض وبطون الأودية والشعاب. والصعود: الارتفاع على الجبال والسطوح والسلاليم والدرج. فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي؛ فيصح المعنى على قراءة "تُصْعِدون" و"تَصْعَدون". قال قتادة والربيع: أصعدوا يوم أحد في الوادي. وقراءة أبي "إذ تصعدون في الوادي". قال ابن عباس: صعدوا في أحد فرارا. فكلتا القراءتين صواب؛ كان يومئذ من المنهزمين مصعد وصاعد. والله أعلم. قال القتبي والمبرد: أصعد إذا أبعد في الذهاب وأمعن فيه؛ فكأن الإصعاد إبعاد في الأرض كإبعاد الارتفاع؛ قال الشاعر:
ألا أيهذا السائلي أين أصعدت فإن لها من بطن يثرب موعدا
وقال الفراء: الإصعاد الابتداء في السفر، والانحدار الرجوع منه؛ يقال: أصعدنا من بغداد إلى مكة وإلى خراسان وأشباه ذلك إذا خرجنا إليها وأخذنا في السفر، وانحدرنا إذا رجعنا. وأنشد أبو عبيدة:
قد كنت تبكين على الإصعاد فاليوم سُرِّحْتِ وصاح الحادي
وقال المفضل: صِعِد وأصْعَد وصَعَّد بمعنى واحد. ومعنى "تلوون" تعرجون وتقيمون، أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هربا؛ فإن المعرج على الشيء يلوي إليه عنقه أو عنان دابته. "على أحد" يريد محمدا صلى الله عليه وسلم؛ قاله الكلبي. "والرسول يدعوكم في أخراكم" أي في آخركم؛ يقال: جاء فلان في آخر الناس وأخرة الناس وأخرى الناس وأخريات الناس. وفي البخاري "أُخْراكُم" تأنيث آخركم: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبدالله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلا. قال ابن عباس وغيره: كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (أي عباد الله ارجعوا) وكان دعاءه تغييرا للمنكر، ومحال أن يرى عليه السلام المنكر وهو الانهزام ثم لا ينهى عنه.
قلت: هذا على أن يكون الانهزام معصية وليس كذلك، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: "فأثابكم غما بغم" الغم في اللغة: التغطية. غممت الشيء غطيته. ويوم غم وليلة غمة إذا كانا مظلمين. ومنه غم الهلال إذا لم ير، وغمني الأمر يغمني. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: الغم الأول القتل والجراح، والغم الثاني الإرجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ صاح به الشيطان. وقيل: الغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني ما أصابهم من القتل والهزيمة. وقيل: الغم الأول الهزيمة، والثاني إشراف أبي وسفيان وخالد عليهم في الجبل؛ فلما نظر إليهم المسلمون غمهم ذلك، وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهم؛ فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم لا يعلن علينا) كما تقّدم. والباء في "بغم" على هذا بمعنى على. وقيل: هي على بابها، والمعنى أنهم غموا النبّي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم إياه، فأثابهم بذلك غمهم بمن أصيب منهم. وقال الحسن: "فأثابكم غما" يوم أحد "بغم" يوم بدر للمشركين. وسمي الغم ثوابا كما سمي جزاء الذنب ذنبا. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم فشغلوا بذلك عما أصابهم.
قوله تعالى: "لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون" اللام متعلقة بقوله: "ولقد عفا عنكم" وقيل: هي متعلقة بقوله: "فأثابكم غما بغم" أي كان هذا الغم بعد الغم لكيلا تحزنوا على ما فات من الغنيمة، ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأول أحسن. و"ما" في قوله "ما أصابكم" في موضع خفض. وقيل: "لا" صلة. أي لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم على مخالفتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مثل قوله: "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك" [الأعراف: 12] أي أن تسجد. وقوله "لئلا يعلم أهل الكتاب" [الحديد: 29] أي ليعلم، وهذا قول المفضل. وقيل: أراد بقوله "فأثابكم غما بغم" أي توالت عليكم الغموم، لكيلا تشتغلوا بعد هذا بالغنائم. "والله خبير بما تعملون" فيه معنى التحذير والوعيد.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 69
69- تفسير الصفحة رقم69 من المصحفالآية: 149 - 150 {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين}
لما أمر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء حذر طاعة الكافرين؛ يعني مشركي العرب: أبا سفيان وأصحابه. وقيل: اليهود والنصارى. وقال علي رضي الله عنه: يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دين آبائكم. "يردوكم على أعقابكم"
أي إلى الكفر. "فتنقلبوا خاسرين" أي فترجعوا مغبونين. ثم قال: "بل الله مولاكم" أي متولي نصركم وحفظكم إن أطعتموه. وقرئ "بل الله" بالنصب، على تقدير بل وأطيعوا الله مولاكم.
الآية: 151 {سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين}
نظيره "وقذف في قلوبهم الرعب". وقرأ ابن عامر والكسائي "الرعب" بضم العين؛ وهما لغتان. والرعب: الخوف؛ يقال: رَعَبْته رُعْبا ورُعُبا، فهو مرعوب. ويجوز أن يكون الرعْب مصدرا، والرُّعُب الاسم. وأصله من الملء؛ يقال سيل راعب يملأ الوادي. ورعبت الحوض ملأته. والمعنى: سنملأ قلوب المشركين خوفا وفزعا. وقرأ السختياني "سَيُلْقي" بالياء، والباقون بنون العظمة. قال السدي وغيره: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة انطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا ! قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم؛ فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام؛ قال الله تعالى: "وألقى الألواح" [الأعراف: 150] "فألقوا حبالهم وعصيهم" [الشعراء: 44] "فألقى عصاه" [الأعراف: 107]. قال الشاعر:
فألقت عصاها واستقر بها النوى
ثم قد يستعمل مجازا كما في هذه الآية، وقوله: "وألقيت عليك محبة مني" [طه: 39]. وألقى عليك مسألة.
قوله تعالى: "بما أشركوا بالله" تعليل؛ أي كان سبب إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم؛ فما للمصدر. وبقال أشرك به أي عدل به غيره ليجعله شريكا. "ما لم ينزل به سلطانا" حجة وبيانا، وعذرا وبرهانا؛ ومن هذا قيل للوالي سلطان؛ لأنه حجة الله عز وجل في الأرض. ويقال: إنه مأخوذ من السليط وهو ما يضاء به السراج، وهو دهن السمسم؛ قال امرؤ القيس:
أمال السليط بالذُّبال المفتل
فالسلطان يستضاء به في إظهار الحق وقمع الباطل. وقيل السليط الحديد. والسلاطة الحدة. والسلاطة من التسليط وهو القهر؛ والسلطان من ذلك، فالنون زائدة. فأصل السلطان القوة، فإنه يقهر بها كما يقهر بالسلطان. والسليطة المرأة الصخابة. والسليط الرجل الفصيح اللسان. ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان في شيء من الِملل. ولم يدل عقل على جواز ذلك. ثم أخبر الله تعالى عن مصيرهم ومرجعهم فقال: "ومأواهم النار" ثم ذمه فقال: "وبئس مثوى الظالمين" والمثوى: المكان الذي يقام فيه؛ يقال: ثَوَى يَثْوي ثَواء. والمأوى: كل مكان يرجع إليه شيء ليلا أو نهارا.
الآية: 152 {ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين}
قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أحد وقد أصيبوا قال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر ! فنزلت هذه الآية. وذلك أنهم قتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء، وكان الظفر ابتداء للمسلمين غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة، وترك بعض الرماة أيضا مركزهم طلبا للغنيمة فكان ذلك سبب الهزيمة. روى البخاري عن البراء بن عازب قال: لما كان يوم أحد ولقينا المشركين أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من الرماة وأمَّر عليهم عبدالله بن جبير وقال لهم: (لا تبرحوا من مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تعينونا عليهم) قال: فلما التقى القوم وهزمهم المسلمون حتى نظرنا إلى النساء يشتددن في الجبل، وقد رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فجعلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم عبدالله: أمهلوا ! أما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فانطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقتل من المسلمين سبعون رجلا. ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو في نشز فقال: أفي القوم محمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجيبوه) حتى قالها ثلاثا. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجيبوه) ثم قال: أفي القوم عمر بن الخطاب ؟ ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجيبوه) ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه دون أن قال: كذبت يا عدو الله ! قد أبقى الله لك من يخزيك به. فقال: اعْلُ هُبَل؛ مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أجيبوه) فقالوا: ما نقول يا رسول الله ؟ قال: (قولوا الله أعلى وأجل). قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، (أجيبوه). قالوا: ما نقول يا رسول الله ؟ قال: قولوا (الله مولانا ولا مولى لكم). قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، أما إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني جبريل وميكائيل. وفي رواية أخرى: يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. وعن مجاهد قال: لم تقاتل الملائكة معهم يومئذ، ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. قال البيهقي: إنما أراد مجاهد أنهم لم يقاتلوا يوم أحد عن القوم حين عصوا الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم به. وعن عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين: وكان قد فعل؛ فلما عصوا أمر الرسول وتركوا مصافهم وتركوا الرماة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ألا يبرحوا من منازلهم، وأرادوا الدنيا، رفع عنهم مدد الملائكة، وأنزل الله تعالى: "ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه" [آل عمران: 152] فصدق الله وعده وأراهم الفتح، فلما عصوا أعقبهم البلاء. وعن عمير بن إسحاق قال: لما كان يوم أحد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد يرمي بين يديه، وفتى ينبل له، كلما ذهبت نبلة أتاه بها. قال ارم أبا إسحاق. فلما فرغوا نظروا من الشاب ؟ فلم يروه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما قتل صاحب لواء المشركين وسقط لواؤهم، رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية؛ وفي ذلك يقول حسان:
فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب
و "تحسونهم" معناه تقتلونهم وتستأصلونهم؛ قال الشاعر:
حسَسْناهم بالسيف حسا فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا
وقال جرير:
تحسهم السيوف كما تسامى حريق النار في الأجم الحصيد
قال أبو عبيد: الحَسُّ الاستئصال بالقتل؛ يقال: جراد محسوس إذا قتله البرد. والبرد محسة للنبت. أي محرقة له ذاهبة به. وسنة حسوس أي جدبة تأكل كل شيء؛ قال رؤبة:
إذا شكونا سنة حسوسا تأكل بعد الأخضر اليبيسا
وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة. فمعنى حسه أذهب حسه بالقتل. "بإذنه" بعلمه، أو بقضائه وأمره. "حتى إذا فشلتم" أي جبنتم وضعفتم. يقال فشل يفشل فهو فشِل وفشْل. وجواب "حتى" محذوف، أي حتى إذا فشلتم امتحنتم. ومثل هذا جائز كقوله: "فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء" [الأنعام: 35] فافعل. وقال الفراء: جواب "حتى"، "وتنازعتم" والواو مقحمة زائدة؛ كقوله "فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه" [الصافات: 103 - 104] أي ناديناه. وقال امرؤ القيس:
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى
أي انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحام الواو من "وعصيتم". أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم عصيتم. وعلى هذا فيه تقديم وتأخير، أي حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم. وقال أبو علي: يجوز أن يكون الجواب "صرفكم عنهم"، و"ثم" زائدة، والتقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنهم وقد أنشد بعض النحويين في زيادتها قول الشاعر:
أراني إذا ما بِتُّ بِتّ على هوى فثُمّ إذا أصبحت أصبحت عاديا
وجوز الأخفش أن تكون زائدة؛ كما في قوله تعالى: "حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم" [التوبة: 118]. وقيل: "حتى" بمعنى "إلى" وحينئذ لا جواب له، أي صدقكم الله وعده إلى أن فشلتم، أي كان ذلك الوعد بشرط الثبات. ومعنى "تنازعتم" اختلفتم؛ يعني الرماة حين قال بعضهم لبعض: نلحق الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبت في مكاننا الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالثبوت فيه. "وعصيتم" أي خالفتم أمر الرسول في الثبوت. "من بعد ما أراكم ما تحبون" يعني من الغلبة التي كانت للمسلمين يوم أحد أول أمرهم؛ وذلك حين صرع صاحب لواء المشركين على ما تقدم، وذلك أنه لما صرع انتشر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصاروا كتائب متفرقة فحاسوا العدو ضربا حتى أجهضوهم عن أثقالهم. وحملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مرات كل ذلك تنضح بالنبل فترجع مغلوبة، وحمل المسلمون فنهكوهم قتلا. فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم قالوا: والله ما نجلس ههنا لشيء، قد أهلك الله العدو وإخواننا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم: علام نقف وقد هزم الله العدو ؟ فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوها، وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول فأوجفت الخيل فيهم قتلا. وألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم، ووجه التوبيخ لهم أنهم رأوا مبادئ النصر، فكان الواجب أن يعلموا أن تمام النصر في الثبات لا في الانهزام. ثم بين سبب التنازع. فقال: "منكم من يريد الدنيا" يعني الغنيمة. قال ابن مسعود: ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. "ومنكم من يريد الآخرة" وهم الذين ثبتوا في مركزهم، ولم يخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم مع أميرهم عبدالله بن جبير؛ فحمل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل عليه، وكانا يومئذ كافرين فقتلوه مع من بقي، رحمهم الله. والعتاب مع من انهزم لا مع من ثبت، فإن من ثبت فاز بالثواب، وهذا كما أنه إذا حل بقوم عقوبة عامة فأهل الصلاح والصبيان يهلكون؛ ولكن لا يكون ما حل بهم عقوبة، بل هو سبب المثوبة. والله أعلم.
قوله تعالى: "ثم صرفكم عنهم ليبتليكم" أي بعد أن استوليتم عليهم ردكم عنهم بالانهزام. ودل هذا على أن المعصية مخلوقة لله تعالى. وقالت المعتزلة: المعنى ثم انصرفتم؛ فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرعب من قلوب الكافرين من المسلمين ابتلاء لهم. قال القشيري: وهذا لا يغنيهم؛ لأن إخراج الرعب من قلوب الكافرين حتى يستخفوا بالمسلمين قبيح ولا يجوز عندهم، أن يقع من الله قبيح، فلا يبقى لقوله: "ثم صرفكم عنهم" معنى. وقيل: معنى "صرفكم عنهم" أي لم يكلفكم طلبهم.
قوله تعالى: "ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين" أي لم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة. والخطاب قيل هو للجميع. وقيل: هو للرماة الذين خالفوا ما أمروا به، واختاره النحاس. وقال أكثر المفسرين: ونظير هذه الآية قوله: "ثم عفونا عنكم" [البقرة: 52]. "والله ذو فضل على المؤمنين" بالعفو والمغفرة. وعن ابن عباس قال: ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد، قال: وأنكرنا ذلك، فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: "ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه - يقول ابن عباس: والحَس القتل - حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين" وإنما عنى بهذا الرماة. وذلك أن النبّي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: (احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا). فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين انكفأت الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينتهبون، وقد التقت صفوف أصحاب النبّي صلى الله عليه وسلم، فهم هكذا - وشبك أصابع يديه - والتبسوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة، وجال المسلمون نحو الجبل، ولم يبلغوا حيث يقول الناس: الغار، إنما كانوا تحت المهراس وصاح الشيطان: قتل محمد. فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل حتى طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين، نعرفه بتكفئه إذا مشى. قال: ففرحنا حتى كأنا لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقي نحونا وهو يقول: (اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيهم). وقال كعب بن مالك: أنا كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين؛ عرفته بعينيه من تحت المغفر تزهران فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين! ابشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل. فأشار إليّ أن اسكت.
الآية: 153 {إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون}
قوله: "إذ" متعلق بقوله: "ولقد عفا عنكم". وقراءة العامة "تصعدون" بضم التاء وكسر العين. وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبو عبدالرحمن السلمي والحسن وقتادة بفتح التاء والعين، يعني تصعدون الجبل. وقرأ ابن محيصن وشبل "إذ يصعدون ولا يلوون" بالياء فيهما. وقرأ الحسن "تَلُون" بواو واحدة. وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم "ولا تلوون" بضم التاء؛ وهي لغة شاذة ذكرها النحاس. وقال أبو حاتم: أصعدت إذا مضيت حيال وجهك، وصعدت إذا ارتقيت في جبل أو غيره. فالإصعاد: السير في مستو من الأرض وبطون الأودية والشعاب. والصعود: الارتفاع على الجبال والسطوح والسلاليم والدرج. فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي؛ فيصح المعنى على قراءة "تُصْعِدون" و"تَصْعَدون". قال قتادة والربيع: أصعدوا يوم أحد في الوادي. وقراءة أبي "إذ تصعدون في الوادي". قال ابن عباس: صعدوا في أحد فرارا. فكلتا القراءتين صواب؛ كان يومئذ من المنهزمين مصعد وصاعد. والله أعلم. قال القتبي والمبرد: أصعد إذا أبعد في الذهاب وأمعن فيه؛ فكأن الإصعاد إبعاد في الأرض كإبعاد الارتفاع؛ قال الشاعر:
ألا أيهذا السائلي أين أصعدت فإن لها من بطن يثرب موعدا
وقال الفراء: الإصعاد الابتداء في السفر، والانحدار الرجوع منه؛ يقال: أصعدنا من بغداد إلى مكة وإلى خراسان وأشباه ذلك إذا خرجنا إليها وأخذنا في السفر، وانحدرنا إذا رجعنا. وأنشد أبو عبيدة:
قد كنت تبكين على الإصعاد فاليوم سُرِّحْتِ وصاح الحادي
وقال المفضل: صِعِد وأصْعَد وصَعَّد بمعنى واحد. ومعنى "تلوون" تعرجون وتقيمون، أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هربا؛ فإن المعرج على الشيء يلوي إليه عنقه أو عنان دابته. "على أحد" يريد محمدا صلى الله عليه وسلم؛ قاله الكلبي. "والرسول يدعوكم في أخراكم" أي في آخركم؛ يقال: جاء فلان في آخر الناس وأخرة الناس وأخرى الناس وأخريات الناس. وفي البخاري "أُخْراكُم" تأنيث آخركم: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبدالله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلا. قال ابن عباس وغيره: كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (أي عباد الله ارجعوا) وكان دعاءه تغييرا للمنكر، ومحال أن يرى عليه السلام المنكر وهو الانهزام ثم لا ينهى عنه.
قلت: هذا على أن يكون الانهزام معصية وليس كذلك، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: "فأثابكم غما بغم" الغم في اللغة: التغطية. غممت الشيء غطيته. ويوم غم وليلة غمة إذا كانا مظلمين. ومنه غم الهلال إذا لم ير، وغمني الأمر يغمني. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: الغم الأول القتل والجراح، والغم الثاني الإرجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ صاح به الشيطان. وقيل: الغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني ما أصابهم من القتل والهزيمة. وقيل: الغم الأول الهزيمة، والثاني إشراف أبي وسفيان وخالد عليهم في الجبل؛ فلما نظر إليهم المسلمون غمهم ذلك، وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهم؛ فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم لا يعلن علينا) كما تقّدم. والباء في "بغم" على هذا بمعنى على. وقيل: هي على بابها، والمعنى أنهم غموا النبّي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم إياه، فأثابهم بذلك غمهم بمن أصيب منهم. وقال الحسن: "فأثابكم غما" يوم أحد "بغم" يوم بدر للمشركين. وسمي الغم ثوابا كما سمي جزاء الذنب ذنبا. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم فشغلوا بذلك عما أصابهم.
قوله تعالى: "لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون" اللام متعلقة بقوله: "ولقد عفا عنكم" وقيل: هي متعلقة بقوله: "فأثابكم غما بغم" أي كان هذا الغم بعد الغم لكيلا تحزنوا على ما فات من الغنيمة، ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأول أحسن. و"ما" في قوله "ما أصابكم" في موضع خفض. وقيل: "لا" صلة. أي لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم على مخالفتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مثل قوله: "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك" [الأعراف: 12] أي أن تسجد. وقوله "لئلا يعلم أهل الكتاب" [الحديد: 29] أي ليعلم، وهذا قول المفضل. وقيل: أراد بقوله "فأثابكم غما بغم" أي توالت عليكم الغموم، لكيلا تشتغلوا بعد هذا بالغنائم. "والله خبير بما تعملون" فيه معنى التحذير والوعيد.










الصفحة رقم 69 من المصحف تحميل و استماع mp3