سورة آل عمران | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
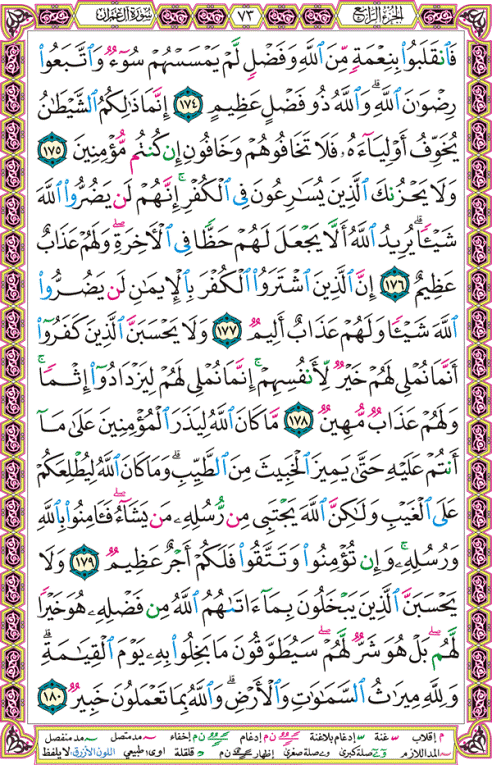
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 73 من المصحف
الآية: 174 {فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم}
قال علماؤنا: لما فوضوا أمورهم إليه، واعتمدوا بقلوبهم عليه، أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة، والفضل، وصرف السوء، واتباع الرضا. فرضاهم عنه، ورضي عنهم.
الآية: 175 {إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين}
قال ابن عباس وغيره: المعنى يخوفكم أولياءه؛ أي بأوليائه، أو من أوليائه؛ فحذف حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم فنصب. كما قال تعالى: "لينذر بأسا شديدا" [الكهف: 2] أي لينذركم ببأس شديد؛ أي يخوف المؤمن بالكافر. وقال الحسن والسدي: المعنى يخوف أولياءه المنافقين؛ ليقعدوا عن قتال المشركين. فأما أولياء الله فإنهم لا يخافونه إذا خوفهم. وقد قيل: إن المراد هذا الذي يخوفكم بجمع الكفار شيطان من شياطين الإنس؛ إما نعيم بن مسعود أو غيره، على الخلاف في ذلك كما تقّدم. "فلا تخافوهم" أي لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: "إن الناس قد جمعوا لكم". أو يرجع إلى الأولياء إن قلت: إن المعنى يخوف بأوليائه أي يخوفكم أولياءه.
قوله تعالى: "وخافون" أي خافوني في ترك أمري إن كنتم مصدقين بوعدي. والخوف في كلام العرب الذعر. وخاوفني فلان فخفته، أي كنت أشد خوفا منه. والخوفاء المفازة لا ماء بها. ويقال: ناقة خوفاء وهي الجرباء. والخافة كالخريطة من الأدم يشتار فيها العسل. قال سهل بن عبدالله: اجتمع بعض الصديقين إلى إبراهيم الخليل فقالوا: ما الخوف؟ فقال: لا تأمن حتى تبلغ المأمن. قال سهل: وكان الربيع بن خيثم إذا مر بكير يغشى عليه؛ فقيل لعلّي بن أبي طالب ذلك؛ فقال: إذا أصابه ذلك فأعلموني. فأصابه فأعلموه، فجاءه فأدخل يده في قميصه فوجد حركته عالية فقال: أشهد أن هذا أخوف أهل زمانكم. فالخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه إما في الدنيا وإما في الآخرة؛ ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، بل الخائف الذي يترك ما يخاف أن يعذب عليه. ففرض الله تعالى على العباد أن يخافوه فقال: وقال: "وإياي فارهبون". ومدح المؤمنين بالخوف فقال: "يخافون ربهم من فوقهم" [النحل: 50]. ولأرباب الإشارات في الخوف عبارات مرجعها إلى ما ذكرنا. قال الأستاذ أبو علّي الدقاق: دخلت على أبي بكر بن فورك رحمه الله عائدا، فلما رأني دمعت عيناه، فقلت له: إن الله يعافيك ويشفيك. فقال لي: أترى أني أخاف من الموت؟ إنما أخاف مما وراء الموت. وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله والله لوددت أني كنت شجرة تعضد". خّرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: (لوددت أني كنت شجرة تعضد). والله أعلم.
الآية: 176 {ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم}
قوله تعالى: "ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر" هؤلاء قوم أسلموا ثم ارتدوا خوفا من المشركين؛ فاغتم النبّي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: "ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر". وقال الكلبّي: يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كتموا صفة النبّي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فنزلت. ويقال: إن أهل الكتاب لما لم يؤمنوا شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الناس ينظرون إليهم ويقولون إنهم أهل كتاب؛ فلو كان قوله حقا لاتبعوه، فنزلت "ولا يحزنك". قراءة نافع بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع إلا في - الأنبياء - "لا يحزنهم الفزع الأكبر" فإنه بفتح الياء وبضم الزاي. وضده أبو جعفر. وقرأ ابن محيض كلها بضم الياء وكسر الزاي. والباقون كلها بفتح الياء وضم الزاي. وهما لغتان: حزنني الأمر يحزنني، وأحزنني أيضا وهي لغة قليلة؛ والأولى أفصح اللغتين؛ قاله النحاس. وقال الشاعر في أحزن:
مضى صحبي وأحزنني الديار
وقراءة العامة "يسارعون". وقرأ طلحة "يسرعون في الكفر". قال الضحاك: هم كفار قريش. وقال غيره: هم المنافقون. وقيل: هو ما ذكرناه قبل. وقيل: هو عام في جميع الكفار. ومسارعتهم في الكفر المظاهرة على محمد صلى الله عليه وسلم. قال القشيري: والحزن على كفر الكافر طاعة؛ ولكن النبّي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن على كفر قومه، فنهي عن ذلك؛ كما قال: "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات" [فاطر: 8] وقال: "فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا" [الكهف: 6].
قوله تعالى: "إنهم لن يضروا الله شيئا" أي لا ينقصون من ملك الله وسلطانه شيئا؛ يعني لا ينقص بكفرهم. وكما روي عن أبي ذر عن النبّي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه). خرجه مسلم في صحيحه والترمذي وغيرهما، وهو حديث عظيم فيه طول يكتب كله. وقيل: معنى "لن يضروا الله شيئا" أي لن يضروا أولياء الله حين تركوا نصرهم إذ كان الله عز وجل ناصرهم.
قوله تعالى: "يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم" أي نصيبا.
والحظ النصيب والجد. يقال: فلان أحظ من فلان، وهو محظوظ. وجمع الحظ أحاظ على غير قياس. قال أبو زيد: يقال رجل حظيظ، أي جديد إذا كان ذا حظ من الرزق. وحظظت في الأمر أحظ. وربما جمع الحظ أحظا. أي لا يجعل لهم نصيبا في الجنة. وهو نص في أن الخير والشر بإرادة الله تعالى.
الآية: 177 {إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم}
قوله تعالى: "إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان" تقدم في البقرة. "لن يضروا الله شيئا" كرر للتأكيد. وقيل: أي من سوء تدبيره استبدال الإيمان بالكفر وبيعه به؛ فلا يخاف جانبه ولا تدبير. وانتصب "شيئا" في الموضعين لوقوعه موقع المصدر؛ كأنه قال: لن يضروا الله ضررا قليلا ولا كثيرا. ويجوز انتصابه على تقدير حذف الباء؛ كأنه قال: لن يضروا الله بشيء.
الآية: 178 {ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين}
قوله تعالى: "ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم" الإملاء طول العمر
ورغد العيش. والمعنى: لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين؛ فإن الله قادر على إهلاكهم، وإنما يطول أعمارهم ليعملوا بالمعاصي، لا لأنه خير لهم. ويقال: "أنما نملي لهم" بما أصابوا من الظفر يوم أحد لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم؛ وإنما كان ذلك ليزدادوا عقوبة. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له؛ لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالى: "وما عند الله خير للأبرار" [آل عمران: 198] وإن كان فاجرا فقد قال الله: وقرأ ابن عامر وعاصم "لا يحسبن" بالياء ونصب السين. وقرأ حمزة: بالتاء ونصب السين. والباقون: بالياء وكسر السين. فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي فلا يحسبن الكفار. و"أنما نملي لهم خير لأنفسهم" تسد مسد المفعولين. و"ما" بمعنى الذي، والعائد محذوف، و"خير" خبر "أن". ويجوز أن تقدر "ما" والفعل مصدرا؛ والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم. ومن قرأ بالتاء فالفعل هو المخاطب، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. و"الذين" نصب على المفعول الأول لتحسب. وأن وما بعدها بدل من الذين، وهي تسد مسد المفعولين، كما تسد لو لم تكن بدلا. ولا يصلح أن تكون "أن" وما بعدها مفعولا ثانيا لتحسب؛ لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول في المعنى؛ لأن حسب وأخواتها داخلة على المبتدأ والخبر؛ فيكون التقدير؛ ولا تحسبن أنما نملي لهم خير. هذا قول الزجاج. وقال أبو علّي: لو صح هذا لقال "خيرا" بالنصب؛ لأن "أن" تصير بدلا من "الذين كفروا"؛ فكأنه قال: لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيرا؛ فقوله "خيرا" هو المفعول الثاني لحسب. فإذا لا يجوز أن يقرأ "لا تحسبن" بالتاء إلا أن تكسر "إن في "أنما" وتنصب خيرا، ولم يرو ذلك عن حمزة، والقراءة عن حمزة بالتاء؛ فلا تصح هذه القراءة إذا. وقال الفراء والكسائي: قراءة حمزة جائزة على التكرير؛ تقديره ولا تحسبن الذي كفروا، ولا تحسبن أنما نملي لهم خيرا، فسدت "أن" مسد المفعولين لتحسب الثاني، وهي وما عملت مفعول ثان لتحسب الأول. قال القشيري: وهذا قريب مما ذكره الزجاج في دعوى البدل، والقراءة صحيحة. فإذا غرض أبي علّي تغليط الزجاج. قال النحاس: وزعم أبو حاتم أن قراءة حمزة بالتاء هنا، وقوله: "ولا يحسبن الذين يبخلون" [آل عمران: 180] لحن لا يجوز. وتبعه على ذلك جماعة.
قلت: وهذا ليس بشيء؛ لما تقدم بيانه من الإعراب، ولصحة القراءة وثبوتها نقلا. وقرأ يحيى بن وثاب "إنما نملي لهم" بكسر إن فيهما جميعا. قال أبو جعفر: وقراءة يحيي حسنة. كما تقول: حسبت عمرا أبوه خالد. قال أبو حاتم وسمعت الأخفش يذكر كسر "إن" يحتج به لأهل القدر؛ لأنه كان منهم. ويجعل على التقديم والتأخير "ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم". قال: ورأيت في مصحف في المسجد الجامع قد زادوا فيه حرفا فصار "إنما نملي لهم إيمانا" فنظر إليه يعقوب القارئ فتبين اللحن فحكه. والآية نص في بطلان مذهب القدرية؛ لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي، وتوالي أمثاله على القلب. كما تقدم بيانه في ضده وهو الإيمان. وعن ابن عباس قال: ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له ثم تلا "إنما نملي لهم ليزدادوا لهم إثما" وتلا "وما عند الله خير للأبرار" أخرجه رزين.
الآية: 179 {ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم}
قال أبو العالية: سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق؛ فأنزل الله عز وجل الآية. واختلفوا من المخاطب بالآية على أقوال. فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبّي وأكثر المفسرين: الخطاب للكفار والمنافقين. أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبّي صلى الله عليه وسلم. قال الكلبّي: إن قريشا من أهل مكة قالوا للنبّي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا تزعم أنه في النار، وأنه إذا ترك ديننا واتبع دينك قلت هو من أهل الجنة! فأخبرنا عن هذا من أين هو؟ وأخبرنا من يأتيك منا؟ ومن لم يأتك؟. فأنزل الله عز وجل "ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه" من الكفر والنفاق.
قوله تعالى: "حتى يميز الخبيث من الطيب" وقيل: هو خطاب للمشركين. والمراد بالمؤمنين في قوله: "ليذر المؤمنين" من في الأصلاب والأرحام ممن يؤمن. أي ما كان الله ليذر أولادكم الذين حكم لهم بالإيمان على ما أنتم عليه من الشرك، حتى يفرق بينكم وبينهم؛ وعلى هذا "وما كان الله ليطلعكم" كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين. وقيل: الخطاب للمؤمنين. أي وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق، حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف؛ فتعرفوا المنافق الخبيث، والمؤمن الطيب. وقد ميز يوم أحد بين الفريقين. وهذا قول أكثر أهل المعاني. "وما كان الله ليطلعكم على الغيب" يا معشر المؤمنين. أي ما كان الله ليعين لكم المنافقين حتى تعرفوهم، ولكن يظهر ذلك لكم بالتكليف والمحنة، وقد ظهر ذلك في يوم أحد؛ فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الشماتة، فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذا، فالآن قد أطلع الله محمدا عليه السلام وصحبه على ذلك. وقيل: معنى "ليطلعكم" أي وما كان الله ليعلمكم ما يكون منهم. فقوله: "وما كان الله ليطلعكم على الغيب" على هذا متصل، وعلى القولين الأولين منقطع. وذلك أن الكفار لما قالوا: لم لم يوح إلينا؟ قال: "وما كان الله ليطلعكم على الغيب" أي على من يستحق النبوة، حتى يكون الوحي باختياركم. "ولكن الله يجتبي" أي يختار. "من رسله" لإطلاع غيبه "من يشاء" يقال: طلعت على كذا واطلعت عليه، وأطلعت عليه غيري؛ فهو لازم ومتعد. وقرئ "حتى يميِّز" بالتشديد من ميز، وكذا في "الأنفال" وهي قراءة حمزة. والباقون "يميز" بالتخفيف من ماز يميز. يقال: مزت الشيء بعضه من بعض أميزه ميزا، وميزته تمييزا. قال أبو معاذ: مزت الشيء أميزه ميزا إذا فرقت بين شيئين. فإن كانت أشياء قلت: ميزتها تمييزا. ومثله إذا جعلت الواحد شيئين قلت: فرقت بينهما، مخففا؛ ومنه فرق الشعر. فإن جعلته أشياء قلت: فرقته تفريقا.
قلت: ومنه امتاز القوم، تميز بعضهم عن بعض. ويكاد يتميز: يتقطع؛ وبهذا فسر قوله تعالى: "تكاد تميز من الغيظ" [الملك: 8] وفي الخبر (من ماز أذى عن الطريق فهو له صدقة).
قوله تعالى: "فآمنوا بالله ورسله" يقال: إن الكفار لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من يؤمن منهم، فأنزل الله "فآمنوا بالله ورسله" يعني لا تشتغلوا بما لا يعنيكم، واشتغلوا بما يعنيكم وهو الإيمان. "فآمنوا" أي صدقوا، أي عليكم التصديق لا التشوف إلى اطلاع الغيب. "وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم" أي الجنة. ويذكر أن رجلا كان عند الحجاج بن يوسف الثقفي منجما؛ فأخذ الحجاج حصيات بيده قد عرف عددها فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب فأصاب المنجم. فأغفله الحجاج وأخذ حصيات لم يعدهن فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب فأخطأ، ثم حسب أيضا فأخطأ؛ فقال: أيها الأمير، أظنك لا تعرف عدد ما في يدك؟ قال لا: قال: فما الفرق بينهما؟ فقال: إن ذاك أحصيته فخرج عن حد الغيب، فحسبت فأصبت، وإن هذا لم تعرف عددها فصار غيبا، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى. وسيأتي هذا الباب في "الأنعام" إن شاء الله تعالى.
الآية: 180 {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير}
قوله تعالى: "ولا يحسبن الذين" "الذين" في موضع رفع، والمفعول الأول محذوف. قال الخليل وسيبويه والفراء المعنى البخل خيرا لهم، أي لا يحسبن الباخلون البخل خيرا لهم. وإنما حذف لدلالة يبخلون على البخل؛ وهو كقوله: من صدق كان خيرا له. أي كان له الصدق خيرا له. ومن هذا قول الشاعر:
إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف
فالمعنى: جرى: إلى السفه؛ فالسفيه دل على السفه. وأما قراءة حمزة بالتاء فبعيدة جدا؛ قاله النحاس. وجوازها أن يكون التقدير: لا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيرا لهم. قال الزجاج: وهي مثل "واسأل القرية". و"هو" في قوله "هو خيرا لهم" فاصلة عند البصريين. وهي العماد عند الكوفيين. قال النحاس: ويجوز في العربية "هو خير لهم" ابتداء وخبر.
قوله تعالى: "بل هو شر لهم" ابتداء وخبر، أي البخل شر لهم. والسين في "سيطوقون" سين الوعيد، أي سوف يطوقون؛ قاله المبرد. وهذه الآية نزلت في البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله، وأداء الزكاة المفروضة. وهذه كقوله: "ولا ينفقونها في سبيل الله" [التوبة: 34] الآية. ذهب إلى هذا جماعة من المتأولين، منهم ابن مسعود وابن عباس وأبو وائل وأبو مالك والسدي والشعبي قالوا: ومعنى "سيطوقون ما بخلوا به" هو الذي ورد في الحديث عن أبي هريرة عن النبّي صلى الله عليه وسلم قال: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك - ثم تلا هذه الآية - "ولا يحسبن الذين يبخلون" الآية). أخرجه النسائي. وخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع حتى يطوق به في عنقه) ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله" الآية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل ما عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمظ حتى يطوقه). وقال ابن عباس أيضا: إنما نزلت في أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما علموه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ذلك مجاهد وجماعة من أهل العلم. ومعنى "سيطوقون" على هذا التأويل سيحملون عقاب ما بخلوا به؛ فهو من الطاقة كما قال تعالى: "وعلى الذين يطيقونه" [البقرة: 184] وليس من التطويق. وقال إبراهيم النخعي: معنى "سيطوقون" سيجعل لهم يوم القيامة طوق من النار. وهذا يجري مع التأويل الأول أي قول السدي. وقيل: يلزمون أعمالهم كما يلزم الطوق العنق؛ يقال: طوق فلان عمله طوق الحمامة، أي ألزم عمله. وقد قال تعالى: "وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه" [الإسراء: 13]. ومن هذا المعنى قول عبدالله بن جحش لأبي سفيان:
أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامه
دار ابن عمك بعتها تقتضي بها عنك الغرامه
وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة
اذهب بها أذهب بها طوقتها طوق الحمامة
وهذا يجري مع التأويل الثاني. والبخل والبخل في اللغة أن يمنع الإنسال الحق الواجب عليه. فأما من منع مالا يجب عليه فليس ببخيل؛ لأنه لا يذم بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يبخلون وقد بخلوا. وسائر العرب يقولون: بخلوا يبخلون؛ حكاه النحاس. وبخل يبخل بخلا وبخلا؛ عن ابن فارس.
في ثمرة البخل وفائدته. وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: (من سيدكم؟) قالوا الجد بن قيس على بخل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: (وأي داء أدوى من البخل) قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: (إن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم فقالوا: ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء؛ وتعتذر النساء ببعد الرجال؛ ففعلوا وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء) ذكره الماوردي في كتاب "أدب الدنيا والدين". والله أعلم.
واختلف في البخل والشح؛ هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين. فقيل: البخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك. والشح: الحرص على تحصيل ما ليس عندك. وقيل: إن الشح هو البخل مع حرص. وهو الصحيح لما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم). وهذا يرد قول من قال: إن البخل منع الواجب، والشح منع المستحب. إذ لو كان الشح منع المستحب لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم، والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا والآخرة. ويؤيد هذا المعنى ما رواه النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبدأ ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبدا). وهذا يدل على أن الشح أشد في الذم من البخل؛ إلا أنه قد جاء ما يدل على مساواتهما وهو قوله - وقد سئل؛ أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: (لا) وذكر الماوردي في كتاب "أدب الدنيا والدين" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: (من سيدكم) قالوا: الجد بن قيس عل بخل فيه؛ الحديث. وقد تقدم.
قوله تعالى: "ولله ميراث السماوات والأرض" أخبر تعالى ببقائه ودوام ملكه. وأنه في الأبد كهو في الأزل غني عن العالمين، فيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم؛ فتبقى الأملاك والأموال لا مدعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة الخلق، وليس هذا بميراث في الحقيقة؛ لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئا لم يكن ملكه من قبل، والله سبحانه وتعالى مالك السموات والأرض وما بينهما، وكانت السموات وما فيها، والأرض وما فيها له، وإن الأموال كانت عارية عند أربابها؛ فإذا ماتوا ردت العارية إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل. ونظير هذه الآية قوله تعالى: "إنا نحن نرث الأرض ومن عليها" [مريم: 40] الآية. والمعنى في الآيتين أن الله تعالى أمر عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل أن يموتوا ويتركوا ذلك ميراثا لله تعالى، ولا ينفعهم إلا ما أنفقوا.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 73
73- تفسير الصفحة رقم73 من المصحفالآية: 174 {فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم}
قال علماؤنا: لما فوضوا أمورهم إليه، واعتمدوا بقلوبهم عليه، أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة، والفضل، وصرف السوء، واتباع الرضا. فرضاهم عنه، ورضي عنهم.
الآية: 175 {إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين}
قال ابن عباس وغيره: المعنى يخوفكم أولياءه؛ أي بأوليائه، أو من أوليائه؛ فحذف حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم فنصب. كما قال تعالى: "لينذر بأسا شديدا" [الكهف: 2] أي لينذركم ببأس شديد؛ أي يخوف المؤمن بالكافر. وقال الحسن والسدي: المعنى يخوف أولياءه المنافقين؛ ليقعدوا عن قتال المشركين. فأما أولياء الله فإنهم لا يخافونه إذا خوفهم. وقد قيل: إن المراد هذا الذي يخوفكم بجمع الكفار شيطان من شياطين الإنس؛ إما نعيم بن مسعود أو غيره، على الخلاف في ذلك كما تقّدم. "فلا تخافوهم" أي لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: "إن الناس قد جمعوا لكم". أو يرجع إلى الأولياء إن قلت: إن المعنى يخوف بأوليائه أي يخوفكم أولياءه.
قوله تعالى: "وخافون" أي خافوني في ترك أمري إن كنتم مصدقين بوعدي. والخوف في كلام العرب الذعر. وخاوفني فلان فخفته، أي كنت أشد خوفا منه. والخوفاء المفازة لا ماء بها. ويقال: ناقة خوفاء وهي الجرباء. والخافة كالخريطة من الأدم يشتار فيها العسل. قال سهل بن عبدالله: اجتمع بعض الصديقين إلى إبراهيم الخليل فقالوا: ما الخوف؟ فقال: لا تأمن حتى تبلغ المأمن. قال سهل: وكان الربيع بن خيثم إذا مر بكير يغشى عليه؛ فقيل لعلّي بن أبي طالب ذلك؛ فقال: إذا أصابه ذلك فأعلموني. فأصابه فأعلموه، فجاءه فأدخل يده في قميصه فوجد حركته عالية فقال: أشهد أن هذا أخوف أهل زمانكم. فالخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه إما في الدنيا وإما في الآخرة؛ ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، بل الخائف الذي يترك ما يخاف أن يعذب عليه. ففرض الله تعالى على العباد أن يخافوه فقال: وقال: "وإياي فارهبون". ومدح المؤمنين بالخوف فقال: "يخافون ربهم من فوقهم" [النحل: 50]. ولأرباب الإشارات في الخوف عبارات مرجعها إلى ما ذكرنا. قال الأستاذ أبو علّي الدقاق: دخلت على أبي بكر بن فورك رحمه الله عائدا، فلما رأني دمعت عيناه، فقلت له: إن الله يعافيك ويشفيك. فقال لي: أترى أني أخاف من الموت؟ إنما أخاف مما وراء الموت. وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله والله لوددت أني كنت شجرة تعضد". خّرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: (لوددت أني كنت شجرة تعضد). والله أعلم.
الآية: 176 {ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم}
قوله تعالى: "ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر" هؤلاء قوم أسلموا ثم ارتدوا خوفا من المشركين؛ فاغتم النبّي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: "ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر". وقال الكلبّي: يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كتموا صفة النبّي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فنزلت. ويقال: إن أهل الكتاب لما لم يؤمنوا شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الناس ينظرون إليهم ويقولون إنهم أهل كتاب؛ فلو كان قوله حقا لاتبعوه، فنزلت "ولا يحزنك". قراءة نافع بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع إلا في - الأنبياء - "لا يحزنهم الفزع الأكبر" فإنه بفتح الياء وبضم الزاي. وضده أبو جعفر. وقرأ ابن محيض كلها بضم الياء وكسر الزاي. والباقون كلها بفتح الياء وضم الزاي. وهما لغتان: حزنني الأمر يحزنني، وأحزنني أيضا وهي لغة قليلة؛ والأولى أفصح اللغتين؛ قاله النحاس. وقال الشاعر في أحزن:
مضى صحبي وأحزنني الديار
وقراءة العامة "يسارعون". وقرأ طلحة "يسرعون في الكفر". قال الضحاك: هم كفار قريش. وقال غيره: هم المنافقون. وقيل: هو ما ذكرناه قبل. وقيل: هو عام في جميع الكفار. ومسارعتهم في الكفر المظاهرة على محمد صلى الله عليه وسلم. قال القشيري: والحزن على كفر الكافر طاعة؛ ولكن النبّي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن على كفر قومه، فنهي عن ذلك؛ كما قال: "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات" [فاطر: 8] وقال: "فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا" [الكهف: 6].
قوله تعالى: "إنهم لن يضروا الله شيئا" أي لا ينقصون من ملك الله وسلطانه شيئا؛ يعني لا ينقص بكفرهم. وكما روي عن أبي ذر عن النبّي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه). خرجه مسلم في صحيحه والترمذي وغيرهما، وهو حديث عظيم فيه طول يكتب كله. وقيل: معنى "لن يضروا الله شيئا" أي لن يضروا أولياء الله حين تركوا نصرهم إذ كان الله عز وجل ناصرهم.
قوله تعالى: "يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم" أي نصيبا.
والحظ النصيب والجد. يقال: فلان أحظ من فلان، وهو محظوظ. وجمع الحظ أحاظ على غير قياس. قال أبو زيد: يقال رجل حظيظ، أي جديد إذا كان ذا حظ من الرزق. وحظظت في الأمر أحظ. وربما جمع الحظ أحظا. أي لا يجعل لهم نصيبا في الجنة. وهو نص في أن الخير والشر بإرادة الله تعالى.
الآية: 177 {إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم}
قوله تعالى: "إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان" تقدم في البقرة. "لن يضروا الله شيئا" كرر للتأكيد. وقيل: أي من سوء تدبيره استبدال الإيمان بالكفر وبيعه به؛ فلا يخاف جانبه ولا تدبير. وانتصب "شيئا" في الموضعين لوقوعه موقع المصدر؛ كأنه قال: لن يضروا الله ضررا قليلا ولا كثيرا. ويجوز انتصابه على تقدير حذف الباء؛ كأنه قال: لن يضروا الله بشيء.
الآية: 178 {ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين}
قوله تعالى: "ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم" الإملاء طول العمر
ورغد العيش. والمعنى: لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين؛ فإن الله قادر على إهلاكهم، وإنما يطول أعمارهم ليعملوا بالمعاصي، لا لأنه خير لهم. ويقال: "أنما نملي لهم" بما أصابوا من الظفر يوم أحد لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم؛ وإنما كان ذلك ليزدادوا عقوبة. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له؛ لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالى: "وما عند الله خير للأبرار" [آل عمران: 198] وإن كان فاجرا فقد قال الله: وقرأ ابن عامر وعاصم "لا يحسبن" بالياء ونصب السين. وقرأ حمزة: بالتاء ونصب السين. والباقون: بالياء وكسر السين. فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي فلا يحسبن الكفار. و"أنما نملي لهم خير لأنفسهم" تسد مسد المفعولين. و"ما" بمعنى الذي، والعائد محذوف، و"خير" خبر "أن". ويجوز أن تقدر "ما" والفعل مصدرا؛ والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم. ومن قرأ بالتاء فالفعل هو المخاطب، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. و"الذين" نصب على المفعول الأول لتحسب. وأن وما بعدها بدل من الذين، وهي تسد مسد المفعولين، كما تسد لو لم تكن بدلا. ولا يصلح أن تكون "أن" وما بعدها مفعولا ثانيا لتحسب؛ لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول في المعنى؛ لأن حسب وأخواتها داخلة على المبتدأ والخبر؛ فيكون التقدير؛ ولا تحسبن أنما نملي لهم خير. هذا قول الزجاج. وقال أبو علّي: لو صح هذا لقال "خيرا" بالنصب؛ لأن "أن" تصير بدلا من "الذين كفروا"؛ فكأنه قال: لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيرا؛ فقوله "خيرا" هو المفعول الثاني لحسب. فإذا لا يجوز أن يقرأ "لا تحسبن" بالتاء إلا أن تكسر "إن في "أنما" وتنصب خيرا، ولم يرو ذلك عن حمزة، والقراءة عن حمزة بالتاء؛ فلا تصح هذه القراءة إذا. وقال الفراء والكسائي: قراءة حمزة جائزة على التكرير؛ تقديره ولا تحسبن الذي كفروا، ولا تحسبن أنما نملي لهم خيرا، فسدت "أن" مسد المفعولين لتحسب الثاني، وهي وما عملت مفعول ثان لتحسب الأول. قال القشيري: وهذا قريب مما ذكره الزجاج في دعوى البدل، والقراءة صحيحة. فإذا غرض أبي علّي تغليط الزجاج. قال النحاس: وزعم أبو حاتم أن قراءة حمزة بالتاء هنا، وقوله: "ولا يحسبن الذين يبخلون" [آل عمران: 180] لحن لا يجوز. وتبعه على ذلك جماعة.
قلت: وهذا ليس بشيء؛ لما تقدم بيانه من الإعراب، ولصحة القراءة وثبوتها نقلا. وقرأ يحيى بن وثاب "إنما نملي لهم" بكسر إن فيهما جميعا. قال أبو جعفر: وقراءة يحيي حسنة. كما تقول: حسبت عمرا أبوه خالد. قال أبو حاتم وسمعت الأخفش يذكر كسر "إن" يحتج به لأهل القدر؛ لأنه كان منهم. ويجعل على التقديم والتأخير "ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم". قال: ورأيت في مصحف في المسجد الجامع قد زادوا فيه حرفا فصار "إنما نملي لهم إيمانا" فنظر إليه يعقوب القارئ فتبين اللحن فحكه. والآية نص في بطلان مذهب القدرية؛ لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي، وتوالي أمثاله على القلب. كما تقدم بيانه في ضده وهو الإيمان. وعن ابن عباس قال: ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له ثم تلا "إنما نملي لهم ليزدادوا لهم إثما" وتلا "وما عند الله خير للأبرار" أخرجه رزين.
الآية: 179 {ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم}
قال أبو العالية: سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق؛ فأنزل الله عز وجل الآية. واختلفوا من المخاطب بالآية على أقوال. فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبّي وأكثر المفسرين: الخطاب للكفار والمنافقين. أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبّي صلى الله عليه وسلم. قال الكلبّي: إن قريشا من أهل مكة قالوا للنبّي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا تزعم أنه في النار، وأنه إذا ترك ديننا واتبع دينك قلت هو من أهل الجنة! فأخبرنا عن هذا من أين هو؟ وأخبرنا من يأتيك منا؟ ومن لم يأتك؟. فأنزل الله عز وجل "ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه" من الكفر والنفاق.
قوله تعالى: "حتى يميز الخبيث من الطيب" وقيل: هو خطاب للمشركين. والمراد بالمؤمنين في قوله: "ليذر المؤمنين" من في الأصلاب والأرحام ممن يؤمن. أي ما كان الله ليذر أولادكم الذين حكم لهم بالإيمان على ما أنتم عليه من الشرك، حتى يفرق بينكم وبينهم؛ وعلى هذا "وما كان الله ليطلعكم" كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين. وقيل: الخطاب للمؤمنين. أي وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق، حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف؛ فتعرفوا المنافق الخبيث، والمؤمن الطيب. وقد ميز يوم أحد بين الفريقين. وهذا قول أكثر أهل المعاني. "وما كان الله ليطلعكم على الغيب" يا معشر المؤمنين. أي ما كان الله ليعين لكم المنافقين حتى تعرفوهم، ولكن يظهر ذلك لكم بالتكليف والمحنة، وقد ظهر ذلك في يوم أحد؛ فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الشماتة، فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذا، فالآن قد أطلع الله محمدا عليه السلام وصحبه على ذلك. وقيل: معنى "ليطلعكم" أي وما كان الله ليعلمكم ما يكون منهم. فقوله: "وما كان الله ليطلعكم على الغيب" على هذا متصل، وعلى القولين الأولين منقطع. وذلك أن الكفار لما قالوا: لم لم يوح إلينا؟ قال: "وما كان الله ليطلعكم على الغيب" أي على من يستحق النبوة، حتى يكون الوحي باختياركم. "ولكن الله يجتبي" أي يختار. "من رسله" لإطلاع غيبه "من يشاء" يقال: طلعت على كذا واطلعت عليه، وأطلعت عليه غيري؛ فهو لازم ومتعد. وقرئ "حتى يميِّز" بالتشديد من ميز، وكذا في "الأنفال" وهي قراءة حمزة. والباقون "يميز" بالتخفيف من ماز يميز. يقال: مزت الشيء بعضه من بعض أميزه ميزا، وميزته تمييزا. قال أبو معاذ: مزت الشيء أميزه ميزا إذا فرقت بين شيئين. فإن كانت أشياء قلت: ميزتها تمييزا. ومثله إذا جعلت الواحد شيئين قلت: فرقت بينهما، مخففا؛ ومنه فرق الشعر. فإن جعلته أشياء قلت: فرقته تفريقا.
قلت: ومنه امتاز القوم، تميز بعضهم عن بعض. ويكاد يتميز: يتقطع؛ وبهذا فسر قوله تعالى: "تكاد تميز من الغيظ" [الملك: 8] وفي الخبر (من ماز أذى عن الطريق فهو له صدقة).
قوله تعالى: "فآمنوا بالله ورسله" يقال: إن الكفار لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من يؤمن منهم، فأنزل الله "فآمنوا بالله ورسله" يعني لا تشتغلوا بما لا يعنيكم، واشتغلوا بما يعنيكم وهو الإيمان. "فآمنوا" أي صدقوا، أي عليكم التصديق لا التشوف إلى اطلاع الغيب. "وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم" أي الجنة. ويذكر أن رجلا كان عند الحجاج بن يوسف الثقفي منجما؛ فأخذ الحجاج حصيات بيده قد عرف عددها فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب فأصاب المنجم. فأغفله الحجاج وأخذ حصيات لم يعدهن فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب فأخطأ، ثم حسب أيضا فأخطأ؛ فقال: أيها الأمير، أظنك لا تعرف عدد ما في يدك؟ قال لا: قال: فما الفرق بينهما؟ فقال: إن ذاك أحصيته فخرج عن حد الغيب، فحسبت فأصبت، وإن هذا لم تعرف عددها فصار غيبا، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى. وسيأتي هذا الباب في "الأنعام" إن شاء الله تعالى.
الآية: 180 {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير}
قوله تعالى: "ولا يحسبن الذين" "الذين" في موضع رفع، والمفعول الأول محذوف. قال الخليل وسيبويه والفراء المعنى البخل خيرا لهم، أي لا يحسبن الباخلون البخل خيرا لهم. وإنما حذف لدلالة يبخلون على البخل؛ وهو كقوله: من صدق كان خيرا له. أي كان له الصدق خيرا له. ومن هذا قول الشاعر:
إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف
فالمعنى: جرى: إلى السفه؛ فالسفيه دل على السفه. وأما قراءة حمزة بالتاء فبعيدة جدا؛ قاله النحاس. وجوازها أن يكون التقدير: لا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيرا لهم. قال الزجاج: وهي مثل "واسأل القرية". و"هو" في قوله "هو خيرا لهم" فاصلة عند البصريين. وهي العماد عند الكوفيين. قال النحاس: ويجوز في العربية "هو خير لهم" ابتداء وخبر.
قوله تعالى: "بل هو شر لهم" ابتداء وخبر، أي البخل شر لهم. والسين في "سيطوقون" سين الوعيد، أي سوف يطوقون؛ قاله المبرد. وهذه الآية نزلت في البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله، وأداء الزكاة المفروضة. وهذه كقوله: "ولا ينفقونها في سبيل الله" [التوبة: 34] الآية. ذهب إلى هذا جماعة من المتأولين، منهم ابن مسعود وابن عباس وأبو وائل وأبو مالك والسدي والشعبي قالوا: ومعنى "سيطوقون ما بخلوا به" هو الذي ورد في الحديث عن أبي هريرة عن النبّي صلى الله عليه وسلم قال: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك - ثم تلا هذه الآية - "ولا يحسبن الذين يبخلون" الآية). أخرجه النسائي. وخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع حتى يطوق به في عنقه) ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله" الآية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل ما عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمظ حتى يطوقه). وقال ابن عباس أيضا: إنما نزلت في أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما علموه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ذلك مجاهد وجماعة من أهل العلم. ومعنى "سيطوقون" على هذا التأويل سيحملون عقاب ما بخلوا به؛ فهو من الطاقة كما قال تعالى: "وعلى الذين يطيقونه" [البقرة: 184] وليس من التطويق. وقال إبراهيم النخعي: معنى "سيطوقون" سيجعل لهم يوم القيامة طوق من النار. وهذا يجري مع التأويل الأول أي قول السدي. وقيل: يلزمون أعمالهم كما يلزم الطوق العنق؛ يقال: طوق فلان عمله طوق الحمامة، أي ألزم عمله. وقد قال تعالى: "وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه" [الإسراء: 13]. ومن هذا المعنى قول عبدالله بن جحش لأبي سفيان:
أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامه
دار ابن عمك بعتها تقتضي بها عنك الغرامه
وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة
اذهب بها أذهب بها طوقتها طوق الحمامة
وهذا يجري مع التأويل الثاني. والبخل والبخل في اللغة أن يمنع الإنسال الحق الواجب عليه. فأما من منع مالا يجب عليه فليس ببخيل؛ لأنه لا يذم بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يبخلون وقد بخلوا. وسائر العرب يقولون: بخلوا يبخلون؛ حكاه النحاس. وبخل يبخل بخلا وبخلا؛ عن ابن فارس.
في ثمرة البخل وفائدته. وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: (من سيدكم؟) قالوا الجد بن قيس على بخل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: (وأي داء أدوى من البخل) قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: (إن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم فقالوا: ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء؛ وتعتذر النساء ببعد الرجال؛ ففعلوا وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء) ذكره الماوردي في كتاب "أدب الدنيا والدين". والله أعلم.
واختلف في البخل والشح؛ هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين. فقيل: البخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك. والشح: الحرص على تحصيل ما ليس عندك. وقيل: إن الشح هو البخل مع حرص. وهو الصحيح لما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم). وهذا يرد قول من قال: إن البخل منع الواجب، والشح منع المستحب. إذ لو كان الشح منع المستحب لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم، والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا والآخرة. ويؤيد هذا المعنى ما رواه النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبدأ ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبدا). وهذا يدل على أن الشح أشد في الذم من البخل؛ إلا أنه قد جاء ما يدل على مساواتهما وهو قوله - وقد سئل؛ أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: (لا) وذكر الماوردي في كتاب "أدب الدنيا والدين" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: (من سيدكم) قالوا: الجد بن قيس عل بخل فيه؛ الحديث. وقد تقدم.
قوله تعالى: "ولله ميراث السماوات والأرض" أخبر تعالى ببقائه ودوام ملكه. وأنه في الأبد كهو في الأزل غني عن العالمين، فيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم؛ فتبقى الأملاك والأموال لا مدعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة الخلق، وليس هذا بميراث في الحقيقة؛ لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئا لم يكن ملكه من قبل، والله سبحانه وتعالى مالك السموات والأرض وما بينهما، وكانت السموات وما فيها، والأرض وما فيها له، وإن الأموال كانت عارية عند أربابها؛ فإذا ماتوا ردت العارية إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل. ونظير هذه الآية قوله تعالى: "إنا نحن نرث الأرض ومن عليها" [مريم: 40] الآية. والمعنى في الآيتين أن الله تعالى أمر عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل أن يموتوا ويتركوا ذلك ميراثا لله تعالى، ولا ينفعهم إلا ما أنفقوا.










الصفحة رقم 73 من المصحف تحميل و استماع mp3