سورة النساء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
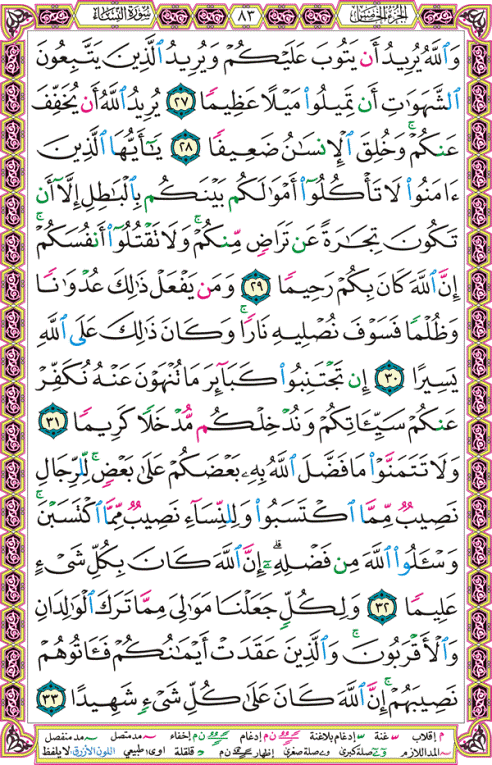
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 83 من المصحف
الآيتان: 27 - 28 {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف}
قوله تعالى: "والله يريد أن يتوب عليكم" ابتداء وخبر. و"أن" في موضع نصب بـ "يريد" وكذلك "يريد الله أن يخفف عنكم"؛ فـ "أن يخفف" في موضع نصب بـ "يريد" والمعنى: يريد توبتكم، أي يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم ويريد التخفيف عنكم. قيل: هذا في جميع أحكام الشرع، وهو الصحيح. وقيل: المراد بالتخفيف نكاح الأمة، أي لما علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء؛ قال مجاهد وابن زيد وطاوس. قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. واختلف في تعيين المتبعين للشهوات؛ فقال مجاهد: هم الزناة. السدي: هم اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموم، وهو الأصح. والميل: العدول عن طريق الاستواء؛ فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة.
قوله تعالى: "وخلق الإنسان ضعيفا" نصب على الحال؛ والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه، وهذا أشد الضعف فأحتاج إلى التخفيف. وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة. وروي عن ابن عباس أنه قرأ "وخلق الإنسان ضعيفا" أي وخلق الله الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر عن النساء. قال ابن املسيب: لقد أتى علي ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى وصاحبي أعمى أصم - يعني ذكره - وإني أخاف من فتنة النساء. ونحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال عبادة: ألا تروني لا أقوم إلا رفدا ولا آكل إلا ما لوق لي - قال يحيى: يعني لين وسخن - وقد مات صاحبي منذ زمان - قال يحيى: يعني ذكره - وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي، وأن لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيحركه علي، إنه لا سمع له ولا بصره.
الآية: 29 {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم}
قوله تعالى: "بالباطل" أي بغير حق. ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه؛ وقد قدمنا معناه في البقرة. ومن أكل المال بالباطل بيع العربان؛ وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه، على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة؛ وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك. فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة، وأكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بإجماع. وبيع العربان مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده، وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وقد روي عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبدالحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا. وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر: هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، وإنما ذكره عبدالرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم مرسلا؛ وهذا ومثله ليس حجة. ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه؛ وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من الثمن إذا اختار تمام البيع. وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره؛ وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع العربان). قال أبو عمر: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل نيه: أنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه. حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره، وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه يقال: إنه احترقت كتبه فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم من يضعف حديثه كله.، وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث، إلا أن حال عندهم كما وصفنا.
قوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" هذا استثناء منقطع، أي ولكن تجارة عن تراض. والتجارة هي البيع والشراء؛ وهذا مثل قوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة: 275] على ما تقدم. وقرئ "تجارة"، بالرفع أي إلا أن تقع تجارة؛ وعليه أنشد سيبويه:
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهب
وتسمى هذه كان التامة؛ لأنها تمت بفاعلها ولم تحتج إلى مفعول. وقرئ "تجارة" بالنصب؛ فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر، فاسمها مضمر فيها، وإن شئت قدرته، أي إلا أن تكون الأموال أموال تجارة؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقد تقدم هذا؛ ومنه قوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة" [البقرة: 280].
قوله تعالى: "تجارة" التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة؛ ومنه الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبد عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فعله؛ قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم" [الصف: 10]. وقال تعالى: "يرجون تجارة لن تبور" [فاطر: 29]. وقال تعالى: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم" [التوبة: 111] الآية. فسمى ذلك كله بيعا وشراء على وجه المجاز، تشبيها بعقود الأشرية والبياعات التي تحصل بها الأغراض، وهي نوعان: تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار، وزهد فيه ذوو الأخطار. والثاني تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا أليق بأهل المروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله). يعني على خطر. وقيل: في التوراة يا ابن آدم، أحدث سفرا أحدث لك رزقا. الطبري: وهذه الآية أدل دليل على فساد قول.
اعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض إلا أن قوله "بالباطل" أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضا كل عقد جائز لا عوض فيه؛ كالقرض والصدقة والهبة لا للثواب. وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها. فهذان طرفان متفق عليهما. وخرج منها أيضا دعاء أخيك إياك إلى طعامه. روى أبو داود عن ابن عباس في قوله تعالى: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية؛ فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في "النور"؛ فقال: "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم" [النور: 61] إلى قوله "أشتاتا"؛ فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول: إني لأجنح أن آكل منه - والتجنح الحرج ويقول: المسكين أحق به مني. فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب.
لو اشتريت من السوق شيئا؛ فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذقه وأنت في حل؛ فلا تأكل منه؛ لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء؛ فربما لا يقع بينكما شراء فيكون ذلك شبهة، ولكن لو وصف لك صفة فاشتريته فلم تجده على تلك الصفة فأنت بالخيار.
والجمهور على جواز الغبن في التجارة؛ مثل أن يبيع رجل ياقوتة به بدرهم وهي تساوي مائة فذلك جائز، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير، وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، كما تجوز الهبة لو وهب. واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك؛ فقال قوم: عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائز إذا كان رشيدا حرا بالغا. وقالت فرقة: الغبن إذا تجاوز الثلث مردود، وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في التجارات، وأما المتفاحش الفادح فلا؛ وقال ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله. والأول أصح؛ لقوله عليه السلام في حديث الأمة الزانية. (فليبعها ولو بضفير) وقوله عليه السلام لعمر: (لا تبتعه يعني القرس - ولو أعطاكه بدرهم واحد) وقوله عليه السلام: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وقوله عليه السلام: (لا يبغ حاضر لباد) وليس فيها تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره.
قوله تعالى: "عن تراض منكم" أي عن رضى، إلا أنها جاءت من المفاعلة إذ التجارة من اثنين. واختلف العلماء في التراضي؛ فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر؛ فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا وإن لم يتفرقا؛ قاله جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغيرهم. قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرقا؛ إلا بيوعا ثلاثة: بيع السلطان المغانم، والشركة في الميراث، والشركة في التجارة؛ فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار. وقال: وحد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه؛ وهو قول أهل الشام. وقال الليث: التفرق أن يقوم أحدهما. وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبدا ما لم يتفرقا بأبدانهما، وسواء قالا: اخترنا أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما؛ وقال الشافعي أيضا. وهو الصحيح في هذا الباب للأحاديث الواردة في ذلك. وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار. قال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) أن البائع إذا قال: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت. وهو قول أبي حنيفة، ونص مذهب مالك أيضا، حكاه ابن خويز منداد. وقيل: ليس له أن يرجع. وقد مضى في "البقرة". واحتج الأولون بما ثبت من حديث سمرة بن جندب وأبي برزة وابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وحكيم بن حزام وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه أختر). رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ فقوله عليه السلام في هذه الرواية: (أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) هو معنى الرواية الأخرى (إلا بيع الخيار) وقوله: (إلا أن يكون بيعهما عن خيار) ونحوه. أي يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه؛ فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهم وإن لم يتفرقا. وكان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلا ثم رجع. وفي الأصول: إن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، لا سيما الصحابة إذ هم أعلم بالمنال وأقعد بالحال. وروى أبو داود والدارقطني عن أبي الوضيء قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام ؟ قال: نعم؛ فباعه ثم بات معنا، فلما أصبح قام إلى فرسه، فقال له صاحبنا: مالك والفرس ! أليس قد بعتنيها ؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة. فقال: مالك ذلك، لقد بعتني. فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه؛ فقال لهما: أترضيان بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) وإني لا أراكما افترقتما. فهذان صحابيان قد علما مخرج الحديث وعملا بمقتضاه، بل هذا كان عمل الصحابة. قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر؛ قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقرى، خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. أخرجه الدارقطني ثم قال: إن أهل اللغة فرقوا بين فرقت مخففا وفرقت مثقلا؛ فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتثقيل في الأبدان. قال أحمد بن يحيى ثعلب: أخبرني ابن الأعرابي عن المفضل قال: يقال فرقت بين الكلامين مخففا فافترقا وفرقت بين اثنين مشددا فتفرقا؛ فجعل الافتراق في القول، والتفرق في الأبدان. احتجت المالكية بما تقدم بيانه في آية الدين، وبقوله تعالى: "أوفوا بالعقود" [المائدة: 1] وهذان قد تعاقدا. وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود. قالوا: وقد يكون التفرق بالقول كعقد النكاح ووقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقا؛ قال الله تعالى: "وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته" [النساء: 130] وقال تعالى: "ولا تكونوا كالذين تفرقوا" [آل عمران: 105] وقال عليه السلام: (تفترق أمتي) ولم يقل بأبدانها.
وقد روى الدارقطني وغيره عن عمرو بن شعيب قال: سمعت شعيبا يقول: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله). قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع. قالوا: ومعنى قوله (المتبايعان بالخيار) أي المتساومان بالخيار ما لم يعقدا فإذا عقدا بطل الخيار فيه. والجواب: أما ما اعتلوا به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديان كما بيناه في "آل عمران"، وإن كان صحيحا في بعض المواضع فهو في هذا الموضع غير صحيح. وبيانه أن يقال: خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع، أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره ؟ فإن قالوا: هو غيره فقد أحالوا وجاؤوا بما لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غير ذلك. وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعهما، به افترقا، هذا عين المحال والفاسد من القول. وأما قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله) فمعناه - إن صح - على الندب؛ بدليل قوله عليه السلام. (من أقال مسلما أقاله الله عثرته) وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث، ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء. وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى (لا يحل) فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب، وإلا فهو باطل بالإجماع. وأما تأويل "المتبايعان" بالمتساومين فعدول عن ظاهر اللفظ، وإنما معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما داما في مجلسهما، إلا بيعا يقول أحدهما لصاحبه فيه: اختر فيختار؛ فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا؛ فإن فرض خيار فالمعنى: إلا بيع الخيار فإنه يبقى الخيار بعد التفرد بالأبدان. وتتميم هذا الباب في كتب الخلاف. وفي قول عمرو بن شعيب "سمعت أبي يقول "دليل على صحة حديثه؛ فسن الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن علي الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: شعيب سمع من أبيه شيئا ؟ قال: يقول حدثني أبي. قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم، أراه قد سمع منه. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو.
روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبي والصديقين والشهداء يوم القيامة). ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينها، أو يصلي على الني صلى الله عليه وسلم في عرض سلعته؛ وهو أن يقول: صلى الله على محمد ! ما أجود هذا. ويستحب للتاجر ألا تشغله تجارته عن أداء الفرائض؛ فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى يكون من أهل هذه الآية: "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" [النور: 37] وسيأتي.
وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلب الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوفة الجهلة؛ لأن الله تعالى حرم أكلها بالباطل وأحلها بالتجارة، وهذا بين.
قوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم" فيه مسألة واحدة - قرأ الحسن "تُقَتِّلوا" على التكثير. وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن يقال: "ولا تقتلوا أنفسكم" في حال ضجر أو غضب؛ فهذا كله يتناول النهي. وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه؛ فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئا. خرجه أبو داود وغيره، وسيأتي.
الآية: 30 {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير}
قوله: "ذلك" إشارة إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. وقيل: هو عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي عنهما جاء متسقا مسرودا، ثم ورد الوعيد حسب النهي. وقيل: هو عام على كل ما نهى عنه من القضايا، من أول السورة إلى قوله تعالى: "ومن يفعل ذلك". وقال الطبري: "ذلك" عائد على ما نهى عنه من آخر وعيد، وذلك قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها" [النساء: 19] لأن كل ما نهى عنه من أول السورة قرن به وعيد، إلا من قوله: "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم" فإنه لا وعيد بعده إلا قوله: "ومن يفعل ذلك عدوانا" [النساء 10]. والعدوان تجاوز الحد. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدم. وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط، وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما لاختلاف ألفاظهما، وحسن ذلك في الكلام كما قال:
وألفى قولها كذبا ومينا
وحسن العطف لاختلاف اللفظين؛ يقال: بعدا وسحقا؛ ومنه قول يعقوب: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله" [يوسف: 86]. فحسن ذلك لاختلاف اللفظ. و"نصليه" معناه نمسه حرها. وقد بينا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي سعيد الخدري في العصاة وأهل الكبائر لمن أنفذ عليه الوعيد؛ فلا معنى لإعادة ذلك. وقرأ الأعمش والنخعي "نصليه" بفتح النون، على أنه منقول من صلي نارا، أي أصليته؛ وفي الخبر "شاة مصلية". ومن ضم النون منقول بالهمزة، مثل طعمت وأطعمت.
الآية: 31 {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم}
لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر، وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر، ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر. وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء، وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق، لا أنه يجب عليه ذلك. ونظير الكلام في هذا ما تقدم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: "إنما التوبة على الله" [النساء: 17]، فالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وروى أبو حاتم البستي إلى صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال: (والذي نفسي بيده) ثلاث مرات، ثم سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق) ثم تلا "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم". فقد تعاضد الكتاب وصحيح السنة بتكفير الصغائر قطعا كالنظر وشبهه. وبينت السنة أن المراد بـ "تجتنبوا" ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وإنما محمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء والمشيئة ثابتة. ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بألا تباعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة. ولا صغيرة عندنا. قال القشيري عبدالرحيم: والصحيح أنها كبائر ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض، والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي.
قلت: وأيضا فإن من نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم: - لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر، وعلى هذا النحو يخرج كلام القاضي أبي بكر بن الطيب والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وأبي المعالي وأبي نصر عبدالرحيم القشيري وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنى، ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر، بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، لقوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" [النساء: 48] واحتجوا بقراءة من قرأ "إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه" على التوحيد؛ وكبير الإثم الشرك. قالوا: وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر. والآية التي قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". واحتجوا بما رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة) فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال: (وإن كان قضيبا من أراك). فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية؛ وتصديقه قوله تعالى: "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه". وقال طاوس: قيل لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: اليأس من روج الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، والشرك بالله؛ دل عليها القرآن. وروي عن ابن عمر: هي تسع: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، والسحر، والإلحاد في البيت الحرام. ومن الكبائر عند العلماء: القمار والسرقة وشرب الخمر وسب السلف الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله وسب الإنسان أبويه - بأن يسب رجلا فيسب ذلك الرجل أبويه - والسعي في الأرض فسادا - ؛ إلى غير ذلك مما يكثر تعداده حسب ما جاء بيانها في القرآن، وفي أحاديث خرجها الأئمة، وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها جملة وافرة. وقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها؛ والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها الحصر، ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره، فالشرك أكبر ذلك كله، وهو الذي لا يغفر لنص الله تعالى على ذلك، وبعده اليأس من رحمة الله؛ لأن فيه تكذيب القرآن؛ إذ يقول وقوله الحق: "ورحمتي وسعت كل شيء" [الأعراف: 156] وهو يقول: لا يغفر له؛ فقد حجر واسعا. هذا إذا كان معتقدا لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: "إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون" [يوسف: 87]. وبعده القنوط؛ قال الله تعالى: "ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون" [الحجر: 56]. وبعده الأمن من مكر الله فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من غير عمل؛ قال الله تعالى: "أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون" [الأعراف: 99]. وقال تعالى: "وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين" [فصلت: 23]. وبعده القتل؛ لأن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود، واللواط فيه قطع النسل، والزنى فيه اختلاط الأنساب بالمياه، والخمر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلام، وشهادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج والأموال، إلى غير ذلك مما هو بين الضرر؛ فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده، أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة. فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه، والله أعلم.
قوله تعالى: "وندخلكم مدخلا كريما" قرأ أبو عمرو وأكثر الكوفيين "مدخلا" بضم الميم، فيحتمل أن يكون مصدرا، أي إدخالا، والمفعول محذوف أي وندخلكم الجنة إدخالا. ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولا. وقرأ أهل المدينة بفتح الميم، فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فعل؛ التقدير وندخلكم فتدخلون مدخلا، ودل الكلام عليه. ويجوز أن يكون اسم مكان فينتصب على أنه مفعول به، أي وندخلكم مكانا كريما وهو الجنة. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: سمعت أبا داود السجستاني يقول: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: المسلمون كلهم في الجنة؛ فقلت له: وكيف ؟ قال: يقول الله عز وجل: "إن تجتبوا كبائر ما تنهون، عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما" يعني الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). فإذا كان الله عز وجل يغفر ما دون الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الكبائر فأي ذنب يبقى على المسلمين. وقال علماؤنا: الكبائر عند أهل السنة تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت حسب ما تقدم. وقد يغفر لمن مات عليها من المسلمين كما قال تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" [النساء: 48] والمراد بذلك من مات على الذنوب؛ فلو كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنى؛ إذ التائب من الشرك أيضا مغفور له. وروي عن ابن مسعود أنه قال: خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا جميعا، قوله تعالى: "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه" وقوله "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر" [النساء: 48] الآية، وقوله تعالى: "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه" [النساء:110]الآية، وقوله تعالى: "وإن تك حسنة يضاعفها" [النساء: 40]، وقوله تعالى: "والذين آمنوا بالله ورسله" [النساء: 152]. وقال ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء، هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: "يريد الله ليبين لكم" [النساء: 26]، "والله يريد أن يتوب عليكم" [النساء: 27]، "يريد الله أن يخفف عنكم" [النساء: 28]، "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم" [النساء: 31]، الآية، "إن الله لا يغفر أن يشرك به"، "إن الله لا يظلم مثقال ذرة" [النساء: 40]، "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه"، "ما يفعل الله بعذابكم" [النساء: 147]الآية.
الآية: 32 {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم}
روى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث؛ فأنزل الله تعالى: "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض". قال مجاهد: وأنزل فيها "إن المسلمين والمسلمات" [الأحزاب: 35]، وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، ورواه بضعهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، مرسل أن أم سلمة قالت كذا. وقال قتادة: كان الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان؛ فلما ورثوا وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين تمنى النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث؛ فنزلت، "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض".
قوله تعالى: "ولا تتمنوا" التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل، كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني؛ لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل. وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الغبطة، وهي أن يتمنى الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمن زوال حاله. والجمهور على إجازة ذلك: مالك وغيره؛ وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه السلام (لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار). فمعنى قوله: "لا حسد" أي لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين. وقد نبه البخاري على هذا المعنى حيث بوب على هذا الحديث (باب الاغتباط في العلم والحكمة) قال المهلب: بين الله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز تمنيه، وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباهها. قال ابن عطية: وأما التمني في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن، وأما إذا تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمنا ذكره فذلك جائز؛ وذلك موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول: (وددت أن أحيا ثم أقتل).
قلت: هذا الحديث هو الذي صدر به البخاري كتاب التمني في صحيحه، وهو يدل على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيها، وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر؛ لأنه عليه السلام تمناها دون غيرها، وذلك لرفيع منزلتها وكرامة أهلها، فرزقه الله إياها؛ لقوله: (ما زالت أكلة خيبر تعادني الآن أوان قطعت أبهري). وفي الصحيح: (إن الشهيد يقال له تمن فيقول أتمنى أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى إيمان أبي طالب وإيمان أبي لهب وصناديد قريش مع علمه بأنه لا يكون؛ وكان يقول: (واشوقاه إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني). وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض، والتمني المنهي عنه في الآية من هذا القبيل؛ فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر، وسواء تمنيت مع ذلك أن يعود إليك أو لا. وهذا هو الحسد بعينه، وهو الذي ذمه الله تعالى بقوله: "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله" [النساء: ] ويدخل فيه أيضا خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه؛ لأنه داعية الحمد والمقت. وقد كره بعض العلماء الغبطة وأنها داخلة في النهي، والصحيح جوازها على ما بينا، وبالله توفيقنا. وقال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد، ألم تسمع الذين قالوا: "يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون" [القصص: ] إلى أن قال: "وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس" [القصص: ] حين خسف به وبداره وبأمواله "لولا أن من الله علينا لخسف بنا" [القصص: ] وقال الكلبي: لا يتمن الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته؛ ولكن ليقل: اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك في التوراة، وكذلك قوله في القرآن "واسألوا الله من فضله". وقال ابن عباس: نهى الله سبحانه أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله، وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله. ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء) الحديث... وقد تقدم. خرجه الترمذي وصححه. وقال الحسن: لا يتمن أحدكم المال وما يدريه لعل هلاكه فيه؛ وهذا إنما يصح إذا تمناه للدنيا، وأما إذا تمناه للخير فقد جوزه الشرع، فيتمناه العبد ليصل به إلى الرب، ويفعل الله ما يشاء.
قوله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا" يريد من الثواب والعقاب "وللنساء" كذلك؛ قال قتادة. فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث. والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فنهى الله عز وجل عن التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم؛ فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم.
قوله تعالى: "واسألوا الله من فضله" روى الترمذي عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج) وخرج أيضا ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يسأل الله يغضب عليه). وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب؛ وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال:
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب
وقال أحمد بن المعذل أبو الفضل الفقيه المالكي فأحسن:
التمس الأرزاق عند الذي ما دونه إن سيل من حاجب
من يبغض التارك تسأله جودا ومن يرضى عن الطالب
ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتب
وقد أشبعنا القول في هذا المعنى في كتاب "قمع الحرص بالزهد والقناعة". وقال سعيد بن جبير: "واسألوا الله من فضله" العبادة، ليس من أمر الدنيا. وقيل: سلوه التوفيق للعمل بما يرضيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سلوا ربكم حتى الشبع؛ فإنه إن لم ييسره الله عز وجل لم يتيسر. وقال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي.
وقرأ الكسائي وابن كثير: "وسلوا الله من فضله" بغير همز في جميع القرآن. الباقون بالهمز. "واسألوا الله". وأصله بالهمز إلا أنه حذفت الهمزة للتخفيف. والله أعلم.
الآية: 33 {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد}
بين تعالى أن لكل إنسان ورثة وموالي؛ فلينتفع كل واحد بما قسم الله له من الميراث، ولا يتمن مال غير. وروى البخاري في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: "ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم" قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت "ولكل جعلنا موالي" قال: نسختها "والذين عاقدت أيمانكم". قال أبو الحسن بن بطال: وقع في جميع النسخ "ولكل جعلنا موالي" قال: نسختها "والذين عاقدت أيمانكم". والصواب أن الآية الناسخة "ولكل جعلنا موالي" والمنسوخة "والذين عاقدت أيمانكم"، وكذا رواه الطبري في روايته. وروي، عن جمهور السلف أن الآية الناسخة لقوله: "والذين عاقدت أيمانكم" قوله تعالى في "الأنفال ": "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض" [الأنفال: 75]. روي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري؛ وهو الذي أثبته أبو عبيد في كتاب "الناسخ والمنسوخ" له. وفيها قول آخر رواه الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أمر الله عز وجل الذين تبنوا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى ذوي الرحم والعصبة. وقالت طائفة: قوله تعالى: "والذين عاقدت أيمانكم" محكم وليس بمنسوخ؛ وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛ ذكره الطبري عن ابن عباس. "والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم" من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي لهم وقد ذهب الميراث؛ وهو قول مجاهد والسدي.
قلت: واختاره النحاس؛ ورواه عن سعيد بن جبير، ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس فيما ذكره الطبري، ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير. وسيأتي ميراث "ذوي الأرحام" في "الأنفال" إن شاء الله تعالى.
قوله: "كل" في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم. فإذا جاءت مفردة فلا بد أن يكون في الكلام حذف عند جميع النحويين؛ حتى أن بعضهم أجاز مررت بكل، مثل قبل وبعد. وتقدير الحذف: ولكل أحد جعلنا موالي، يعني ورثة. "والذين عاقدت أيمانكم" يعني بالحلف؛ عن قتادة. وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك؛ فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف ثم نسخ.
قوله تعالى: "موالي" أعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه؛ فيسمى المعتق مولى والمعتق مولى. ويقال: المولى الأسفل والأعلى أيضا. ويسمى الناصر المولى؛ ومنه قوله تعالى: "وأن الكافرين لا مولى لهم" [محمد: 11]. ويسمى ابن العم مولى والجار مولى. فأما قوله تعالى: "ولكل جعلنا موالي" يريد عصبة؛ لقوله عليه السلام: (ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر). ومن العصبات المولى الأعلى لا الأسفل، على قول أكثر العلماء؛ لأن المفهوم في حق المعتق أنه المنعم على المعتق، كالموجد له؛ فاستحق ميراثه لهذا المعنى. وحكى الطحاوي عن الحسن بن زياد أن المولى الأسفل يرث من الأعلى؛ واحتج فيه بما روي أن رجلا أعتق عبدا له لهذا الحديث ولم يترك إلا المعتق فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام المعتق. قال الطحاوي: ولا معارض لهذا الحديث، فوجب القول به؛ ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للمعتق على تقدير أنه كان كالموجد له، فهو شبيه بالأب؛ والمولى الأسفل شبيه بالابن؛ وذلك يقتضي التسوية بينهما في الميراث، والأصل أن الاتصال يعم. وفي الخبر (مولى القوم منهم). والذين خالفوا هذا وهم الجمهور قالوا: الميراث. يستدعي القرابة ولا قرابة، غير أنا أثبتنا للمعتق الميراث بحكم الإنعام على المعتق؛ فيقتضي مقابلة الإنعام بالمجازاة، وذلك لا ينعكس في المولى الأسفل. وأما الابن فهو أولى الناس بأن يكون خليفة أبيه وقائما مقامه، وليس المعتق صالحا لأن يقوم مقام معتقه، وإنما المعتق قد أنعم عليه فقابله الشرع بأن جعله أحق بمولاه المعتق، ولا يوجد هذا في المولى الأسفل؛ فظهر الفرق بينهما والله أعلم.
قوله تعالى: "والذين عقدت أيمانكم" روى علي بن كبشة عن حمزة "عقَّدت" بتشديد القاف على التكثير. والمشهور عن حمزة "عقدت أيمانكم" مخففة القاف، وهي قراءة عاصم والكسائي، وهي قراءة بعيدة؛ لأن المعاقدة لا تكون إلا من اثنين فصاعدا، فبابها فاعل. قال أبو جعفر النحاس: وقراءة حمزة تجوز على غموض في العربية، يكون التقدير فيها والذين عقدتهم أيمانكم الحلف، وتعدى إلى مفعولين؛ وتقديره: عقدت لهم أيمانكم الحلف، ثم حذفت اللام مثل قوله تعالى: "وإذا كالوهم" [المطففين: 3] أي كالوا لهم. وحذف المفعول الثاني، كما يقال: كلتك أي كلت لك برا. وحذف المفعول الأول لأنه متصل في الصلة.
قوله تعالى: "فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا" أي قد شهد معاقدتكم إياهم، وهو عز وجل يحب الوفاء.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 83
83- تفسير الصفحة رقم83 من المصحفالآيتان: 27 - 28 {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف}
قوله تعالى: "والله يريد أن يتوب عليكم" ابتداء وخبر. و"أن" في موضع نصب بـ "يريد" وكذلك "يريد الله أن يخفف عنكم"؛ فـ "أن يخفف" في موضع نصب بـ "يريد" والمعنى: يريد توبتكم، أي يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم ويريد التخفيف عنكم. قيل: هذا في جميع أحكام الشرع، وهو الصحيح. وقيل: المراد بالتخفيف نكاح الأمة، أي لما علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء؛ قال مجاهد وابن زيد وطاوس. قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. واختلف في تعيين المتبعين للشهوات؛ فقال مجاهد: هم الزناة. السدي: هم اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموم، وهو الأصح. والميل: العدول عن طريق الاستواء؛ فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة.
قوله تعالى: "وخلق الإنسان ضعيفا" نصب على الحال؛ والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه، وهذا أشد الضعف فأحتاج إلى التخفيف. وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة. وروي عن ابن عباس أنه قرأ "وخلق الإنسان ضعيفا" أي وخلق الله الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر عن النساء. قال ابن املسيب: لقد أتى علي ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى وصاحبي أعمى أصم - يعني ذكره - وإني أخاف من فتنة النساء. ونحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال عبادة: ألا تروني لا أقوم إلا رفدا ولا آكل إلا ما لوق لي - قال يحيى: يعني لين وسخن - وقد مات صاحبي منذ زمان - قال يحيى: يعني ذكره - وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي، وأن لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيحركه علي، إنه لا سمع له ولا بصره.
الآية: 29 {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم}
قوله تعالى: "بالباطل" أي بغير حق. ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه؛ وقد قدمنا معناه في البقرة. ومن أكل المال بالباطل بيع العربان؛ وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه، على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة؛ وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك. فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة، وأكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بإجماع. وبيع العربان مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده، وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وقد روي عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبدالحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا. وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر: هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، وإنما ذكره عبدالرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم مرسلا؛ وهذا ومثله ليس حجة. ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه؛ وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من الثمن إذا اختار تمام البيع. وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره؛ وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع العربان). قال أبو عمر: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل نيه: أنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه. حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره، وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه يقال: إنه احترقت كتبه فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم من يضعف حديثه كله.، وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث، إلا أن حال عندهم كما وصفنا.
قوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" هذا استثناء منقطع، أي ولكن تجارة عن تراض. والتجارة هي البيع والشراء؛ وهذا مثل قوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة: 275] على ما تقدم. وقرئ "تجارة"، بالرفع أي إلا أن تقع تجارة؛ وعليه أنشد سيبويه:
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهب
وتسمى هذه كان التامة؛ لأنها تمت بفاعلها ولم تحتج إلى مفعول. وقرئ "تجارة" بالنصب؛ فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر، فاسمها مضمر فيها، وإن شئت قدرته، أي إلا أن تكون الأموال أموال تجارة؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقد تقدم هذا؛ ومنه قوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة" [البقرة: 280].
قوله تعالى: "تجارة" التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة؛ ومنه الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبد عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فعله؛ قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم" [الصف: 10]. وقال تعالى: "يرجون تجارة لن تبور" [فاطر: 29]. وقال تعالى: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم" [التوبة: 111] الآية. فسمى ذلك كله بيعا وشراء على وجه المجاز، تشبيها بعقود الأشرية والبياعات التي تحصل بها الأغراض، وهي نوعان: تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار، وزهد فيه ذوو الأخطار. والثاني تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا أليق بأهل المروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله). يعني على خطر. وقيل: في التوراة يا ابن آدم، أحدث سفرا أحدث لك رزقا. الطبري: وهذه الآية أدل دليل على فساد قول.
اعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض إلا أن قوله "بالباطل" أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضا كل عقد جائز لا عوض فيه؛ كالقرض والصدقة والهبة لا للثواب. وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها. فهذان طرفان متفق عليهما. وخرج منها أيضا دعاء أخيك إياك إلى طعامه. روى أبو داود عن ابن عباس في قوله تعالى: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية؛ فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في "النور"؛ فقال: "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم" [النور: 61] إلى قوله "أشتاتا"؛ فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول: إني لأجنح أن آكل منه - والتجنح الحرج ويقول: المسكين أحق به مني. فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب.
لو اشتريت من السوق شيئا؛ فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذقه وأنت في حل؛ فلا تأكل منه؛ لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء؛ فربما لا يقع بينكما شراء فيكون ذلك شبهة، ولكن لو وصف لك صفة فاشتريته فلم تجده على تلك الصفة فأنت بالخيار.
والجمهور على جواز الغبن في التجارة؛ مثل أن يبيع رجل ياقوتة به بدرهم وهي تساوي مائة فذلك جائز، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير، وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، كما تجوز الهبة لو وهب. واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك؛ فقال قوم: عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائز إذا كان رشيدا حرا بالغا. وقالت فرقة: الغبن إذا تجاوز الثلث مردود، وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في التجارات، وأما المتفاحش الفادح فلا؛ وقال ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله. والأول أصح؛ لقوله عليه السلام في حديث الأمة الزانية. (فليبعها ولو بضفير) وقوله عليه السلام لعمر: (لا تبتعه يعني القرس - ولو أعطاكه بدرهم واحد) وقوله عليه السلام: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وقوله عليه السلام: (لا يبغ حاضر لباد) وليس فيها تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره.
قوله تعالى: "عن تراض منكم" أي عن رضى، إلا أنها جاءت من المفاعلة إذ التجارة من اثنين. واختلف العلماء في التراضي؛ فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر؛ فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا وإن لم يتفرقا؛ قاله جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغيرهم. قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرقا؛ إلا بيوعا ثلاثة: بيع السلطان المغانم، والشركة في الميراث، والشركة في التجارة؛ فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار. وقال: وحد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه؛ وهو قول أهل الشام. وقال الليث: التفرق أن يقوم أحدهما. وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبدا ما لم يتفرقا بأبدانهما، وسواء قالا: اخترنا أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما؛ وقال الشافعي أيضا. وهو الصحيح في هذا الباب للأحاديث الواردة في ذلك. وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار. قال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) أن البائع إذا قال: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت. وهو قول أبي حنيفة، ونص مذهب مالك أيضا، حكاه ابن خويز منداد. وقيل: ليس له أن يرجع. وقد مضى في "البقرة". واحتج الأولون بما ثبت من حديث سمرة بن جندب وأبي برزة وابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وحكيم بن حزام وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه أختر). رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ فقوله عليه السلام في هذه الرواية: (أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) هو معنى الرواية الأخرى (إلا بيع الخيار) وقوله: (إلا أن يكون بيعهما عن خيار) ونحوه. أي يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه؛ فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهم وإن لم يتفرقا. وكان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلا ثم رجع. وفي الأصول: إن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، لا سيما الصحابة إذ هم أعلم بالمنال وأقعد بالحال. وروى أبو داود والدارقطني عن أبي الوضيء قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام ؟ قال: نعم؛ فباعه ثم بات معنا، فلما أصبح قام إلى فرسه، فقال له صاحبنا: مالك والفرس ! أليس قد بعتنيها ؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة. فقال: مالك ذلك، لقد بعتني. فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه؛ فقال لهما: أترضيان بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) وإني لا أراكما افترقتما. فهذان صحابيان قد علما مخرج الحديث وعملا بمقتضاه، بل هذا كان عمل الصحابة. قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر؛ قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقرى، خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. أخرجه الدارقطني ثم قال: إن أهل اللغة فرقوا بين فرقت مخففا وفرقت مثقلا؛ فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتثقيل في الأبدان. قال أحمد بن يحيى ثعلب: أخبرني ابن الأعرابي عن المفضل قال: يقال فرقت بين الكلامين مخففا فافترقا وفرقت بين اثنين مشددا فتفرقا؛ فجعل الافتراق في القول، والتفرق في الأبدان. احتجت المالكية بما تقدم بيانه في آية الدين، وبقوله تعالى: "أوفوا بالعقود" [المائدة: 1] وهذان قد تعاقدا. وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود. قالوا: وقد يكون التفرق بالقول كعقد النكاح ووقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقا؛ قال الله تعالى: "وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته" [النساء: 130] وقال تعالى: "ولا تكونوا كالذين تفرقوا" [آل عمران: 105] وقال عليه السلام: (تفترق أمتي) ولم يقل بأبدانها.
وقد روى الدارقطني وغيره عن عمرو بن شعيب قال: سمعت شعيبا يقول: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله). قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع. قالوا: ومعنى قوله (المتبايعان بالخيار) أي المتساومان بالخيار ما لم يعقدا فإذا عقدا بطل الخيار فيه. والجواب: أما ما اعتلوا به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديان كما بيناه في "آل عمران"، وإن كان صحيحا في بعض المواضع فهو في هذا الموضع غير صحيح. وبيانه أن يقال: خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع، أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره ؟ فإن قالوا: هو غيره فقد أحالوا وجاؤوا بما لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غير ذلك. وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعهما، به افترقا، هذا عين المحال والفاسد من القول. وأما قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله) فمعناه - إن صح - على الندب؛ بدليل قوله عليه السلام. (من أقال مسلما أقاله الله عثرته) وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث، ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء. وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى (لا يحل) فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب، وإلا فهو باطل بالإجماع. وأما تأويل "المتبايعان" بالمتساومين فعدول عن ظاهر اللفظ، وإنما معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما داما في مجلسهما، إلا بيعا يقول أحدهما لصاحبه فيه: اختر فيختار؛ فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا؛ فإن فرض خيار فالمعنى: إلا بيع الخيار فإنه يبقى الخيار بعد التفرد بالأبدان. وتتميم هذا الباب في كتب الخلاف. وفي قول عمرو بن شعيب "سمعت أبي يقول "دليل على صحة حديثه؛ فسن الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن علي الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: شعيب سمع من أبيه شيئا ؟ قال: يقول حدثني أبي. قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم، أراه قد سمع منه. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو.
روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبي والصديقين والشهداء يوم القيامة). ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينها، أو يصلي على الني صلى الله عليه وسلم في عرض سلعته؛ وهو أن يقول: صلى الله على محمد ! ما أجود هذا. ويستحب للتاجر ألا تشغله تجارته عن أداء الفرائض؛ فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى يكون من أهل هذه الآية: "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" [النور: 37] وسيأتي.
وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلب الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوفة الجهلة؛ لأن الله تعالى حرم أكلها بالباطل وأحلها بالتجارة، وهذا بين.
قوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم" فيه مسألة واحدة - قرأ الحسن "تُقَتِّلوا" على التكثير. وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن يقال: "ولا تقتلوا أنفسكم" في حال ضجر أو غضب؛ فهذا كله يتناول النهي. وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه؛ فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئا. خرجه أبو داود وغيره، وسيأتي.
الآية: 30 {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير}
قوله: "ذلك" إشارة إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. وقيل: هو عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي عنهما جاء متسقا مسرودا، ثم ورد الوعيد حسب النهي. وقيل: هو عام على كل ما نهى عنه من القضايا، من أول السورة إلى قوله تعالى: "ومن يفعل ذلك". وقال الطبري: "ذلك" عائد على ما نهى عنه من آخر وعيد، وذلك قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها" [النساء: 19] لأن كل ما نهى عنه من أول السورة قرن به وعيد، إلا من قوله: "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم" فإنه لا وعيد بعده إلا قوله: "ومن يفعل ذلك عدوانا" [النساء 10]. والعدوان تجاوز الحد. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدم. وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط، وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما لاختلاف ألفاظهما، وحسن ذلك في الكلام كما قال:
وألفى قولها كذبا ومينا
وحسن العطف لاختلاف اللفظين؛ يقال: بعدا وسحقا؛ ومنه قول يعقوب: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله" [يوسف: 86]. فحسن ذلك لاختلاف اللفظ. و"نصليه" معناه نمسه حرها. وقد بينا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي سعيد الخدري في العصاة وأهل الكبائر لمن أنفذ عليه الوعيد؛ فلا معنى لإعادة ذلك. وقرأ الأعمش والنخعي "نصليه" بفتح النون، على أنه منقول من صلي نارا، أي أصليته؛ وفي الخبر "شاة مصلية". ومن ضم النون منقول بالهمزة، مثل طعمت وأطعمت.
الآية: 31 {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم}
لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر، وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر، ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر. وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء، وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق، لا أنه يجب عليه ذلك. ونظير الكلام في هذا ما تقدم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: "إنما التوبة على الله" [النساء: 17]، فالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وروى أبو حاتم البستي إلى صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال: (والذي نفسي بيده) ثلاث مرات، ثم سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق) ثم تلا "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم". فقد تعاضد الكتاب وصحيح السنة بتكفير الصغائر قطعا كالنظر وشبهه. وبينت السنة أن المراد بـ "تجتنبوا" ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وإنما محمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء والمشيئة ثابتة. ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بألا تباعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة. ولا صغيرة عندنا. قال القشيري عبدالرحيم: والصحيح أنها كبائر ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض، والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي.
قلت: وأيضا فإن من نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم: - لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر، وعلى هذا النحو يخرج كلام القاضي أبي بكر بن الطيب والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وأبي المعالي وأبي نصر عبدالرحيم القشيري وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنى، ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر، بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، لقوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" [النساء: 48] واحتجوا بقراءة من قرأ "إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه" على التوحيد؛ وكبير الإثم الشرك. قالوا: وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر. والآية التي قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". واحتجوا بما رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة) فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال: (وإن كان قضيبا من أراك). فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية؛ وتصديقه قوله تعالى: "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه". وقال طاوس: قيل لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: اليأس من روج الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، والشرك بالله؛ دل عليها القرآن. وروي عن ابن عمر: هي تسع: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، والسحر، والإلحاد في البيت الحرام. ومن الكبائر عند العلماء: القمار والسرقة وشرب الخمر وسب السلف الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله وسب الإنسان أبويه - بأن يسب رجلا فيسب ذلك الرجل أبويه - والسعي في الأرض فسادا - ؛ إلى غير ذلك مما يكثر تعداده حسب ما جاء بيانها في القرآن، وفي أحاديث خرجها الأئمة، وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها جملة وافرة. وقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها؛ والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها الحصر، ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره، فالشرك أكبر ذلك كله، وهو الذي لا يغفر لنص الله تعالى على ذلك، وبعده اليأس من رحمة الله؛ لأن فيه تكذيب القرآن؛ إذ يقول وقوله الحق: "ورحمتي وسعت كل شيء" [الأعراف: 156] وهو يقول: لا يغفر له؛ فقد حجر واسعا. هذا إذا كان معتقدا لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: "إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون" [يوسف: 87]. وبعده القنوط؛ قال الله تعالى: "ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون" [الحجر: 56]. وبعده الأمن من مكر الله فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من غير عمل؛ قال الله تعالى: "أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون" [الأعراف: 99]. وقال تعالى: "وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين" [فصلت: 23]. وبعده القتل؛ لأن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود، واللواط فيه قطع النسل، والزنى فيه اختلاط الأنساب بالمياه، والخمر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلام، وشهادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج والأموال، إلى غير ذلك مما هو بين الضرر؛ فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده، أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة. فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه، والله أعلم.
قوله تعالى: "وندخلكم مدخلا كريما" قرأ أبو عمرو وأكثر الكوفيين "مدخلا" بضم الميم، فيحتمل أن يكون مصدرا، أي إدخالا، والمفعول محذوف أي وندخلكم الجنة إدخالا. ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولا. وقرأ أهل المدينة بفتح الميم، فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فعل؛ التقدير وندخلكم فتدخلون مدخلا، ودل الكلام عليه. ويجوز أن يكون اسم مكان فينتصب على أنه مفعول به، أي وندخلكم مكانا كريما وهو الجنة. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: سمعت أبا داود السجستاني يقول: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: المسلمون كلهم في الجنة؛ فقلت له: وكيف ؟ قال: يقول الله عز وجل: "إن تجتبوا كبائر ما تنهون، عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما" يعني الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). فإذا كان الله عز وجل يغفر ما دون الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الكبائر فأي ذنب يبقى على المسلمين. وقال علماؤنا: الكبائر عند أهل السنة تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت حسب ما تقدم. وقد يغفر لمن مات عليها من المسلمين كما قال تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" [النساء: 48] والمراد بذلك من مات على الذنوب؛ فلو كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنى؛ إذ التائب من الشرك أيضا مغفور له. وروي عن ابن مسعود أنه قال: خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا جميعا، قوله تعالى: "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه" وقوله "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر" [النساء: 48] الآية، وقوله تعالى: "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه" [النساء:110]الآية، وقوله تعالى: "وإن تك حسنة يضاعفها" [النساء: 40]، وقوله تعالى: "والذين آمنوا بالله ورسله" [النساء: 152]. وقال ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء، هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: "يريد الله ليبين لكم" [النساء: 26]، "والله يريد أن يتوب عليكم" [النساء: 27]، "يريد الله أن يخفف عنكم" [النساء: 28]، "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم" [النساء: 31]، الآية، "إن الله لا يغفر أن يشرك به"، "إن الله لا يظلم مثقال ذرة" [النساء: 40]، "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه"، "ما يفعل الله بعذابكم" [النساء: 147]الآية.
الآية: 32 {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم}
روى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث؛ فأنزل الله تعالى: "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض". قال مجاهد: وأنزل فيها "إن المسلمين والمسلمات" [الأحزاب: 35]، وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، ورواه بضعهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، مرسل أن أم سلمة قالت كذا. وقال قتادة: كان الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان؛ فلما ورثوا وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين تمنى النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث؛ فنزلت، "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض".
قوله تعالى: "ولا تتمنوا" التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل، كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني؛ لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل. وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الغبطة، وهي أن يتمنى الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمن زوال حاله. والجمهور على إجازة ذلك: مالك وغيره؛ وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه السلام (لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار). فمعنى قوله: "لا حسد" أي لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين. وقد نبه البخاري على هذا المعنى حيث بوب على هذا الحديث (باب الاغتباط في العلم والحكمة) قال المهلب: بين الله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز تمنيه، وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباهها. قال ابن عطية: وأما التمني في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن، وأما إذا تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمنا ذكره فذلك جائز؛ وذلك موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول: (وددت أن أحيا ثم أقتل).
قلت: هذا الحديث هو الذي صدر به البخاري كتاب التمني في صحيحه، وهو يدل على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيها، وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر؛ لأنه عليه السلام تمناها دون غيرها، وذلك لرفيع منزلتها وكرامة أهلها، فرزقه الله إياها؛ لقوله: (ما زالت أكلة خيبر تعادني الآن أوان قطعت أبهري). وفي الصحيح: (إن الشهيد يقال له تمن فيقول أتمنى أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى إيمان أبي طالب وإيمان أبي لهب وصناديد قريش مع علمه بأنه لا يكون؛ وكان يقول: (واشوقاه إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني). وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض، والتمني المنهي عنه في الآية من هذا القبيل؛ فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر، وسواء تمنيت مع ذلك أن يعود إليك أو لا. وهذا هو الحسد بعينه، وهو الذي ذمه الله تعالى بقوله: "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله" [النساء: ] ويدخل فيه أيضا خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه؛ لأنه داعية الحمد والمقت. وقد كره بعض العلماء الغبطة وأنها داخلة في النهي، والصحيح جوازها على ما بينا، وبالله توفيقنا. وقال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد، ألم تسمع الذين قالوا: "يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون" [القصص: ] إلى أن قال: "وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس" [القصص: ] حين خسف به وبداره وبأمواله "لولا أن من الله علينا لخسف بنا" [القصص: ] وقال الكلبي: لا يتمن الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته؛ ولكن ليقل: اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك في التوراة، وكذلك قوله في القرآن "واسألوا الله من فضله". وقال ابن عباس: نهى الله سبحانه أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله، وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله. ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء) الحديث... وقد تقدم. خرجه الترمذي وصححه. وقال الحسن: لا يتمن أحدكم المال وما يدريه لعل هلاكه فيه؛ وهذا إنما يصح إذا تمناه للدنيا، وأما إذا تمناه للخير فقد جوزه الشرع، فيتمناه العبد ليصل به إلى الرب، ويفعل الله ما يشاء.
قوله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا" يريد من الثواب والعقاب "وللنساء" كذلك؛ قال قتادة. فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث. والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فنهى الله عز وجل عن التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم؛ فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم.
قوله تعالى: "واسألوا الله من فضله" روى الترمذي عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج) وخرج أيضا ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يسأل الله يغضب عليه). وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب؛ وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال:
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب
وقال أحمد بن المعذل أبو الفضل الفقيه المالكي فأحسن:
التمس الأرزاق عند الذي ما دونه إن سيل من حاجب
من يبغض التارك تسأله جودا ومن يرضى عن الطالب
ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتب
وقد أشبعنا القول في هذا المعنى في كتاب "قمع الحرص بالزهد والقناعة". وقال سعيد بن جبير: "واسألوا الله من فضله" العبادة، ليس من أمر الدنيا. وقيل: سلوه التوفيق للعمل بما يرضيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سلوا ربكم حتى الشبع؛ فإنه إن لم ييسره الله عز وجل لم يتيسر. وقال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي.
وقرأ الكسائي وابن كثير: "وسلوا الله من فضله" بغير همز في جميع القرآن. الباقون بالهمز. "واسألوا الله". وأصله بالهمز إلا أنه حذفت الهمزة للتخفيف. والله أعلم.
الآية: 33 {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد}
بين تعالى أن لكل إنسان ورثة وموالي؛ فلينتفع كل واحد بما قسم الله له من الميراث، ولا يتمن مال غير. وروى البخاري في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: "ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم" قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت "ولكل جعلنا موالي" قال: نسختها "والذين عاقدت أيمانكم". قال أبو الحسن بن بطال: وقع في جميع النسخ "ولكل جعلنا موالي" قال: نسختها "والذين عاقدت أيمانكم". والصواب أن الآية الناسخة "ولكل جعلنا موالي" والمنسوخة "والذين عاقدت أيمانكم"، وكذا رواه الطبري في روايته. وروي، عن جمهور السلف أن الآية الناسخة لقوله: "والذين عاقدت أيمانكم" قوله تعالى في "الأنفال ": "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض" [الأنفال: 75]. روي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري؛ وهو الذي أثبته أبو عبيد في كتاب "الناسخ والمنسوخ" له. وفيها قول آخر رواه الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أمر الله عز وجل الذين تبنوا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى ذوي الرحم والعصبة. وقالت طائفة: قوله تعالى: "والذين عاقدت أيمانكم" محكم وليس بمنسوخ؛ وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛ ذكره الطبري عن ابن عباس. "والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم" من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي لهم وقد ذهب الميراث؛ وهو قول مجاهد والسدي.
قلت: واختاره النحاس؛ ورواه عن سعيد بن جبير، ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس فيما ذكره الطبري، ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير. وسيأتي ميراث "ذوي الأرحام" في "الأنفال" إن شاء الله تعالى.
قوله: "كل" في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم. فإذا جاءت مفردة فلا بد أن يكون في الكلام حذف عند جميع النحويين؛ حتى أن بعضهم أجاز مررت بكل، مثل قبل وبعد. وتقدير الحذف: ولكل أحد جعلنا موالي، يعني ورثة. "والذين عاقدت أيمانكم" يعني بالحلف؛ عن قتادة. وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك؛ فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف ثم نسخ.
قوله تعالى: "موالي" أعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه؛ فيسمى المعتق مولى والمعتق مولى. ويقال: المولى الأسفل والأعلى أيضا. ويسمى الناصر المولى؛ ومنه قوله تعالى: "وأن الكافرين لا مولى لهم" [محمد: 11]. ويسمى ابن العم مولى والجار مولى. فأما قوله تعالى: "ولكل جعلنا موالي" يريد عصبة؛ لقوله عليه السلام: (ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر). ومن العصبات المولى الأعلى لا الأسفل، على قول أكثر العلماء؛ لأن المفهوم في حق المعتق أنه المنعم على المعتق، كالموجد له؛ فاستحق ميراثه لهذا المعنى. وحكى الطحاوي عن الحسن بن زياد أن المولى الأسفل يرث من الأعلى؛ واحتج فيه بما روي أن رجلا أعتق عبدا له لهذا الحديث ولم يترك إلا المعتق فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام المعتق. قال الطحاوي: ولا معارض لهذا الحديث، فوجب القول به؛ ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للمعتق على تقدير أنه كان كالموجد له، فهو شبيه بالأب؛ والمولى الأسفل شبيه بالابن؛ وذلك يقتضي التسوية بينهما في الميراث، والأصل أن الاتصال يعم. وفي الخبر (مولى القوم منهم). والذين خالفوا هذا وهم الجمهور قالوا: الميراث. يستدعي القرابة ولا قرابة، غير أنا أثبتنا للمعتق الميراث بحكم الإنعام على المعتق؛ فيقتضي مقابلة الإنعام بالمجازاة، وذلك لا ينعكس في المولى الأسفل. وأما الابن فهو أولى الناس بأن يكون خليفة أبيه وقائما مقامه، وليس المعتق صالحا لأن يقوم مقام معتقه، وإنما المعتق قد أنعم عليه فقابله الشرع بأن جعله أحق بمولاه المعتق، ولا يوجد هذا في المولى الأسفل؛ فظهر الفرق بينهما والله أعلم.
قوله تعالى: "والذين عقدت أيمانكم" روى علي بن كبشة عن حمزة "عقَّدت" بتشديد القاف على التكثير. والمشهور عن حمزة "عقدت أيمانكم" مخففة القاف، وهي قراءة عاصم والكسائي، وهي قراءة بعيدة؛ لأن المعاقدة لا تكون إلا من اثنين فصاعدا، فبابها فاعل. قال أبو جعفر النحاس: وقراءة حمزة تجوز على غموض في العربية، يكون التقدير فيها والذين عقدتهم أيمانكم الحلف، وتعدى إلى مفعولين؛ وتقديره: عقدت لهم أيمانكم الحلف، ثم حذفت اللام مثل قوله تعالى: "وإذا كالوهم" [المطففين: 3] أي كالوا لهم. وحذف المفعول الثاني، كما يقال: كلتك أي كلت لك برا. وحذف المفعول الأول لأنه متصل في الصلة.
قوله تعالى: "فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا" أي قد شهد معاقدتكم إياهم، وهو عز وجل يحب الوفاء.










الصفحة رقم 83 من المصحف تحميل و استماع mp3