سورة التوبة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
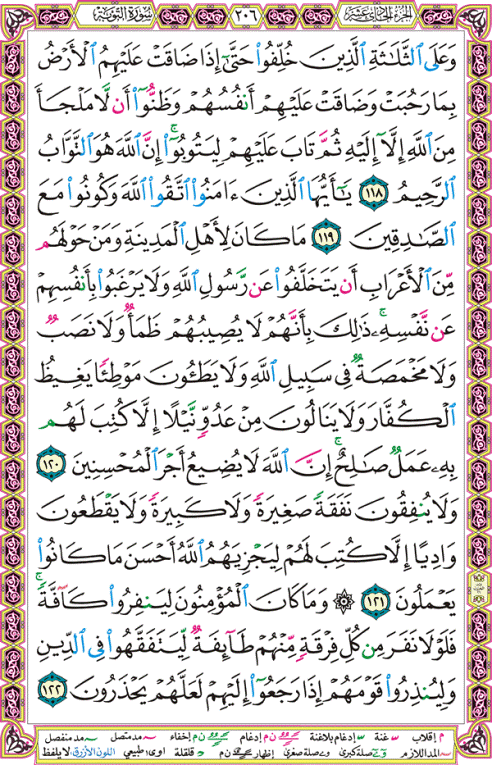
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 206 من المصحف
الآية: 118 {وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم}
قوله تعالى: "وعلى الثلاثة الذين خلفوا" قيل: عن التوبة عن مجاهد وأبي مالك. وقال قتادة: عن غزوة تبوك. وحكي عن محمد بن زيد معنى "خلفوا" تركوا؛ لأن معنى خلفت فلانا تركته وفارقته قاعدا عما نهضت فيه. وقرأ عكرمة بن خالد "خلفوا" أي أقاموا بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن جعفر بن محمد أنه قرأ "خالفوا". وقيل: "خلفوا" أي أرجئوا وأخروا عن المنافقين فلم يقض فيهم بشيء. وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم، واعتذر أقوام فقبل عذرهم، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم والبخاري وغيرهما. واللفظ لمسلم قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عز وجل: "وعلى الثلاثة الذين خلقوا" وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وهذا الحديث فيه طول، هذا آخره.
والثلاثة الذين خلفوا هم: كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي وكلهم من الأنصار. وقد خرج البخاري ومسلم حديثهم، فقال مسلم عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد بذلك الديوان - قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل كذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أترحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: (ما فعل كعب بن مالك)؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كن أبا خيثمة) فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حتى لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي فلما قيل لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: (تعال) فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: (ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك)؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك). فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المتخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة؛ قال: فمضيت حين ذكروهما لي.
قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس. وقال: وتغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة؛ فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم فقاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطيٌ من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال فقلت، حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: فأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: (لا ولكن لا يقربنك) فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب قال: فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا.
قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت عليّ الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ فكسوته إياهما ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيدالله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: (أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك). قال: فقلت أمن عند الله يا رسول الله أم من عندك؟ قال: (لا بل من عند الله). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك). قال فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي فأنزل الله عز وجل: "لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين أتبعوه في ساعة العسرة - حتى بلغ - إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم - حتى بلغ - اتقوا الله وكونوا مع الصادقين". قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله تعالى: "سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين" [التوبة: 95 - 96]. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله عز وجل: "وعلى الثلاثة" وليس الذي ذكر الله مما خُلفنا تَخَلُفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
قوله تعالى: "حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت" أي بما اتسعت يقال: منزل رجب ورحيب ورحاب. و"ما" مصدرية؛ أي ضاقت عليهم الأرض برحبها، لأنهم كانوا مهجورين لا يعاملون ولا يكلمون. وفي هذا دليل على هجران أهل المعاصي حتى يتوبوا. "وضاقت عليهم أنفسهم" أي ضاقت صدورهم بالهم والوحشة، "وبما لقوه من الصحابة من الجفوة. "وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه" أي تيقنوا أن لا ملجأ يلجؤون إليه في الصفح عنهم وقبول التوبة منهم إلا إليه. قال أبو بكر الوراق. التوبة النصوح أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت، وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة كعب وصاحبيه.
قوله تعالى: "ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم" فبدأ بالتوبة منه. قال أبو زيد: غلطت في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى، ظننت أني أحبه فإذا هو أحبني؛ قال الله تعالى: "يحبهم ويحبونه" [المائدة: 54]. وظننت أني أرضى عنه فإذا هو قد رضي عني؛ قال الله تعالى: "رضي الله عنهم ورضوا عنه" [المائدة: 119]. وظننت أني أذكره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالى: "ولذكر الله أكبر". وظننت أني أتوب فإذا هو قد تاب على؛ قال الله تعالى: "ثم تاب عليهم ليتوبوا". وقيل: المعنى ثم تاب عليهم ليثبتوا على التوبة؛ كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا آمنوا" [النساء: 136] وقيل: أي فسح لهم ولم يعجل عقابهم كما فعل بغيرهم؛ قال جل وعز: "فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم" [النساء: 160].
الآية: 119 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}
قوله تعالى: "وكونوا مع الصادقين" هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين. قال مطرف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف.
واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال؛ فقيل: هو خطاب لمن آمن من أهل الكتاب. وقيل: هو خطاب لجميع المؤمنين؛ أي اتقوا مخالفة أمر الله "وكونوا مع الصادقين" أي مع الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا مع المنافقين. أي كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم. وقيل: هم الأنبياء؛ أي كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. وقيل: هم المراد بقوله: "ليس البر أن تولوا وجوهكم - الآية إلى قوله - أولئك الذين صدقوا" [البقرة: 177]. وقيل: هم الموفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أبي بكر يوم السقيفة إن الله سمانا الصادقين فقال: "للفقراء المهاجرين" [الحشر: 8] الآية، ثم سماكم بالمفلحين فقال: "والذين تبوؤوا الدار والإيمان" [الحشر: 9] الآية. وقيل: هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم. قال ابن العربي: وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل، وصاحبها يقال له الصديق كأبي بكر وعمر وعثمان ومن دونهم على منازلهم وأزمانهم. وأما من قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو معظم الصدق ومتبعه الأقل وهو معنى آية الأحزاب. وأما تفسير أبي بكر الصديق فهو الذي يعم الأقوال كلها فإن جميع الصفات فيهم موجودة.
حق من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق في الأقوال، والإخلاص في الأعمال، والصفاء، في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار؛ قال صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا). والكذب على الضد من ذلك؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) خرجه مسلم. فالكذب عار وأهله مسلوبو الشهادة، وقد رد صلى الله عليه وسلم شهادة رجل في كذبة كذبها. قال معمر: لا أدري أكذب على الله أو كذب على رسوله أو كذب على أحد من الناس. وسئل شريك بن عبدالله فقيل له: يا أبا عبدالله، رجل سمعته يكذب متعمدا أأصلي خلفه؟ قال لا. وعن ابن مسعود قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم شيئا ثم لا ينجزه، أقرؤوا إن شئتم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" هل ترون في الكذب رخصة؟ وقال مالك: لا يقبل خبر الكاذب في حديث الناس وإن صدق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: يقبل حديثه. والصحيح أن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبره لما ذكرناه؛ فإن القبول مرتبة عظيمة وولاية شريفة لا تكون إلا لمن كملت خصاله ولا خصلة هي أشر من الكذب فهي تعزل الولايات وتبطل الشهادات.
الآيتان: 120 - 121 {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون}
قوله تعالى: "ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله" ظاهره خبر ومعناه أمر؛ كقوله: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" [الأحزاب: 53] وقد تقدم. "أن يتخلفوا" في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبة للمؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها؛ كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم على التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلفوا؛ فإن النفير كان فيهم، بخلاف غيرهم فإنهم لن يستنفروا؛ في قول بعضهم. ويحتمل أن يكون الاستنفار في كل مسلم، وخصى هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم، وأنهم أحق بذلك من غيرهم.
قوله تعالى: "ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه" أي لا يرضوا لأنفسهم بالخفض والدعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المشقة. يقال: رغبت عن كذا أي ترفعت عنه. "ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ" أي عطش. وقرأ عبيد بن عمير "ظماء" بالمد. وهما لغتان مثل خطأ وخطاء. "ولا نصب" عطف، أي تعب، ولا زائدة للتوكيد. وكذا "ولا مخمصة" أي مجاعة. وأصله ضمور البطن؛ ومنه رجل خميص وامرأة خمصانة. وقد تقدم. "في سبيل الله" أي في طاعته. "ولا يطؤون موطئا" أي أرضا. "يغيظ الكفار" أي بوطئهم إياها، وهو في موضع نصب لأنه نعت للموطئ، أي غائظا. "ولا ينالون من عدو نيلا" أي قتلا وهزيمة. وأصله من نلت الشيء أنال أي أصبت. قال الكسائي: هو من قولهم أمر منيل منه؛ وليس هو من التناول، إنما التناول من نلته العطية. قال غيره: نلت أنول من العطية، من الواو والنيل من الياء، تقول: نلته فأنا نائل، أي أدركته. "ولا يقطعون وادي" العرب تقول: واد وأودية، على غير قياس. قال النحاس: ولا يعرف فيما علمت فاعل وأفعلة سواه، والقياس أن يجمع ووادي؛ فاستثقلوا الجمع بين واوين وهم قد يستثقلون واحدة، حتى قالوا: أقتت في وقتت. وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل اسم رجل أو يصل فلا يقولون غيره. وحكى الفراء في جمع واد أوداء. قلت: وقد جمع أوداه؛ قال جرير:
عرفت ببرقة الأوداه رسما محيلا طال عهدك من رسوم
"إلا كتب لهم به عمل صالح" قال ابن عباس: بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون ألف حسنة. وفي الصحيح: (الخيل ثلاثة... - وفيه - وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات...). الحديث. هذا وهي في مواضعها فكيف إذا أدرب بها.
استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدو، فإن مات بعد ذلك فله سهمه؛ وهو قول أشهب وعبدالملك، وأحد قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عز وجل إنما ذكر في هذه الآية الأجر ولم يذكر السهم.
قلت: الأول أصح لأن الله تعالى: جعل وطء ديار الكفار بمثابة النيل من أموالهم وإخراجهم من ديارهم، وهو الذي يغيظهم ويدخل الذل عليهم، فهو بمنزلة نيل الغنيمة والقتل والأسر؛ وإذا كان كذلك فالغنيمة تستحق بالإدراب لا بالحيازة، ولذلك قال علي رضي الله عنه: ما وطئ قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. والله أعلم.
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة" [التوبة: 122] وأن حكمها كان حين كان المسلمون في قلة، فلما كثروا نسخت وأباح الله التخلف لمن شاء؛ قاله ابن زيد. وقال مجاهد: بعث صلى الله عليه وسلم قوما إلى البوادي ليعلموا الناس فلما نزلت هذه الآية خافوا ورجعوا؛ فأنزل الله: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة". وقال قتادة: كان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر؛ فأما غيره من الأئمة الولاة فلمن شاء أن يتخلف خلفه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة. وقول ثالث: أنها محكمة؛ قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي وابن المبارك والفزاري والسبيعي وسعيد بن عبدالعزيز يقولون في هذه الآية إنها لأول هذه الأمة وآخرها.
قلت: قول قتادة حسن؛ بدليل غزاة تبوك، والله أعلم.
روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه) قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة.؟ قال: (حبسهم العذر). خرجه مسلم من حديث جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: (إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض). فأعطى صلى الله عليه وسلم للمعذور من الأجر مثل ما أعطى للقوي العامل. وقد قال بعض الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعف، ويضاعف للعامل المباشر. قال ابن العربي: وهذا تحكم على الله تعالى وتضييق لسعة رحمته، وقد عاب بعض الناس فقال: إنهم يعطون الثواب مضاعفا قطعا، ونحن لا نقطع بالتضعيف في موضع فإنه مبني على مقدار النيات، وهذا أمر مغيب، والذي يقطع به أن هناك تضعيفا وربك أعلم بمن يستحقه.
قلت: الظاهر من الأحاديث والآي المساواة في الأجر؛ منها قوله عليه السلام: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) وقوله: (من توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها). وهو ظاهر قوله تعالى: "ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله" [النساء:100] وبدليل أن النية الصادقة هي أصل الأعمال، فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منع منها فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل ويزيد عليه؛ لقوله عليه السلام: (نية المؤمن خير من عمله). والله أعلم.
الآية: 122 {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}
قوله تعالى: "وما كان المؤمنون" وهي أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية كما تقدم؛ إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع، وما تجدد نزول على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: "إلا تنفروا" [التوبة: 39] وللآية التي قبلها؛ على قول مجاهد وابن زيد.
هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة والنبي صلى الله عليه وسلم مقيم لا ينفر فيتركوه وحده. "فلو لا نفر" بعد ما علموا أن النفير لا يسع جميعهم. "من كل فرقة منهم طائفة" وتبقى بقيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفى هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون الأعيان. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [النحل: 43]. فدخل في هذا من لا يعلم الكتاب والسنن.
قوله تعالى: "فلولا نفر" قال الأخفش: أي فهلا نفر. "من كل فرقة منهم طائفة" الطائفة في اللغة الجماعة، وقد تقع على أقل من ذلك حتى تبلغ الرجلين، وللواحد على معنى نفس طائفة. وقد تقدم أن المراد بقوله تعالى: "إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة" [التوبة: 66] رجل واحد. ولا شك أن المراد هنا جماعة لوجهين؛ أحدهما عقلا، والآخر لغة. أما العقل فلأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب، وأما اللغة فقوله: "ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم" فجاء بضمير الجماعة. قال ابن العربي: والقاضي أبو بكر والشيخ أبو الحسن قبله يرون أن الطائفة ههنا واحد، ويعتضون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد، وهو صحيح لا من جهة. أن الطائفة تنطلق على الواحد ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحد، وأن مقابله وهو التواتر لا ينحصر.
قلت: أنص ما يستدل به على أن الواحد يقال له طائفة قوله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا" [الحجرات: 9] يعني نفسين. دليله قوله تعالى: "فأصلحوا بين أخويكم" [الحجرات: 9] فجاء بلفظ التثنية، والضمير في "اقتتلوا" وإن كان ضمير جماعة فأقل الجماعة اثنان في أحد القولين للعلماء.
قوله تعالى: "ليتفقهوا" الضمير في "ليتفقهوا ، ولينذروا" للمقيمين مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ قاله قتادة ومجاهد. وقال الحسن: هما للفرقة النافرة؛ واختاره الطبري. ومعنى "ليتفقهوا في الدين" أي يتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين. "ولينذروا قومهم" من الكفار. "إذا رجعوا إليهم" من الجهاد فيخبرونهم بنصرة الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأنهم لا يدان لهم بقتالهم وقتال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار.
قلت: قول مجاهد وقتادة أبين، أي لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفور في السرايا. وهذا يقتضي الحث على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب والإلزام؛ إذ ليس ذلك في قوة الكلام، وإنما لزم طلب العلم بأدلته؛ قاله أبو بكر بن العربي.
طلب العلم ينقسم قسمين: فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة والصيام.
قلت: وفي هذا المعنى جاء الحديث المروي (إن طلب العلم فريضة). روى عبدالقدوس بن حبيب: أبو سعيد الوحاظي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (طلب العلم فريضة على كل مسلم). قال إبراهيم: لم أسمع من أنس بن مالك إلا هذا الحديث.
وفرض على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم ونحوه؛ إذ لا يصلح أن يتعلمه جميع الناس فتضيع أحوالهم وأحوال سراياهم وتنقص أو تبطل معايشهم؛ فتعين بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين، وذلك بحسب ما يسره الله لعباده وقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته وكلمته.
طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل؛ روى الترمذي من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر). وروى الدارمي أبو محمد في مسنده قال: حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير. والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم). أسنده أبو عمر في كتاب بيان العلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي). وقال ابن عباس: أفضل الجهاد من بنى مسجدا يعلم فيه القرآن والفقه والسنة. رواه شريك عن ليث بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير عن علي الأزدي قال: أردت الجهاد فقال لي ابن عباس ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد، تأتي مسجدا فتقرئ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة. وقوله عليه السلام: (إن الملائكة لتضع أجنحتها...) الحديث يحتمل وجهين: أحدهما: أنها تعطف عليه وترحمه؛ كما قال الله تعالى فيما وصى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله: "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة" [الإسراء: 24] أي تواضع لهما. والوجه الآخر: أن يكون المراد بوضع الأجنحة فرشها؛ لأن في بعض الروايات (وإن الملائكة تفرش أجنحتها) أي إن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه من وجهه ابتغاء مرضات الله وكانت سائر أحواله مشاكلة لطلب العلم فرشت له أجنحتها في رحلته وحملته عليها؛ فمن هناك يسلم فلا يحفى إن كان ماشيا ولا يعيا، وتقرب عليه الطريق البعيدة ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرر كالمرض وذهاب المال وضلال الطريق. وقد مضى شيء من هذا المعنى في "آل عمران" عند قوله تعالى: "شهد الله..." الآية. روى عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة). قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟.
قلت: وهذا قول عبدالرزاق في تأويل الآية، إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره الثعلبي. سمعت شيخنا الأستاذ المقرئ النحوي المحدث أبا جعفر أحمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بابن أبي حجة رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه السلام: (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة) إنهم العلماء؛ قال: وذلك أن الغرب لفظ مشترك يطلق على الدلو الكبيرة وعلى مغرب الشمس، ويطلق على فيضة من الدمع. فمعنى (لا يزال أهل الغرب) أي لا يزال أهل فيض الدمع من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهرين؛ الحديث. قال الله تعالى: "إنما يخشى الله من عباده العلماء" [فاطر: 28].
قلت: وهذا التأويل يعضده قوله عليه السلام في صحيح مسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة). وظاهر هذا المساق أن أوله مرتبط بآخره. والله أعلم.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 206
206- تفسير الصفحة رقم206 من المصحفالآية: 118 {وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم}
قوله تعالى: "وعلى الثلاثة الذين خلفوا" قيل: عن التوبة عن مجاهد وأبي مالك. وقال قتادة: عن غزوة تبوك. وحكي عن محمد بن زيد معنى "خلفوا" تركوا؛ لأن معنى خلفت فلانا تركته وفارقته قاعدا عما نهضت فيه. وقرأ عكرمة بن خالد "خلفوا" أي أقاموا بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن جعفر بن محمد أنه قرأ "خالفوا". وقيل: "خلفوا" أي أرجئوا وأخروا عن المنافقين فلم يقض فيهم بشيء. وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم، واعتذر أقوام فقبل عذرهم، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم والبخاري وغيرهما. واللفظ لمسلم قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عز وجل: "وعلى الثلاثة الذين خلقوا" وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وهذا الحديث فيه طول، هذا آخره.
والثلاثة الذين خلفوا هم: كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي وكلهم من الأنصار. وقد خرج البخاري ومسلم حديثهم، فقال مسلم عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد بذلك الديوان - قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل كذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أترحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: (ما فعل كعب بن مالك)؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كن أبا خيثمة) فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حتى لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي فلما قيل لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: (تعال) فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: (ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك)؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك). فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المتخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة؛ قال: فمضيت حين ذكروهما لي.
قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس. وقال: وتغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة؛ فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم فقاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطيٌ من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال فقلت، حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: فأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: (لا ولكن لا يقربنك) فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب قال: فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا.
قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت عليّ الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ فكسوته إياهما ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيدالله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: (أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك). قال: فقلت أمن عند الله يا رسول الله أم من عندك؟ قال: (لا بل من عند الله). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك). قال فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي فأنزل الله عز وجل: "لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين أتبعوه في ساعة العسرة - حتى بلغ - إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم - حتى بلغ - اتقوا الله وكونوا مع الصادقين". قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله تعالى: "سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين" [التوبة: 95 - 96]. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله عز وجل: "وعلى الثلاثة" وليس الذي ذكر الله مما خُلفنا تَخَلُفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
قوله تعالى: "حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت" أي بما اتسعت يقال: منزل رجب ورحيب ورحاب. و"ما" مصدرية؛ أي ضاقت عليهم الأرض برحبها، لأنهم كانوا مهجورين لا يعاملون ولا يكلمون. وفي هذا دليل على هجران أهل المعاصي حتى يتوبوا. "وضاقت عليهم أنفسهم" أي ضاقت صدورهم بالهم والوحشة، "وبما لقوه من الصحابة من الجفوة. "وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه" أي تيقنوا أن لا ملجأ يلجؤون إليه في الصفح عنهم وقبول التوبة منهم إلا إليه. قال أبو بكر الوراق. التوبة النصوح أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت، وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة كعب وصاحبيه.
قوله تعالى: "ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم" فبدأ بالتوبة منه. قال أبو زيد: غلطت في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى، ظننت أني أحبه فإذا هو أحبني؛ قال الله تعالى: "يحبهم ويحبونه" [المائدة: 54]. وظننت أني أرضى عنه فإذا هو قد رضي عني؛ قال الله تعالى: "رضي الله عنهم ورضوا عنه" [المائدة: 119]. وظننت أني أذكره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالى: "ولذكر الله أكبر". وظننت أني أتوب فإذا هو قد تاب على؛ قال الله تعالى: "ثم تاب عليهم ليتوبوا". وقيل: المعنى ثم تاب عليهم ليثبتوا على التوبة؛ كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا آمنوا" [النساء: 136] وقيل: أي فسح لهم ولم يعجل عقابهم كما فعل بغيرهم؛ قال جل وعز: "فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم" [النساء: 160].
الآية: 119 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}
قوله تعالى: "وكونوا مع الصادقين" هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين. قال مطرف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف.
واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال؛ فقيل: هو خطاب لمن آمن من أهل الكتاب. وقيل: هو خطاب لجميع المؤمنين؛ أي اتقوا مخالفة أمر الله "وكونوا مع الصادقين" أي مع الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا مع المنافقين. أي كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم. وقيل: هم الأنبياء؛ أي كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. وقيل: هم المراد بقوله: "ليس البر أن تولوا وجوهكم - الآية إلى قوله - أولئك الذين صدقوا" [البقرة: 177]. وقيل: هم الموفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أبي بكر يوم السقيفة إن الله سمانا الصادقين فقال: "للفقراء المهاجرين" [الحشر: 8] الآية، ثم سماكم بالمفلحين فقال: "والذين تبوؤوا الدار والإيمان" [الحشر: 9] الآية. وقيل: هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم. قال ابن العربي: وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل، وصاحبها يقال له الصديق كأبي بكر وعمر وعثمان ومن دونهم على منازلهم وأزمانهم. وأما من قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو معظم الصدق ومتبعه الأقل وهو معنى آية الأحزاب. وأما تفسير أبي بكر الصديق فهو الذي يعم الأقوال كلها فإن جميع الصفات فيهم موجودة.
حق من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق في الأقوال، والإخلاص في الأعمال، والصفاء، في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار؛ قال صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا). والكذب على الضد من ذلك؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) خرجه مسلم. فالكذب عار وأهله مسلوبو الشهادة، وقد رد صلى الله عليه وسلم شهادة رجل في كذبة كذبها. قال معمر: لا أدري أكذب على الله أو كذب على رسوله أو كذب على أحد من الناس. وسئل شريك بن عبدالله فقيل له: يا أبا عبدالله، رجل سمعته يكذب متعمدا أأصلي خلفه؟ قال لا. وعن ابن مسعود قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم شيئا ثم لا ينجزه، أقرؤوا إن شئتم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" هل ترون في الكذب رخصة؟ وقال مالك: لا يقبل خبر الكاذب في حديث الناس وإن صدق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: يقبل حديثه. والصحيح أن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبره لما ذكرناه؛ فإن القبول مرتبة عظيمة وولاية شريفة لا تكون إلا لمن كملت خصاله ولا خصلة هي أشر من الكذب فهي تعزل الولايات وتبطل الشهادات.
الآيتان: 120 - 121 {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون}
قوله تعالى: "ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله" ظاهره خبر ومعناه أمر؛ كقوله: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" [الأحزاب: 53] وقد تقدم. "أن يتخلفوا" في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبة للمؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها؛ كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم على التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلفوا؛ فإن النفير كان فيهم، بخلاف غيرهم فإنهم لن يستنفروا؛ في قول بعضهم. ويحتمل أن يكون الاستنفار في كل مسلم، وخصى هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم، وأنهم أحق بذلك من غيرهم.
قوله تعالى: "ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه" أي لا يرضوا لأنفسهم بالخفض والدعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المشقة. يقال: رغبت عن كذا أي ترفعت عنه. "ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ" أي عطش. وقرأ عبيد بن عمير "ظماء" بالمد. وهما لغتان مثل خطأ وخطاء. "ولا نصب" عطف، أي تعب، ولا زائدة للتوكيد. وكذا "ولا مخمصة" أي مجاعة. وأصله ضمور البطن؛ ومنه رجل خميص وامرأة خمصانة. وقد تقدم. "في سبيل الله" أي في طاعته. "ولا يطؤون موطئا" أي أرضا. "يغيظ الكفار" أي بوطئهم إياها، وهو في موضع نصب لأنه نعت للموطئ، أي غائظا. "ولا ينالون من عدو نيلا" أي قتلا وهزيمة. وأصله من نلت الشيء أنال أي أصبت. قال الكسائي: هو من قولهم أمر منيل منه؛ وليس هو من التناول، إنما التناول من نلته العطية. قال غيره: نلت أنول من العطية، من الواو والنيل من الياء، تقول: نلته فأنا نائل، أي أدركته. "ولا يقطعون وادي" العرب تقول: واد وأودية، على غير قياس. قال النحاس: ولا يعرف فيما علمت فاعل وأفعلة سواه، والقياس أن يجمع ووادي؛ فاستثقلوا الجمع بين واوين وهم قد يستثقلون واحدة، حتى قالوا: أقتت في وقتت. وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل اسم رجل أو يصل فلا يقولون غيره. وحكى الفراء في جمع واد أوداء. قلت: وقد جمع أوداه؛ قال جرير:
عرفت ببرقة الأوداه رسما محيلا طال عهدك من رسوم
"إلا كتب لهم به عمل صالح" قال ابن عباس: بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون ألف حسنة. وفي الصحيح: (الخيل ثلاثة... - وفيه - وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات...). الحديث. هذا وهي في مواضعها فكيف إذا أدرب بها.
استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدو، فإن مات بعد ذلك فله سهمه؛ وهو قول أشهب وعبدالملك، وأحد قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عز وجل إنما ذكر في هذه الآية الأجر ولم يذكر السهم.
قلت: الأول أصح لأن الله تعالى: جعل وطء ديار الكفار بمثابة النيل من أموالهم وإخراجهم من ديارهم، وهو الذي يغيظهم ويدخل الذل عليهم، فهو بمنزلة نيل الغنيمة والقتل والأسر؛ وإذا كان كذلك فالغنيمة تستحق بالإدراب لا بالحيازة، ولذلك قال علي رضي الله عنه: ما وطئ قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. والله أعلم.
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة" [التوبة: 122] وأن حكمها كان حين كان المسلمون في قلة، فلما كثروا نسخت وأباح الله التخلف لمن شاء؛ قاله ابن زيد. وقال مجاهد: بعث صلى الله عليه وسلم قوما إلى البوادي ليعلموا الناس فلما نزلت هذه الآية خافوا ورجعوا؛ فأنزل الله: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة". وقال قتادة: كان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر؛ فأما غيره من الأئمة الولاة فلمن شاء أن يتخلف خلفه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة. وقول ثالث: أنها محكمة؛ قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي وابن المبارك والفزاري والسبيعي وسعيد بن عبدالعزيز يقولون في هذه الآية إنها لأول هذه الأمة وآخرها.
قلت: قول قتادة حسن؛ بدليل غزاة تبوك، والله أعلم.
روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه) قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة.؟ قال: (حبسهم العذر). خرجه مسلم من حديث جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: (إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض). فأعطى صلى الله عليه وسلم للمعذور من الأجر مثل ما أعطى للقوي العامل. وقد قال بعض الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعف، ويضاعف للعامل المباشر. قال ابن العربي: وهذا تحكم على الله تعالى وتضييق لسعة رحمته، وقد عاب بعض الناس فقال: إنهم يعطون الثواب مضاعفا قطعا، ونحن لا نقطع بالتضعيف في موضع فإنه مبني على مقدار النيات، وهذا أمر مغيب، والذي يقطع به أن هناك تضعيفا وربك أعلم بمن يستحقه.
قلت: الظاهر من الأحاديث والآي المساواة في الأجر؛ منها قوله عليه السلام: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) وقوله: (من توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها). وهو ظاهر قوله تعالى: "ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله" [النساء:100] وبدليل أن النية الصادقة هي أصل الأعمال، فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منع منها فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل ويزيد عليه؛ لقوله عليه السلام: (نية المؤمن خير من عمله). والله أعلم.
الآية: 122 {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}
قوله تعالى: "وما كان المؤمنون" وهي أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية كما تقدم؛ إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع، وما تجدد نزول على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: "إلا تنفروا" [التوبة: 39] وللآية التي قبلها؛ على قول مجاهد وابن زيد.
هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة والنبي صلى الله عليه وسلم مقيم لا ينفر فيتركوه وحده. "فلو لا نفر" بعد ما علموا أن النفير لا يسع جميعهم. "من كل فرقة منهم طائفة" وتبقى بقيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفى هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون الأعيان. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [النحل: 43]. فدخل في هذا من لا يعلم الكتاب والسنن.
قوله تعالى: "فلولا نفر" قال الأخفش: أي فهلا نفر. "من كل فرقة منهم طائفة" الطائفة في اللغة الجماعة، وقد تقع على أقل من ذلك حتى تبلغ الرجلين، وللواحد على معنى نفس طائفة. وقد تقدم أن المراد بقوله تعالى: "إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة" [التوبة: 66] رجل واحد. ولا شك أن المراد هنا جماعة لوجهين؛ أحدهما عقلا، والآخر لغة. أما العقل فلأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب، وأما اللغة فقوله: "ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم" فجاء بضمير الجماعة. قال ابن العربي: والقاضي أبو بكر والشيخ أبو الحسن قبله يرون أن الطائفة ههنا واحد، ويعتضون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد، وهو صحيح لا من جهة. أن الطائفة تنطلق على الواحد ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحد، وأن مقابله وهو التواتر لا ينحصر.
قلت: أنص ما يستدل به على أن الواحد يقال له طائفة قوله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا" [الحجرات: 9] يعني نفسين. دليله قوله تعالى: "فأصلحوا بين أخويكم" [الحجرات: 9] فجاء بلفظ التثنية، والضمير في "اقتتلوا" وإن كان ضمير جماعة فأقل الجماعة اثنان في أحد القولين للعلماء.
قوله تعالى: "ليتفقهوا" الضمير في "ليتفقهوا ، ولينذروا" للمقيمين مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ قاله قتادة ومجاهد. وقال الحسن: هما للفرقة النافرة؛ واختاره الطبري. ومعنى "ليتفقهوا في الدين" أي يتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين. "ولينذروا قومهم" من الكفار. "إذا رجعوا إليهم" من الجهاد فيخبرونهم بنصرة الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأنهم لا يدان لهم بقتالهم وقتال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار.
قلت: قول مجاهد وقتادة أبين، أي لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفور في السرايا. وهذا يقتضي الحث على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب والإلزام؛ إذ ليس ذلك في قوة الكلام، وإنما لزم طلب العلم بأدلته؛ قاله أبو بكر بن العربي.
طلب العلم ينقسم قسمين: فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة والصيام.
قلت: وفي هذا المعنى جاء الحديث المروي (إن طلب العلم فريضة). روى عبدالقدوس بن حبيب: أبو سعيد الوحاظي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (طلب العلم فريضة على كل مسلم). قال إبراهيم: لم أسمع من أنس بن مالك إلا هذا الحديث.
وفرض على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم ونحوه؛ إذ لا يصلح أن يتعلمه جميع الناس فتضيع أحوالهم وأحوال سراياهم وتنقص أو تبطل معايشهم؛ فتعين بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين، وذلك بحسب ما يسره الله لعباده وقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته وكلمته.
طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل؛ روى الترمذي من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر). وروى الدارمي أبو محمد في مسنده قال: حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير. والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم). أسنده أبو عمر في كتاب بيان العلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي). وقال ابن عباس: أفضل الجهاد من بنى مسجدا يعلم فيه القرآن والفقه والسنة. رواه شريك عن ليث بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير عن علي الأزدي قال: أردت الجهاد فقال لي ابن عباس ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد، تأتي مسجدا فتقرئ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة. وقوله عليه السلام: (إن الملائكة لتضع أجنحتها...) الحديث يحتمل وجهين: أحدهما: أنها تعطف عليه وترحمه؛ كما قال الله تعالى فيما وصى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله: "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة" [الإسراء: 24] أي تواضع لهما. والوجه الآخر: أن يكون المراد بوضع الأجنحة فرشها؛ لأن في بعض الروايات (وإن الملائكة تفرش أجنحتها) أي إن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه من وجهه ابتغاء مرضات الله وكانت سائر أحواله مشاكلة لطلب العلم فرشت له أجنحتها في رحلته وحملته عليها؛ فمن هناك يسلم فلا يحفى إن كان ماشيا ولا يعيا، وتقرب عليه الطريق البعيدة ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرر كالمرض وذهاب المال وضلال الطريق. وقد مضى شيء من هذا المعنى في "آل عمران" عند قوله تعالى: "شهد الله..." الآية. روى عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة). قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟.
قلت: وهذا قول عبدالرزاق في تأويل الآية، إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره الثعلبي. سمعت شيخنا الأستاذ المقرئ النحوي المحدث أبا جعفر أحمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بابن أبي حجة رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه السلام: (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة) إنهم العلماء؛ قال: وذلك أن الغرب لفظ مشترك يطلق على الدلو الكبيرة وعلى مغرب الشمس، ويطلق على فيضة من الدمع. فمعنى (لا يزال أهل الغرب) أي لا يزال أهل فيض الدمع من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهرين؛ الحديث. قال الله تعالى: "إنما يخشى الله من عباده العلماء" [فاطر: 28].
قلت: وهذا التأويل يعضده قوله عليه السلام في صحيح مسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة). وظاهر هذا المساق أن أوله مرتبط بآخره. والله أعلم.










الصفحة رقم 206 من المصحف تحميل و استماع mp3