سورة الأعراف | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
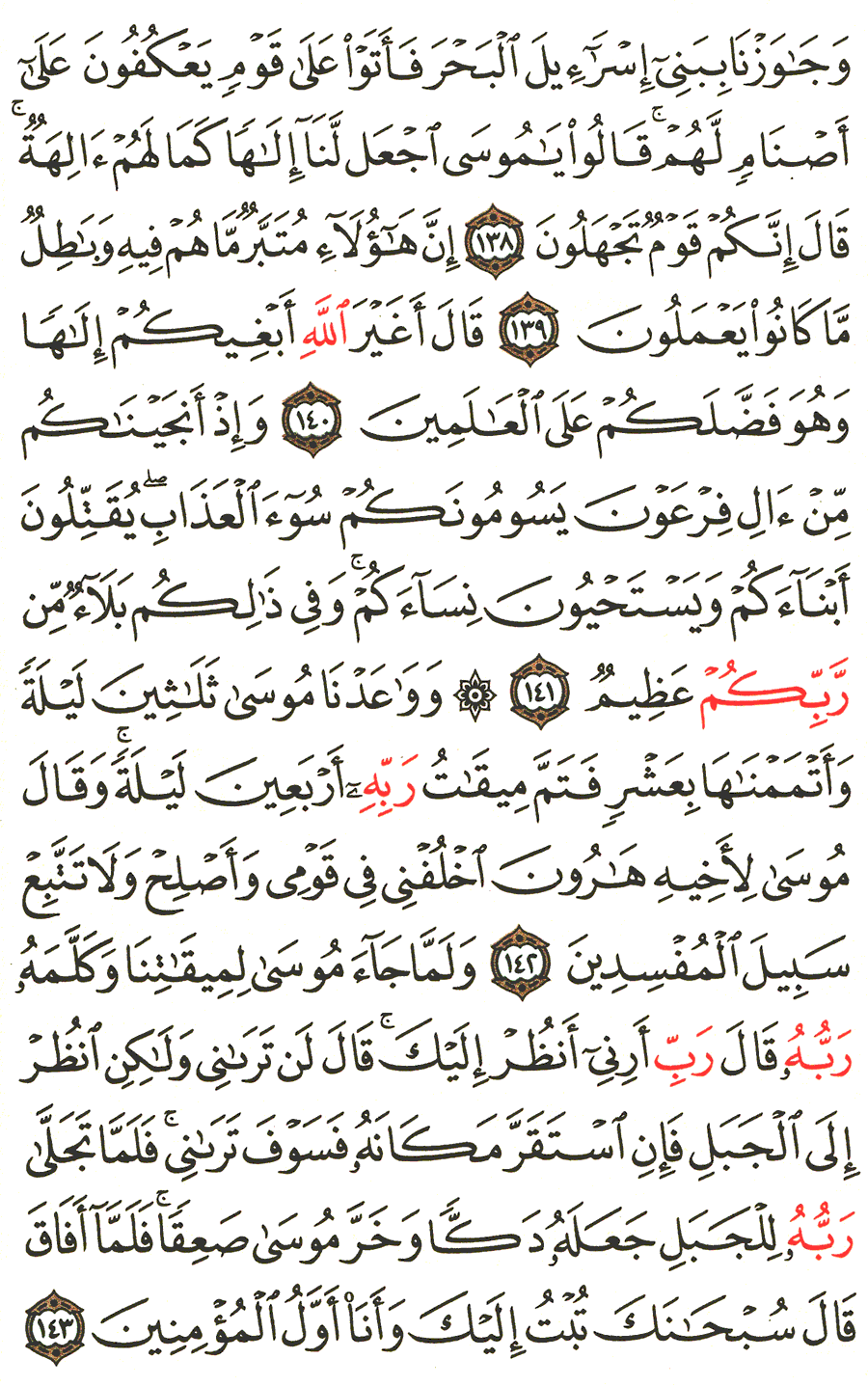
تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 167 من المصحف
قوله: 138- "وجاوزنا ببني إسرائيل البحر" جزناه بهم وقطعناه. وقرئ جوزنا بالتشديد، وهو بمعنى قراءة الجمهور "فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم". قرأ حمزة والكسائي "يعكفون" بكسر الكاف، وقرأ الباقون بضمها، يقال: عكيف يعكف: ويعكف بمعنى أقام على الشيء ولزمه، والمصدر منهما عكوف، قيل: هؤلاء القوم الذين أتاهم بنو إسرائيل هم من لخم كانوا نازلين بالرقة، كانت أصنامهم تماثيل بقر، وقيل: كانوا من الكنعانيين "قالوا" أي بنو إسرائيل عند مشاهدتهم لتلك التماثيل "يا موسى اجعل لنا إلهاً" أي صنماً نعبده كائناً كالذي لهؤلاء القوم فالكاف متعلق بمحذوف وقع صفة لإلهاً، فأجاب عليهم موسى، و "قال إنكم قوم تجهلون" وصفهم بالجهل لأنهم قد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله، ولكن هؤلاء القوم: أعني بني إسرائيل أشد خلق الله عناداً وجهلاً وتلوناً. وقد سلف في سورة البقرة بيان ما جرى منهم من ذلك.
ثم قال لهم موسى: "إن هؤلاء" يعني القوم العاكفين على الأصنام "متبر ما هم فيه" التبار الهلاك، وكل إناء منكسر فهو متبر: أي أن هؤلاء هالك ما هم فيه مدمر مكسر، والذي هم فيه عبادة الأصنام أخبرهم بأن هذا الدين الذي هؤلاء القوم عليه هالك مدمر لا يتم منه شيء. قوله: "وباطل ما كانوا يعملون" أي ذاهب مضمحل جميع ما كانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم للأصنام. قال في الكشاف: وفي إيقاع هؤلاء اسماً لـ إن وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها، وسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرضون للتبار، وأنه لا يعدوهم البتة، وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبوا.
قوله: 140- "أغير الله أبغيكم إلهاً" الاستفهام للإنكار والتوبيخ: أي كيف أطلب لكم غير الله إلهاً تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفي البعض منه؟ والمعنى: أن هذا الذي طلبتم لا يكون أبداً، وإدخال الهمزة على غير للإشعار بأن المنكر هو كون المبتغي غيره سبحانه إلهاً، و غير مفعول للفعل الذي بعده، وإلهاً تمييز أو حال، وجملة "وهو فضلكم على العالمين" في محل نصب على الحال: أي والحال أنه فضلكم على العالمين من أهل عصركم بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض وإخراجكم من الذل والهوان إلى العز والرفعة فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره.
قوله: 141- "وإذ أنجيناكم من آل فرعون" أي واذكروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعون بعد أن كانوا مالكين لكم يستعبدونكم فيما يريدونه منكم ويمتهنونكم بأنواع الامتهانات، هذا على أن هذا الكلام محكي عن موسى، وأما إذا كان في حكم الخطاب لليهود الموجودين في عصر محمد، فهو بمعنى اذكروا إذ أنجينا أسلافكم من آل فرعون، وجملة "يسومونكم سوء العذاب" في محل نصب على الحال: أي أنجيناكم من آل فرعون حال كونهم "يسومونكم سوء العذاب"، ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان ما كانوا فيه مما أنجاهم منه، وجملة "يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم" مفسرة للجملة التي قبلها، أو بدل منها. وقد سبق بيان ذلك، والإشارة بقوله: "وفي ذلكم" إلى العذاب: أي في هذا العذاب التي كنتم فيه "بلاء" عليكم "من ربكم عظيم" وقيل: الإشارة إلى الإنجاء، والبلاء النعمة. والأول أولى. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: "مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها" قال: الشام وأخرج هؤلاء عن قتادة مثله. وأخرج ابن عساكر عن زيد بن أسلم نحوه. وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن شوذب قال: هي فلسطين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الشام أحاديث ليس هذا موضع ذكرها. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: " وتمت كلمة ربك الحسنى " قال: ظهور قوم موسى على فرعون وتمكين الله لهم في الأرض وما ورثهم منها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "وما كانوا يعرشون" قال: يبنون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم" قال: لخم وجذام. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي عمران الجوني مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال: تماثيل بقر من نحاس، فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر، فذلك كان أول شأن العجل ليكون الله عليهم الحجة فينتقم منهم بعد ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي واقد الليثي قال:" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة، فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذوات أنواط كما للكفار ذوات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم:الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم". وأخرج نحوه ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً، وكثير ضعيف جداً. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "متبر" قال: خسران. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه قال: هلاك.
هذا من جملة ما كرم الله به موسى عليه السلام وشرفه. والثلاثين هي ذو القعدة والعشر هي عشر ذي الحجة ضرب الله هذه المدة موعدا لمناجاة موسى ومكالمته، قيل: وكان التكليم في يوم النحر، والفائدة في 142- "فتم ميقات ربه أربعين ليلة" مع العلم بأن الثلاثين والعشر أربعون ليلاً يتوهم وأن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها فبين أن العشر غير الثلاثين، وأربعين ليلة منصوب على الحال: أي فتم حال كونه بالغاً أربعين ليلة. قوله: "وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي" أي كن خليفتي فيهم، قال موسى: هذا لما أراد المضي إلى المناجاة "وأصلح" أمر بني إسرائيل بحسن سياستهم والرفق بهم وتفقد أحوالهم "ولا تتبع سبيل المفسدين" أي لا تسلك سبيل العاصين ولا تكن عوناً للظالمين. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس في قوله: "وواعدنا موسى" الآية قال: ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد مثله. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: إن موسى قال لقومه: إن ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكم، فلما فصل موسى إلى ربه زاده الله عشراً فكانت فتنتهم في العشر التي زاده الله، فلما مضى ثلاثون ليلة كان السامري قد أبصر جبريل، فأخذ من أثر الفرس قبضة من تراب، ثم ذكر قصة السامري.
اللام في 143- "لميقاتنا" للاختصاص: أي كان مجيئه مختصاً بالميقات المذكور بمعنى أنه جاء في الوقت الموعود "وكلمه ربه" أي اسمعه كلامه من غير واسطة. قوله: "أرني أنظر إليك" أي أرني نفسك أنظر إليك: أي سأله النظر إليه اشتياقاً إلى رؤيته لما أسمعه كلامه. وسؤال موسى للرؤية يدل على أنها جائزة عنده في الجملة، ولو كانت مستحيلة عنده لما سألها، والجواب بقوله: "لن تراني" يفيد أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه، أو أنه لا يرى ما دام الرائي حياً في دار الدنيا. وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواتراً لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة، والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة، ومنهج الحق واضح، ولكن الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في التعصب. والمتعصب وإن كان بصره صحيحاً فبصيرته عمياء. وأذنه عن سماع الحق صماء، يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل ويحسب أن ما نشأ عليه هو الحق غفلة منه وجهلاً بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم. وما أقل المنصفين بعد ظهوره هذه المذاهب في الأصول والفروع فإنه صار بها باب الحق مرتجاً، وطريق الإنصاف مستوعرة، والأمر لله سبحانه، والهداية منه: يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح وجملة "قال لن تراني" مستأنفة لكونها جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل: فما قال الله له؟ والاستدراك بقوله: "ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني" معناه أنك لا تثبت لرؤيتي ولا يثبت لها ما هو أعظم منك جرماً وصلابة وقوة، وهو الجبل فانظر إليه "فإن استقر مكانه" ولم يتزلزل عند رؤيتي له "فسوف تراني" وإن ضعف عن ذلك فأنت منه أضعف، فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل لموسى عليه السلام الجبل، وقيل: هو من باب التعليق بالمحال، وعلى تسليم هذا فهو في الرؤية في الدنيا لما قدمنا. وقد تمسك بهذه الآية كلا طائفتي المعتزلة والأشعرية: فالمعتزلة استدلوا بقوله: "لن تراني"، وبأمره بأن ينظر إلى الجبل، والأشعرية قالوا: إن تعليق الرؤية باستقرار الجبل يدل على أنها جائزة غير ممتنعة، ولا يخفاك أن الرؤية الأخروية هي بمعزل عن هذا كله، والخلاف بينهم هو فيها لا في الرؤية في الدنيا فقد كان الخلاف فيها في زمن الصحابة وكلامهم فيها معروف. قوله: "فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً" تجلى معناه: ظهر، من قولك جلوت العروس: أي أبرزتها، وجلوت السيف: أخلصته من الصدأ، وتجلى الشيء: انكشف. والمعنى: فلما ظهر ربه للجبل جعله دكاً، وقيل المتجلي هو أمره وقدرته، قاله قطرب وغيره والدك مصدر بمعنى المفعول: أي جعله مدكوكاً مدقوقاً فصار تراباً، هذا على قراءة من قرأ دكاً بالمصدر، وهم أهل المدينة وأهل البصرة، وأما على قراءة أهل الكوفة "جعله دكاء" على التأنيث، والجمع دكاوات كحمراء وحمراوات، وهي اسم للرابية الناشزة من الأرض أو للأرض المستوية، فالمعنى: أن الجبل صار صغيراً كالرابية أو أرضاً مستوية. قال الكسائي: الدك: الجبال العراض واحدها أدك، والدكاوات جمع دكاء، وهي رواب من طين ليست بالغلاظ، والدكادك: ما التبد من الأرض فلم يرتفع، وناقة دكاء: لا سنام لها "وخر موسى صعقاً" أي مغشياً عليه مأخوذاً من الصاعقة: والمعنى: أنه صار حاله لما غشي عليه كحال من يغشى عليه عند إصابة الصاعقة له. يقال: صعق الرجل فهو صعق ومصعوق: إذا أصابته الصاعقة "فلما أفاق" من غشيته "قال سبحانك" أي أنزهك تنزيهاً من أن أسأل شيئاً لم تأذن لي به "تبت إليك" عن العود إلى مثل هذا السؤال. قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية فإن الأنبياء معصومون، وقيل: هي توبة من قتله للقبطي، ذكره القشيري، ولا وجه له في مثل هذا المقام "وأنا أول المؤمنين" بك قبل قومي الموجودين في هذا العصر المعترفين بعظمتك وجلالك.
فتح القدير - صفحة القرآن رقم 167
166قوله: 138- "وجاوزنا ببني إسرائيل البحر" جزناه بهم وقطعناه. وقرئ جوزنا بالتشديد، وهو بمعنى قراءة الجمهور "فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم". قرأ حمزة والكسائي "يعكفون" بكسر الكاف، وقرأ الباقون بضمها، يقال: عكيف يعكف: ويعكف بمعنى أقام على الشيء ولزمه، والمصدر منهما عكوف، قيل: هؤلاء القوم الذين أتاهم بنو إسرائيل هم من لخم كانوا نازلين بالرقة، كانت أصنامهم تماثيل بقر، وقيل: كانوا من الكنعانيين "قالوا" أي بنو إسرائيل عند مشاهدتهم لتلك التماثيل "يا موسى اجعل لنا إلهاً" أي صنماً نعبده كائناً كالذي لهؤلاء القوم فالكاف متعلق بمحذوف وقع صفة لإلهاً، فأجاب عليهم موسى، و "قال إنكم قوم تجهلون" وصفهم بالجهل لأنهم قد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله، ولكن هؤلاء القوم: أعني بني إسرائيل أشد خلق الله عناداً وجهلاً وتلوناً. وقد سلف في سورة البقرة بيان ما جرى منهم من ذلك.
ثم قال لهم موسى: "إن هؤلاء" يعني القوم العاكفين على الأصنام "متبر ما هم فيه" التبار الهلاك، وكل إناء منكسر فهو متبر: أي أن هؤلاء هالك ما هم فيه مدمر مكسر، والذي هم فيه عبادة الأصنام أخبرهم بأن هذا الدين الذي هؤلاء القوم عليه هالك مدمر لا يتم منه شيء. قوله: "وباطل ما كانوا يعملون" أي ذاهب مضمحل جميع ما كانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم للأصنام. قال في الكشاف: وفي إيقاع هؤلاء اسماً لـ إن وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها، وسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرضون للتبار، وأنه لا يعدوهم البتة، وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبوا.
قوله: 140- "أغير الله أبغيكم إلهاً" الاستفهام للإنكار والتوبيخ: أي كيف أطلب لكم غير الله إلهاً تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفي البعض منه؟ والمعنى: أن هذا الذي طلبتم لا يكون أبداً، وإدخال الهمزة على غير للإشعار بأن المنكر هو كون المبتغي غيره سبحانه إلهاً، و غير مفعول للفعل الذي بعده، وإلهاً تمييز أو حال، وجملة "وهو فضلكم على العالمين" في محل نصب على الحال: أي والحال أنه فضلكم على العالمين من أهل عصركم بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض وإخراجكم من الذل والهوان إلى العز والرفعة فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره.
قوله: 141- "وإذ أنجيناكم من آل فرعون" أي واذكروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعون بعد أن كانوا مالكين لكم يستعبدونكم فيما يريدونه منكم ويمتهنونكم بأنواع الامتهانات، هذا على أن هذا الكلام محكي عن موسى، وأما إذا كان في حكم الخطاب لليهود الموجودين في عصر محمد، فهو بمعنى اذكروا إذ أنجينا أسلافكم من آل فرعون، وجملة "يسومونكم سوء العذاب" في محل نصب على الحال: أي أنجيناكم من آل فرعون حال كونهم "يسومونكم سوء العذاب"، ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان ما كانوا فيه مما أنجاهم منه، وجملة "يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم" مفسرة للجملة التي قبلها، أو بدل منها. وقد سبق بيان ذلك، والإشارة بقوله: "وفي ذلكم" إلى العذاب: أي في هذا العذاب التي كنتم فيه "بلاء" عليكم "من ربكم عظيم" وقيل: الإشارة إلى الإنجاء، والبلاء النعمة. والأول أولى. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: "مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها" قال: الشام وأخرج هؤلاء عن قتادة مثله. وأخرج ابن عساكر عن زيد بن أسلم نحوه. وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن شوذب قال: هي فلسطين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الشام أحاديث ليس هذا موضع ذكرها. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: " وتمت كلمة ربك الحسنى " قال: ظهور قوم موسى على فرعون وتمكين الله لهم في الأرض وما ورثهم منها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "وما كانوا يعرشون" قال: يبنون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم" قال: لخم وجذام. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي عمران الجوني مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال: تماثيل بقر من نحاس، فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر، فذلك كان أول شأن العجل ليكون الله عليهم الحجة فينتقم منهم بعد ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي واقد الليثي قال:" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة، فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذوات أنواط كما للكفار ذوات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم:الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم". وأخرج نحوه ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً، وكثير ضعيف جداً. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "متبر" قال: خسران. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه قال: هلاك.
هذا من جملة ما كرم الله به موسى عليه السلام وشرفه. والثلاثين هي ذو القعدة والعشر هي عشر ذي الحجة ضرب الله هذه المدة موعدا لمناجاة موسى ومكالمته، قيل: وكان التكليم في يوم النحر، والفائدة في 142- "فتم ميقات ربه أربعين ليلة" مع العلم بأن الثلاثين والعشر أربعون ليلاً يتوهم وأن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها فبين أن العشر غير الثلاثين، وأربعين ليلة منصوب على الحال: أي فتم حال كونه بالغاً أربعين ليلة. قوله: "وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي" أي كن خليفتي فيهم، قال موسى: هذا لما أراد المضي إلى المناجاة "وأصلح" أمر بني إسرائيل بحسن سياستهم والرفق بهم وتفقد أحوالهم "ولا تتبع سبيل المفسدين" أي لا تسلك سبيل العاصين ولا تكن عوناً للظالمين. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس في قوله: "وواعدنا موسى" الآية قال: ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد مثله. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: إن موسى قال لقومه: إن ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكم، فلما فصل موسى إلى ربه زاده الله عشراً فكانت فتنتهم في العشر التي زاده الله، فلما مضى ثلاثون ليلة كان السامري قد أبصر جبريل، فأخذ من أثر الفرس قبضة من تراب، ثم ذكر قصة السامري.
اللام في 143- "لميقاتنا" للاختصاص: أي كان مجيئه مختصاً بالميقات المذكور بمعنى أنه جاء في الوقت الموعود "وكلمه ربه" أي اسمعه كلامه من غير واسطة. قوله: "أرني أنظر إليك" أي أرني نفسك أنظر إليك: أي سأله النظر إليه اشتياقاً إلى رؤيته لما أسمعه كلامه. وسؤال موسى للرؤية يدل على أنها جائزة عنده في الجملة، ولو كانت مستحيلة عنده لما سألها، والجواب بقوله: "لن تراني" يفيد أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه، أو أنه لا يرى ما دام الرائي حياً في دار الدنيا. وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواتراً لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة، والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة، ومنهج الحق واضح، ولكن الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في التعصب. والمتعصب وإن كان بصره صحيحاً فبصيرته عمياء. وأذنه عن سماع الحق صماء، يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل ويحسب أن ما نشأ عليه هو الحق غفلة منه وجهلاً بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم. وما أقل المنصفين بعد ظهوره هذه المذاهب في الأصول والفروع فإنه صار بها باب الحق مرتجاً، وطريق الإنصاف مستوعرة، والأمر لله سبحانه، والهداية منه: يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح وجملة "قال لن تراني" مستأنفة لكونها جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل: فما قال الله له؟ والاستدراك بقوله: "ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني" معناه أنك لا تثبت لرؤيتي ولا يثبت لها ما هو أعظم منك جرماً وصلابة وقوة، وهو الجبل فانظر إليه "فإن استقر مكانه" ولم يتزلزل عند رؤيتي له "فسوف تراني" وإن ضعف عن ذلك فأنت منه أضعف، فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل لموسى عليه السلام الجبل، وقيل: هو من باب التعليق بالمحال، وعلى تسليم هذا فهو في الرؤية في الدنيا لما قدمنا. وقد تمسك بهذه الآية كلا طائفتي المعتزلة والأشعرية: فالمعتزلة استدلوا بقوله: "لن تراني"، وبأمره بأن ينظر إلى الجبل، والأشعرية قالوا: إن تعليق الرؤية باستقرار الجبل يدل على أنها جائزة غير ممتنعة، ولا يخفاك أن الرؤية الأخروية هي بمعزل عن هذا كله، والخلاف بينهم هو فيها لا في الرؤية في الدنيا فقد كان الخلاف فيها في زمن الصحابة وكلامهم فيها معروف. قوله: "فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً" تجلى معناه: ظهر، من قولك جلوت العروس: أي أبرزتها، وجلوت السيف: أخلصته من الصدأ، وتجلى الشيء: انكشف. والمعنى: فلما ظهر ربه للجبل جعله دكاً، وقيل المتجلي هو أمره وقدرته، قاله قطرب وغيره والدك مصدر بمعنى المفعول: أي جعله مدكوكاً مدقوقاً فصار تراباً، هذا على قراءة من قرأ دكاً بالمصدر، وهم أهل المدينة وأهل البصرة، وأما على قراءة أهل الكوفة "جعله دكاء" على التأنيث، والجمع دكاوات كحمراء وحمراوات، وهي اسم للرابية الناشزة من الأرض أو للأرض المستوية، فالمعنى: أن الجبل صار صغيراً كالرابية أو أرضاً مستوية. قال الكسائي: الدك: الجبال العراض واحدها أدك، والدكاوات جمع دكاء، وهي رواب من طين ليست بالغلاظ، والدكادك: ما التبد من الأرض فلم يرتفع، وناقة دكاء: لا سنام لها "وخر موسى صعقاً" أي مغشياً عليه مأخوذاً من الصاعقة: والمعنى: أنه صار حاله لما غشي عليه كحال من يغشى عليه عند إصابة الصاعقة له. يقال: صعق الرجل فهو صعق ومصعوق: إذا أصابته الصاعقة "فلما أفاق" من غشيته "قال سبحانك" أي أنزهك تنزيهاً من أن أسأل شيئاً لم تأذن لي به "تبت إليك" عن العود إلى مثل هذا السؤال. قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية فإن الأنبياء معصومون، وقيل: هي توبة من قتله للقبطي، ذكره القشيري، ولا وجه له في مثل هذا المقام "وأنا أول المؤمنين" بك قبل قومي الموجودين في هذا العصر المعترفين بعظمتك وجلالك.










الصفحة رقم 167 من المصحف تحميل و استماع mp3