سورة الروم | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح
| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |
| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |
| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |
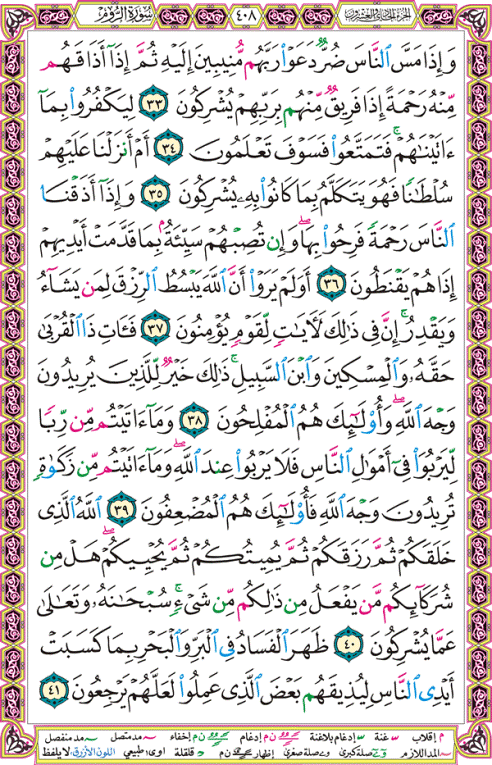
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن تفسير الصفحة 408 من المصحف
الآية: 33 {وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون}
قوله تعالى: "وإذا مس الناس ضر" أي قحط وشدة "دعوا ربهم" أن يرفع ذلك عنهم "منيبين إليه" قال ابن عباس: مقبلين عليه بكل قلوبهم لا يشركون. ومعنى هذا الكلام التعجب، عجب نبيه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى مع تتابع الحجج عليهم؛ أي إذا مس هؤلاء الكفار ضر من مرض وشدة دعوا ربهم؛ أي استغاثوا به في كشف ما نزل بهم، مقبلين عليه وحده دون الأصنام، لعلمهم بأنه لا فرج عندها. "ثم إذا أذاقهم منه رحمة" أي عافية ونعمة. "إذا فريق منهم بربهم يشركون" أي يشركون به في العبادة.
الآية: 34 {ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون}
قوله تعالى: "ليكفروا بما آتيناهم" قيل: هي لام كي. وقيل: هي لام أمر فيه معنى التهديد؛ كما قال جل وعز: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" [الكهف: 29]. "فتمتعوا فسوف تعلمون" تهديد ووعيد. وفي مصحف عبدالله "وليتمتعوا"؛ أي مكناهم من ذلك لكي يتمتعوا، فهو إخبار عن غائب؛ مثل: "ليكفروا". وهو على خط المصحف خطاب بعد الإخبار عن غائب؛ أي تمتعوا أيها الفاعلون لهذا.
الآية: 35 {أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون}
قوله تعالى: "أم أنزلنا عليهم سلطانا" استفهام فيه معنى التوقيف. قال الضحاك: "سلطانا" أي كتابا؛ وقاله قتادة والربيع بن أنس. وأضاف الكلام إلى الكتاب توسعا. وزعم الفراء أن العرب تؤنث السلطان؛ تقول: قضت به عليك السلطان. فأما البصريون فالتذكير عندهم أفصح، وبه جاء القرآن، والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة؛ أي حجة تنطق بشرككم؛ قاله ابن عباس والضحاك أيضا. وقال علي بن سليمان عن أبي العباس محمد بن يزيد قال: سلطان جمع سليط؛ مثل رغيف ورغفان، فتذكيره على معنى الجمع وتأنيثه على معنى الجماعة. وقد مضى في "آل عمران". والسلطان: ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمرا يستوجب به عقوبة؛ كما قال تعالى: "أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين" [النمل: 21].
الآية: 36 {وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون}
قوله تعالى: "وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها" يعني الخصب والسعة والعافية؛ قاله يحيى ابن سلام. النقاش: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدعة؛ والمعنى متقارب. "فرحوا بها" أي بالرحمة. "وإن تصبهم سيئة" أي بلاء وعقوبة؛ قاله مجاهد. السدي: قحط المطر. "بما قدمت أيديهم" أي بما عملوا من المعاصي. "إذا هم يقنطون" أي ييأسون من الرحمة والفرج؛ قاله الجمهور. وقال الحسن: إن القنوط ترك فرائض الله سبحانه وتعالى في السر. قنط يقنط، وهي قراءة العامة. وقنط يقنط، وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ومعقوب. وقرأ الأعمش: قنِط يقنَط [الحجر: 56] بالكسر فيهما؛ مثل حسب يحسب. والآية صفة للكافر، يقنط عند الشدة، ويبطر عند النعمة؛ كما قيل:
كحمار السوء إن أعلفته رمَح الناس وإن جاع نهق
وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة؛ وقد مضى في غير موضع. فأما المؤمن فيشكر ربه عند النعمة، ويرجوه عند الشدة.
الآية: 37 {أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون}
قوله تعالى: "أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر" أي يوسع الخير في الدنيا لمن يشاء أو يضيق؛ فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط. "إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون".
الآية: 38 {فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون}
لما تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني. والخطاب للنبي عليه السلام والمراد هو وأمته؛ لأنه قال: "ذلك خير للذين يريدون وجه الله". وأمر بإيتاء ذي القربى لقرب رحمه؛ وخير الصدقة ما كان على القريب، وفيها صلة الرحم. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب، فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة: (أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك).
واختلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا نسخ، بل للقريب حق لازم في البر على كل حال؛ وهو الصحيح. قال مجاهد وقتادة: صلة الرحم فرض من الله عز وجل، حتى قال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة. وقيل: المراد بالقربى أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. والأول أصح؛ فإن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في قوله: "فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى" [الأنفال: 41]. وقيل: إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب. قال الحسن: "حقه" المواساة في اليسر، وقول ميسور في العسر. "والمسكين" قال ابن عباس: أي أطعم السائل الطواف؛ "وابن السبيل" الضيف؛ فجعل الضيافة فرضا، وقد مضى جميع هذا مبسوطا مبينا في مواضعه والحمد لله.
قوله تعالى: "ذلك خير للذين يريدون وجه الله" أي إعطاء الحق أفضل من الإمساك إذا أريد بذلك وجه الله والتقرب إليه. "وأولئك هم المفلحون" أي الفائزون بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدم في "البقرة" القول فيه.
الآية: 39 {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون}
لما ذكر ما يراد به وجهه ويثبت عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد به أيضا وجهه. وقرأ الجمهور: "آتيتم" بالمد بمعنى أعطيتم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحميد بغير مد؛ بمعنى ما فعلتم من ربا ليربو؛ كما تقول: أتيت صوابا وأتيت خطأ. وأجمعوا على المد في قوله: "وما آتيتم من زكاة". والربا الزيادة وقد مضى في "البقرة" معناه، وهو هناك محرم وها هنا حلال. وثبت بهذا أنه قسمان: منه حلال ومنه حرام. قال عكرمة في قوله تعالى: "وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس" قال: الربا ربوان، ربا حلال وربا حرام؛ فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى، يلتمس ما هو أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية: هو الربا الحلال الذي يهدى ليثاب ما هو أفضل منه، لا له ولا عليه، ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن عباس: "وما آتيتم من ربا" يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه؛ فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه، وفي هذا المعنى نزلت الآية. قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد: هذه آية نزلت في هبة الثواب. قال ابن عطية: وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره؛ فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى. وقاله القاضي أبو بكر بن العربي. وفي كتاب النسائي عن عبدالرحمن بن علقمة قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية فقال: (أهدية أم صدقة فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل) قالوا: لا بل هدية؛ فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسألونه. وقال ابن عباس أيضا وإبراهيم النخعي: نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم، وليزيدوا في أموالهم على وجه النفع لهم. وقال الشعبي: معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحدا وخف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله. وقيل: كان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص؛ قال الله تعالى: "ولا تمنن تستكثر" [المدثر: 6] فنهى أن يعطي شيئا فيأخذ أكثر منه عوضا. وقيل: إنه الربا المحرم؛ فمعنى: "لا يربو عند الله" على هذا القول لا يحكم به لآخذه بل هو للمأخوذ منه. قال السدي: نزلت هذه الآية في ربا ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش.
قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فيمن يهب يطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة. قال المهلب: اختلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب ثوابها وقال: إنما أردت الثواب؛ فقال مالك: ينظر فيه؛ فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك؛ مثل هبة الفقير للغني، وهبة الخادم لصاحبه، وهبة الرجل لأميره ومن فوقه؛ وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط؛ وهو قول الشافعي الآخر. قال: والهبة للثواب باطلة لا تنفعه؛ لأنها بيع بثمن مجهول. واحتج الكوفي بأن موضوع الهبة التبرع، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت في معنى المعاوضات، والعرب قد فرقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة، فجعلت لفظ البيع على ما يستحق فيه العوض، والهبة بخلاف ذلك. ودليلنا ما رواه مالك في موطئه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها. ونحوه عن علّي رضي الله عنه قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله، وموهبة يراد بها وجوه الناس، وموهبة يراد بها الثواب؛ فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب منها. وترجم البخاري رحمه الله (باب المكافأة في الهبة) وساق حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وأثاب على لقحة ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب، وإنما أنكر سخطه للثواب وكان زائدا على القيمة. خرجه الترمذي.
ما ذكره علّي رضي الله عنه وفصّله من الهبة صحيح؛ وذلك أن الواهب لا يخلو في هبته من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه. والثاني: أن يريد بها وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها. والثالث: أن يريد بها الثواب من الموهوب له؛ وقد مضى الكلام فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). فأما إذا أراد بهبته وجه الله تعالى وابتغى عليه الثواب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؛ قال الله عز وجل: "وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون"
وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيا حتى لا يكون كلا فالنية في ذلك متبوعة؛ فإن كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه الله، وإن كان لما له عليه من حق القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله.
وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا منفعة له في هبته؛ لا ثواب في الدنيا ولا أجر في الآخرة؛ قال الله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس" [البقرة: 264] الآية. وأما من أراذ بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبته، وله أن يرجع فيها ما لم يثب بقيمتها، على مذهب ابن القاسم، أو ما لم يرض منها بأزيد من قيمتها، على ظاهر قول عمر وعلّي، وهو قول مطرف في الواضحة: أن الهبة ما كانت قائمة العين، وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه الموهوب فيها أكثر منها. وقد قيل: إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغير فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمة كنكاح التفويض، وأما إذا كان بعد فوت الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا؛ قاله ابن العربي.
قوله تعالى: "ليربو" قرأ جمهور الفراء [القراء؟؟] السبعة: "ليربو" بالياء وإسناد الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضم التاء والواو ساكنة على المخاطبة؛ بمعنى تكونوا ذوي زيادات، وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتاده والشعبي. قال أبو حاتم: هي قراءتنا. وقرأ أبو مالك: "لتربوها" بضمير مؤنث. "فلا يربو عند الله" أي لا يزكو ولا يثيب عليه؛ لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه وكان خالصا له؛ وقد تقدم في "النساء". "وما آتيتم من زكاة" قال ابن عباس: أي من صدقة. "تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون" أي ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرة أضعافه أو أكثر؛ كما قال: "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة" [البقرة: 245]. وقال: "ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة" [البقرة: 265]. وقال: 0"فأولئك هم المضعفون" ولم يقل فأنتم المضعفون لأنه رجع من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: "حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم" [يونس: 22]. وفي معنى المضعفين قولان: أحدهما: أنه تضاعف لهم الحسنات ذكرنا. والآخر: أنهم قد أضعف لهم الخير والنعيم؛ أي هم أصحاب أضعاف، كما يقال: فلان مقو إذا كانت إبله قوية، أو له أصحاب أقوياء. ومسمن إذا كانت إبله سمانا. ومعطش إذا كانت إبله عطاشا. ومضعف إذا كان إبله ضعيفة؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم". فالمخبث: الذي أصابه خبث، يقال: فلان رديء أي هو رديء؛ في نفسه. ومردئ: أصحابه أردئاء.
الآية: 40 {الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون}
قوله تعالى: "الله الذي خلقكم" ابتداء وخبر. وعاد الكلام إلى الاحتجاج على المشركين وأنه الخالق الرازق المميت المحيي. ثم قال على جهة الاستفهام: "هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء" لا يفعل. "سبحانه وتعالى عما يشركون" ثم نزه نفسه عن الأنداد والأضداد والصاحبة والأولاد وأضاف الشركاء إليهم لأنهم كانوا يسمونهم بالآلهة والشركاء، ويجعلون لهم من أموالهم.
الآية: 41 {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون}
قوله تعالى: "ظهر الفساد في البر والبحر" اختلف العلماء في معنى الفساد والبر والبحر؛ فقال قتادة والسدي: الفساد الشرك، وهو أعظم الفساد. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: فساد البر قتل ابن آدم أخاه؛ قابيل قتل هابيل. وفي البحر بالملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. وقيل: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة. ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية. وعنه أيضا: أن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم. وقال عطية: فإذا قل المطر قل الغوص عنده، وأخفق الصيادون، وعميت دواب البحر. وقال ابن عباس: إذا مطرت السماء تفتحت الأصداف في البحر، فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ. وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش. وقيل: الفساد المعاصي وقطع السبيل والظلم؛ أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والعمارات والتجارات؛ والمعنى كله متقارب. والبر والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس؛ لا ما قاله بعض العباد: أن البر اللسان، والبحر القلب؛ لظهور ما على اللسان وخفاء ما في القلب. وقيل: البر: الفيافي، والبحر: القرى؛ قاله عكرمة. والعرب تسمي الأمصار البحار. وقال قتادة: البر أهل العمود، والبحر أهل القرى والريف. وقال ابن عباس: إن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر، والبحر ما كان على شط نهر؛ وقاله مجاهد، قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهي بحر. وقال معناه النحاس، قال: في معناه قولان: أحدهما: ظهر الجذب في البر؛ أي في البوادي وقراها، وفي البحر أي في مدن البحر؛ مثل: "واسأل القرية" [يوسف: 82]. أي ظهر قلة الغيث وغلاء السعر. "بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض" أي عقاب بعض "الذين عملوا" ثم حذف. والقول الآخر: أنه ظهرت المعاصي من قطع السبيل والظلم، فهذا هو الفساد على الحقيقة، والأول مجاز إلا أنه على الجواب الثاني، فيكون في الكلام حذف واختصار دل عليه ما بعده، ويكون المعنى: ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عنهما الغيث وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا. "لعلهم يرجعون" لعلهم يتوبون. وقال: "بعض الذي عملوا" لأن معظم الجزاء في الآخرة. والقراءة "ليذيقهم" بالياء. وقرأ ابن عباس بالنون، وهي قراءة السلمي وابن محيصن وقنبل ويعقوب على التعظيم؛ أي نذيقهم عقوبة بعض ما عملوا.
تفسير القرطبي - صفحة القرآن رقم 408
408- تفسير الصفحة رقم408 من المصحفالآية: 33 {وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون}
قوله تعالى: "وإذا مس الناس ضر" أي قحط وشدة "دعوا ربهم" أن يرفع ذلك عنهم "منيبين إليه" قال ابن عباس: مقبلين عليه بكل قلوبهم لا يشركون. ومعنى هذا الكلام التعجب، عجب نبيه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى مع تتابع الحجج عليهم؛ أي إذا مس هؤلاء الكفار ضر من مرض وشدة دعوا ربهم؛ أي استغاثوا به في كشف ما نزل بهم، مقبلين عليه وحده دون الأصنام، لعلمهم بأنه لا فرج عندها. "ثم إذا أذاقهم منه رحمة" أي عافية ونعمة. "إذا فريق منهم بربهم يشركون" أي يشركون به في العبادة.
الآية: 34 {ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون}
قوله تعالى: "ليكفروا بما آتيناهم" قيل: هي لام كي. وقيل: هي لام أمر فيه معنى التهديد؛ كما قال جل وعز: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" [الكهف: 29]. "فتمتعوا فسوف تعلمون" تهديد ووعيد. وفي مصحف عبدالله "وليتمتعوا"؛ أي مكناهم من ذلك لكي يتمتعوا، فهو إخبار عن غائب؛ مثل: "ليكفروا". وهو على خط المصحف خطاب بعد الإخبار عن غائب؛ أي تمتعوا أيها الفاعلون لهذا.
الآية: 35 {أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون}
قوله تعالى: "أم أنزلنا عليهم سلطانا" استفهام فيه معنى التوقيف. قال الضحاك: "سلطانا" أي كتابا؛ وقاله قتادة والربيع بن أنس. وأضاف الكلام إلى الكتاب توسعا. وزعم الفراء أن العرب تؤنث السلطان؛ تقول: قضت به عليك السلطان. فأما البصريون فالتذكير عندهم أفصح، وبه جاء القرآن، والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة؛ أي حجة تنطق بشرككم؛ قاله ابن عباس والضحاك أيضا. وقال علي بن سليمان عن أبي العباس محمد بن يزيد قال: سلطان جمع سليط؛ مثل رغيف ورغفان، فتذكيره على معنى الجمع وتأنيثه على معنى الجماعة. وقد مضى في "آل عمران". والسلطان: ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمرا يستوجب به عقوبة؛ كما قال تعالى: "أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين" [النمل: 21].
الآية: 36 {وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون}
قوله تعالى: "وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها" يعني الخصب والسعة والعافية؛ قاله يحيى ابن سلام. النقاش: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدعة؛ والمعنى متقارب. "فرحوا بها" أي بالرحمة. "وإن تصبهم سيئة" أي بلاء وعقوبة؛ قاله مجاهد. السدي: قحط المطر. "بما قدمت أيديهم" أي بما عملوا من المعاصي. "إذا هم يقنطون" أي ييأسون من الرحمة والفرج؛ قاله الجمهور. وقال الحسن: إن القنوط ترك فرائض الله سبحانه وتعالى في السر. قنط يقنط، وهي قراءة العامة. وقنط يقنط، وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ومعقوب. وقرأ الأعمش: قنِط يقنَط [الحجر: 56] بالكسر فيهما؛ مثل حسب يحسب. والآية صفة للكافر، يقنط عند الشدة، ويبطر عند النعمة؛ كما قيل:
كحمار السوء إن أعلفته رمَح الناس وإن جاع نهق
وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة؛ وقد مضى في غير موضع. فأما المؤمن فيشكر ربه عند النعمة، ويرجوه عند الشدة.
الآية: 37 {أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون}
قوله تعالى: "أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر" أي يوسع الخير في الدنيا لمن يشاء أو يضيق؛ فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط. "إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون".
الآية: 38 {فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون}
لما تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني. والخطاب للنبي عليه السلام والمراد هو وأمته؛ لأنه قال: "ذلك خير للذين يريدون وجه الله". وأمر بإيتاء ذي القربى لقرب رحمه؛ وخير الصدقة ما كان على القريب، وفيها صلة الرحم. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب، فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة: (أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك).
واختلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا نسخ، بل للقريب حق لازم في البر على كل حال؛ وهو الصحيح. قال مجاهد وقتادة: صلة الرحم فرض من الله عز وجل، حتى قال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة. وقيل: المراد بالقربى أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. والأول أصح؛ فإن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في قوله: "فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى" [الأنفال: 41]. وقيل: إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب. قال الحسن: "حقه" المواساة في اليسر، وقول ميسور في العسر. "والمسكين" قال ابن عباس: أي أطعم السائل الطواف؛ "وابن السبيل" الضيف؛ فجعل الضيافة فرضا، وقد مضى جميع هذا مبسوطا مبينا في مواضعه والحمد لله.
قوله تعالى: "ذلك خير للذين يريدون وجه الله" أي إعطاء الحق أفضل من الإمساك إذا أريد بذلك وجه الله والتقرب إليه. "وأولئك هم المفلحون" أي الفائزون بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدم في "البقرة" القول فيه.
الآية: 39 {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون}
لما ذكر ما يراد به وجهه ويثبت عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد به أيضا وجهه. وقرأ الجمهور: "آتيتم" بالمد بمعنى أعطيتم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحميد بغير مد؛ بمعنى ما فعلتم من ربا ليربو؛ كما تقول: أتيت صوابا وأتيت خطأ. وأجمعوا على المد في قوله: "وما آتيتم من زكاة". والربا الزيادة وقد مضى في "البقرة" معناه، وهو هناك محرم وها هنا حلال. وثبت بهذا أنه قسمان: منه حلال ومنه حرام. قال عكرمة في قوله تعالى: "وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس" قال: الربا ربوان، ربا حلال وربا حرام؛ فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى، يلتمس ما هو أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية: هو الربا الحلال الذي يهدى ليثاب ما هو أفضل منه، لا له ولا عليه، ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن عباس: "وما آتيتم من ربا" يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه؛ فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه، وفي هذا المعنى نزلت الآية. قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد: هذه آية نزلت في هبة الثواب. قال ابن عطية: وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره؛ فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى. وقاله القاضي أبو بكر بن العربي. وفي كتاب النسائي عن عبدالرحمن بن علقمة قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية فقال: (أهدية أم صدقة فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل) قالوا: لا بل هدية؛ فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسألونه. وقال ابن عباس أيضا وإبراهيم النخعي: نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم، وليزيدوا في أموالهم على وجه النفع لهم. وقال الشعبي: معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحدا وخف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله. وقيل: كان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص؛ قال الله تعالى: "ولا تمنن تستكثر" [المدثر: 6] فنهى أن يعطي شيئا فيأخذ أكثر منه عوضا. وقيل: إنه الربا المحرم؛ فمعنى: "لا يربو عند الله" على هذا القول لا يحكم به لآخذه بل هو للمأخوذ منه. قال السدي: نزلت هذه الآية في ربا ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش.
قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فيمن يهب يطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة. قال المهلب: اختلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب ثوابها وقال: إنما أردت الثواب؛ فقال مالك: ينظر فيه؛ فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك؛ مثل هبة الفقير للغني، وهبة الخادم لصاحبه، وهبة الرجل لأميره ومن فوقه؛ وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط؛ وهو قول الشافعي الآخر. قال: والهبة للثواب باطلة لا تنفعه؛ لأنها بيع بثمن مجهول. واحتج الكوفي بأن موضوع الهبة التبرع، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت في معنى المعاوضات، والعرب قد فرقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة، فجعلت لفظ البيع على ما يستحق فيه العوض، والهبة بخلاف ذلك. ودليلنا ما رواه مالك في موطئه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها. ونحوه عن علّي رضي الله عنه قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله، وموهبة يراد بها وجوه الناس، وموهبة يراد بها الثواب؛ فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب منها. وترجم البخاري رحمه الله (باب المكافأة في الهبة) وساق حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وأثاب على لقحة ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب، وإنما أنكر سخطه للثواب وكان زائدا على القيمة. خرجه الترمذي.
ما ذكره علّي رضي الله عنه وفصّله من الهبة صحيح؛ وذلك أن الواهب لا يخلو في هبته من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه. والثاني: أن يريد بها وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها. والثالث: أن يريد بها الثواب من الموهوب له؛ وقد مضى الكلام فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). فأما إذا أراد بهبته وجه الله تعالى وابتغى عليه الثواب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؛ قال الله عز وجل: "وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون"
وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيا حتى لا يكون كلا فالنية في ذلك متبوعة؛ فإن كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه الله، وإن كان لما له عليه من حق القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله.
وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا منفعة له في هبته؛ لا ثواب في الدنيا ولا أجر في الآخرة؛ قال الله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس" [البقرة: 264] الآية. وأما من أراذ بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبته، وله أن يرجع فيها ما لم يثب بقيمتها، على مذهب ابن القاسم، أو ما لم يرض منها بأزيد من قيمتها، على ظاهر قول عمر وعلّي، وهو قول مطرف في الواضحة: أن الهبة ما كانت قائمة العين، وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه الموهوب فيها أكثر منها. وقد قيل: إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغير فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمة كنكاح التفويض، وأما إذا كان بعد فوت الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا؛ قاله ابن العربي.
قوله تعالى: "ليربو" قرأ جمهور الفراء [القراء؟؟] السبعة: "ليربو" بالياء وإسناد الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضم التاء والواو ساكنة على المخاطبة؛ بمعنى تكونوا ذوي زيادات، وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتاده والشعبي. قال أبو حاتم: هي قراءتنا. وقرأ أبو مالك: "لتربوها" بضمير مؤنث. "فلا يربو عند الله" أي لا يزكو ولا يثيب عليه؛ لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه وكان خالصا له؛ وقد تقدم في "النساء". "وما آتيتم من زكاة" قال ابن عباس: أي من صدقة. "تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون" أي ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرة أضعافه أو أكثر؛ كما قال: "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة" [البقرة: 245]. وقال: "ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة" [البقرة: 265]. وقال: 0"فأولئك هم المضعفون" ولم يقل فأنتم المضعفون لأنه رجع من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: "حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم" [يونس: 22]. وفي معنى المضعفين قولان: أحدهما: أنه تضاعف لهم الحسنات ذكرنا. والآخر: أنهم قد أضعف لهم الخير والنعيم؛ أي هم أصحاب أضعاف، كما يقال: فلان مقو إذا كانت إبله قوية، أو له أصحاب أقوياء. ومسمن إذا كانت إبله سمانا. ومعطش إذا كانت إبله عطاشا. ومضعف إذا كان إبله ضعيفة؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم". فالمخبث: الذي أصابه خبث، يقال: فلان رديء أي هو رديء؛ في نفسه. ومردئ: أصحابه أردئاء.
الآية: 40 {الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون}
قوله تعالى: "الله الذي خلقكم" ابتداء وخبر. وعاد الكلام إلى الاحتجاج على المشركين وأنه الخالق الرازق المميت المحيي. ثم قال على جهة الاستفهام: "هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء" لا يفعل. "سبحانه وتعالى عما يشركون" ثم نزه نفسه عن الأنداد والأضداد والصاحبة والأولاد وأضاف الشركاء إليهم لأنهم كانوا يسمونهم بالآلهة والشركاء، ويجعلون لهم من أموالهم.
الآية: 41 {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون}
قوله تعالى: "ظهر الفساد في البر والبحر" اختلف العلماء في معنى الفساد والبر والبحر؛ فقال قتادة والسدي: الفساد الشرك، وهو أعظم الفساد. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: فساد البر قتل ابن آدم أخاه؛ قابيل قتل هابيل. وفي البحر بالملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. وقيل: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة. ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية. وعنه أيضا: أن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم. وقال عطية: فإذا قل المطر قل الغوص عنده، وأخفق الصيادون، وعميت دواب البحر. وقال ابن عباس: إذا مطرت السماء تفتحت الأصداف في البحر، فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ. وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش. وقيل: الفساد المعاصي وقطع السبيل والظلم؛ أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والعمارات والتجارات؛ والمعنى كله متقارب. والبر والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس؛ لا ما قاله بعض العباد: أن البر اللسان، والبحر القلب؛ لظهور ما على اللسان وخفاء ما في القلب. وقيل: البر: الفيافي، والبحر: القرى؛ قاله عكرمة. والعرب تسمي الأمصار البحار. وقال قتادة: البر أهل العمود، والبحر أهل القرى والريف. وقال ابن عباس: إن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر، والبحر ما كان على شط نهر؛ وقاله مجاهد، قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهي بحر. وقال معناه النحاس، قال: في معناه قولان: أحدهما: ظهر الجذب في البر؛ أي في البوادي وقراها، وفي البحر أي في مدن البحر؛ مثل: "واسأل القرية" [يوسف: 82]. أي ظهر قلة الغيث وغلاء السعر. "بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض" أي عقاب بعض "الذين عملوا" ثم حذف. والقول الآخر: أنه ظهرت المعاصي من قطع السبيل والظلم، فهذا هو الفساد على الحقيقة، والأول مجاز إلا أنه على الجواب الثاني، فيكون في الكلام حذف واختصار دل عليه ما بعده، ويكون المعنى: ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عنهما الغيث وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا. "لعلهم يرجعون" لعلهم يتوبون. وقال: "بعض الذي عملوا" لأن معظم الجزاء في الآخرة. والقراءة "ليذيقهم" بالياء. وقرأ ابن عباس بالنون، وهي قراءة السلمي وابن محيصن وقنبل ويعقوب على التعظيم؛ أي نذيقهم عقوبة بعض ما عملوا.










الصفحة رقم 408 من المصحف تحميل و استماع mp3